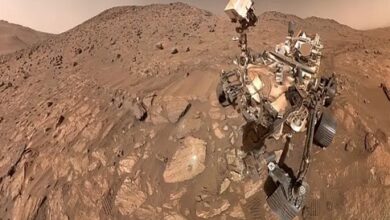النشأة المستقلّة والفريدة للتاريخ الإسلاميّ

د. عبد العظيم محمود حنفي*
التاريخ هو مِن أهمّ ميادين المعرفة التي اهتمّ بها العرب وتدارسوها وألّفوا فيها. ويرجع اهتمامهم به إلى ما قبل الإسلام، حيث كانوا يؤمنون بأهمّية رابطة الدمّ في تقرير مكانة الإنسان، وبأنّ أعمال الآباء والأجداد تُسبغ على الأبناء مكانة في المجتمع. وهذا ما دفعهم إلى الاهتمام بالنَّسب وحفظ شجراته وتدارسها، والاهتمام، في هذا السياق، بالتاريخ. والواقع أنّ التاريخ من الموضوعات الثقافية التي عني بها العرب عناية كبيرة، وبذلوا فيها جهوداً ضخمة جبّارة.
لكنّ نشأة التاريخ عند العرب، على الرّغم من كثرة ما كُتب فيها، لا تزال بحاجة الى المزيد من الضوء. فحينما ظهر الإسلام، كان للعرب نصيب من الأخبار التاريخية التي تختلط فيها الحقائق بالأساطير اختلاطاً يجعل التمييز بينها من الأمور الشاقّة، وذلك لعدم وجود مدوّنات يرجع إليها عند المقابلة والتمحيص والوزن والتحقيق؛ وكان أكثر هذه الأخبار يدور حول ما يسمّى “أيّام العرب” وحروبهم قبل الإسلام وأنسابهم وأخبار بعض القبائل البائدة مثل عاد وثمود، وشذرات ممّا سمعوه من أخبار التوراة والتلمود. وقد كان العصر الجاهلي فترة طويلة الأمد بين حضارات العرب القديمة، في اليمن وتدمر والحيرة، والحضارات الإسلامية. ولم تكن الكتابة في العصر الجاهلي واسعة الانتشار، ولكنّها مع ذلك لم تكن مجهولة، بل كانت شائعة الاستعمال في كتابة العهود والمواثيق والصكوك والرسائل، ولكنّ العقلية الجاهلية كانت أقدر على قرض الشعر منها على معالجة كتابة التاريخ. كانت عقلية شديدة التعصّب للقبيلة، نزّاعة إلى الأسطورة والخرافة، قليلة الصبر على المراجعة والتدقيق، متشبّعة بروح عصرها وتقاليده، معتزّة بعروبتها، وهذه الحالة لا تعوق قرض الشعر، بل قد تكون من بواعث نظمه لأنّ فيها ما يُحرِّك الخيال ويثير العاطفة، ولكنّها عقبة في طريق النضج الذي تستلزمه كتابة التاريخ.
ولمّا ظهر الإسلام، انشغل المسلمون بالفتوح والغزوات والحروب حتّى توطّدت مكانة الإسلام، ورست قواعده، وعلت كلمته، واستوثق له الأمر. ولمّا هدأت ثورة الفتوح، وحدث نوع من الاستقرار النسبيّ، بدأ المسلمون يتّجهون إلى إثبات الأخبار وتسجيل الحوادث، وأقبلوا على جمع الأحاديث النبوية وتفسير القرآن.
تدلّ أكثر القرائن على أنّ التاريخ الإسلامي نشأ نشأة مستقلّة، وشقّ لنفسه طريقاً مُلائماً لطبيعته واتّجاه أحداثه، ولا يبدو فيه أثر التأثّر بما كتبه أعلام المؤرّخين اليونانيّين أو الرومانيّين، ولا يبدو أنّ كتّاب التاريخ الأوائل قد عرفوا كُتب هيرودوت وثوكوديدس وزينوفون اليونايين أو مؤلّفات تيتوس ليفيوس وتاسيتوس وأضرابهماعند الرومان .
ولم يكن كتّاب التاريخ في الأعمّ الأغلب من المؤرّخين الرسميّين الذين تقوم مهمّتهم على تسجيل ما تريده الدولة، وقد ذكر الطبري وغيره من الكتّاب حالاتٍ أمَر فيها الخلفاء بوضع مصنّفات أدبية مثل مجموعة الشعر القديم التي أَمَر المهدي بجمعها، والرسائل التي جُمعت عن المذاهب بأمر القادر، ولم تُذكَر حالة واحدة أمر فيها خليفة من الخلفاء بكتابة التاريخ. وقد ذُكرت بعض حالات مُنع فيها أو حُرِّم وضع مثل هذه التواريخ. ومن الشواهد على التواريخ الإخبارية الرسمية كِتاب “التاجي” نسبةً إلى تاج الملّة، وهو لقب من ألقاب عضد الدّولة البويهي، ألّفه له الوزير الشهير إبراهيم الصابئ، وكان هذ الرجل كاتب عزّ الدّولة بختيار الأمير البويهي الثاني الذي كان وليّ الأمر في بغداد قد كتب رسائل أغضبت ابن عمّه عضد الدّولة أشدّ الغضب، فهاجمه بعد أن توفّى أبوه وخلعه عن العرش ولم يكن إبراهيم إلّا كاتباً، وطلب عضد الدولة التكفير عن هذه الرسائل، واقترح أن يكون ذلك بكتابته تاريخاً رسمياً لدولة بني بويه. ويُقال إنّ كثيراً من هذا الكِتاب قد تضمّنه تاريخ مسكويه، وسُئل إبراهيم وهو عاكف على تأليف الكِتاب عمّا يفعل فقال “أباطيل أنمّقها وأكاذيب ألفّقها”. وعَلم عضد الدّولة بقولته هذه وغضب غضباً شديداً، وأفلت الصابئ من الموت بصعوبة، وكذلك كِتاب “اليميني” للعتبي فقد كُتِب لتسجيل أعمال السلطان محمود الغزنوي، وما كتبه عماد الدين الأصفهاني في وصف استرداد صلاح الدّين لبيت المقدس وأسماه “الفتح القسي في الفتح القدسي”؛ وهكذا نشأ التاريخ الإسلامي مُستجيباً لمطالب العالَم الإسلامي وحاجاته وتطوّراته.
مزايا مؤرّخي الإسلام
من المزايا التي امتاز بها مؤرّخو الإسلام مراعاة الدقّة في تسجيل الأحداث التاريخية وتأريخها بالسنة والشهر واليوم. ويُنقل عن المؤرّخ الإنكليزي المشهور ديفيد مرجليوث (1858-1940) في كتابه عن “مؤرّخي العرب” قوله إنّ التوقيت على هذا النحو لم يُعرف في أوروبا قبل سنة 1597 ميلادية، وقد ابتدأ التاريخ الإسلامي بالهجرة في عهد عمر بن الخطّاب ثاني الخلفاء الراشدين. وقد لاحظ روزنتال أنّ كلمة تاريخ لا تظهر في الأدب الجاهلى كما أنّها غير مذكورة في القرآن ولا في الأحاديث النبويّة. والحديث الوحيد الذي يشير إلى إدخال التقويم الإسلامي في “صحيح البخاري” يستعمل كلمة “عدّ” ولا يستعمل “أرّخ”، وكلّ الظواهر تدلّ على أنّ كلمة تاريخ استُعملت لأوّل مرّة فى الآداب العربية مع أخبار إدخال التقويم الهجري.
والميزة الثانية التي امتاز بها التاريخ الإسلامي هي الإسناد، وهو إرجاع الرواية التاريخية إلى شخص شاهد عيان. وفي سبيل تحرّي صحّة الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ (عليه السلام )، نشأ نوع من التحقيق يقوم على فحص سلسلة الإسناد، ويتتبَّع كيف وصل الحديث إلى كلّ جيل من الأجيال التالية، وكان دارسو الحديث في بادئ الأمر من المؤرّخين، ولكنّ التاريخ استقلّ بالتدريج عن عِلم الحديث، وصار الإخباريّ شخصاً غير المُحدِّث.
واعتماد مؤرّخي الإسلام على الرواية والإسناد كان يجعل لرأي الشاهد الأوّل قيمة كبيرة، لأنّ روايته هي الأساس الذي يقوم عليه الإسناد من ناحية، وتحقيق المؤرِّخ من ناحية أخرى، ولذلك استلزم الأمر المزيد من العناية بالتعرّف إلى أخبار هؤلاء الرواة الأوائل، وتحرّي سيرهم وأخلاقهم ونزعاتهم الفكرية واتّجاهاتهم المذهبية، واستأثر ذلك بنصيب كبير من جهد المؤرّخين، وهذا هو الأصل في ظهور كُتب الطبقات وأسبقيّتها شأن مؤلَّف “طبقات ابن سعد” المعروف.
وسار المؤرّخون المختلفون على غرارها، فظهرت إلى جانب طبقات المحدّثين، طبقاتُ الشعراء وطبقاتُ النحّاة وطبقات الأطبّاء، وتواريخ الأعيان والوزراء، وهي تتناول تاريخ الرجال الذين برزوا وامتازوا في أيّ ناحية من نواحي الحياة الدينية أو السياسية أو الأدبية، وتُعرِّفنا بهم، وتُلخِّص لنا أعمالهم وأخبارههم. وتتفاوت هذه الكُتب في الإجادة والإتقان والتثبّت والتحقيق والتدقيق.
*كاتب وباحث اكاديمي مصري
نشرة أفق (تصدر عن مؤسسة الفكر العربي)