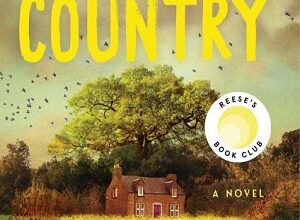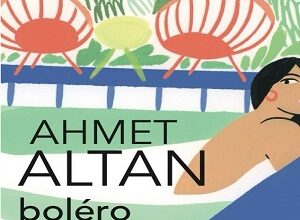جوان ديديون: تيه الإنسان المعاصر

في مقالها المنشور عام 1976 في «نيويورك تايمز»، كتبت جوان ديديون (1934ـــ 2021) عن روايتها «كيفما اتفق» الصادرة بترجمتها العربية (عماد العتيلي ـــــ «دار المدى» العراقية)، عن الصورة التي دفعتها إلى كتابة هذه الرواية: «أما في ما يتعلق بالصور: فقد كانت الصورة الأولى لمساحة بيضاء. فضاء فارغ.
ولا شك في أنّها الصورة التي حددت المغزى السردي للكتاب. الكتاب الذي تجري كل أحداثه خارج الصفحة، كتاب «أبيض» يجبر القارئ على إحضار كوابيسه معه. ومع ذلك، فما زالت الصورة عاجزة عن إخباري بأية قصة أو حالة محتملة». الفصل الأول من الرواية يبدأ باستقلال البطلة ماريا وايت، التي تعمل ممثلة، سيارتها والخروج بها على طريق سريع من سان دييغو إلى فينتورا. تحكي ماريا حياتها عبر استدعاء ومضات غير واضحة منها، تفتح أبواباً كثيرة لتأويل القصة، وربطها بحالة كيت ابنتها المريضة التي تُعاني حالةً مرضية ميؤوساً منها، أو ربطها بالعلاقة المحطّمة بينها وبين زوجها كارتر، بطل الرواية الثاني، الذي يعمل مؤلف أفلام. ثمة إجبار على تأويل القصة، لأنّ ديديون هنا تحطّم أي بنية سردية قد تصل بالقارئ إلى صورة واضحة أو حتى إلى صفحة مليئة بالحبر.
لعبة تطرح خلالها سؤالاً بلا بحث عن إجابة له.
في بداية الرواية، تكتب ديديون نبذة سريعة عن ماريا، ثم تعرض آراء زوجها كارتر، وصديقتها هيلين. وعلى لسان ماريا، تقول: «لماذا يُعد إياغو (شخصية روائية في مسرحية «عطيل» لشكسبير) شريراً؟ لكنني لا أتساءل أبداً. ما لم تكن مستعداً للانتظار حتى تتكشف الأسباب في المستقبل البعيد، فلن تحظى بإجابة آنية شافية لمثل تلك الأسئلة. فإنّ البحث عن الأسباب مُضن ولا معنى له». في الفصل الأول التي تستقل ماريا مركبتها للذهاب إلى الطريق السريع، تكتب ديديون على لسان راو غير معلوم الهوية: «كانت تقود مركبتها مثلما يقود البحّار مركبه.. فيكون كل يوم أكثر اعتياداً على موجات البحر وأحابيله. وكالبحار كانت تحسّ، في هدأتها ما بين النوم واليقظة بالشلالات التي تحاول اجتذابها». لا تعلم إلى نهاية الرواية من أي شيء تحديداً تهرب ماريا إلى الطريق السريع أو إلى التيه. لا تعرف اللحظة التي غيّرت ماريا وجعلتها لا تبحث عن إجابات لأي أسئلة تدور في ذهنها، عكس اللحظة التي تبدلت فيها حياة ديديون نفسها لحظة موت زوجها كما ذكرت في سيرتها الذاتية «عام التفكير السحري». تبدو ماريا طيلة العمل كبحار تائه عن مرساه، أحياناً تومض حدثاً ما ليظن القارئ أنه على مقربة من لحظة تغيّر ماريا ثم تفاجئه بأنها ليست هي اللحظة. تظل اللعبة مستمرة وتحكي ماريا حياتها خلال ومضات غير متتابعة زمنياً. عبر الومضات هذه، تحطم ديديون أي بناء متكامل للرواية. لا تجعلها رواية تدور حول بطلتها أو حتى حول راو عليم، بل شذرات ومشاهد منقطعة السياق، تثير فيك محاولة معرفة اللحظة.
في لحظة ما أثناء القراءة، تجبرك ديديون على الركض وراءها في طريقها السريع هذا. تسحب قدميك لتدخل إلى التيه الخاص بماريا، لا لتبحث عنها، بل لتبحث عن لحظة تحولها إلى شخص يشعرها التمهل بخطر غريب. لذا تلجأ إلى الطرق السريعة لتهرب من هذا الخطر.
تستمر لعبة الركض وراء الومضات هذه، وتختفي نبرة الراوي العليم، أو يتغير الراوي. لا تعرف حتى النهاية من يروي حياة ماريا، تلهث وراءها ويتغير مكان الركض من الطريق السريع إلى حانات، إلى فنادق تهرب منها ماريا بحثاً عن العودة إلى الطريق السريع. لا خطوط سردية تتبعها لتصل إلى معنى، بل إنّ كل الخطوط تدفعك إلى اللهاث لتصل إلى تيه شخصية لا تبحث عن سؤال. هي تلهث وأنت تلهث خلفها غير عابئ بأي شيء تبحث عنه هي. تدفعك الرواية كلها إلى اللهاث، تقرأها وأنت تلهث، لكن تخرج منها شخصاً آخر، شخصاً راغباً في قراءة العمل مرة ثانية لتعي كل ومضة من ومضات حياة ماريا. اللهاث الذي ترغم ديديون القارئ عليه، يدفعه إلى إحضار كل كوابيس تيهه الشخصي، وربما هذا هو الأدب فعلاً أو دوره الأساسي أن تخرج من قراءة عمل وأنت لا تنتمي إلى شخصك ما قبل القراءة. كل عمل قادر على خلق مثل هذا الشعور يمثّل أدباً رفيعاً. كل عمل يجبر القارئ على اكتشاف تيهه الخاص من خلال عملية القراءة هو عزاء للقارئ ونجاح لكاتبه أو كاتبته.
يرى تيرى إيغلتون في كتاب «نظرية الأدب» إنّ الأدب عزاء وأرضية مألوفة بالنسبة إلى الإنكليز لسبر كابوس التاريخ بعد الحرب العالمية. ولو حذفت كلمة الإنكليز من الجملة، لن تختل، أو تصبح منقوصة، بل ستظهر دور الأدب بأنه عزاء للإنسان، وخالق للمعنى في حياة بلا أي معان. حياة تشبه حياة ماريا. حياة إنسان على طريق سريع، لا يهرب مثل ماريا من فجيعة حياته، بل يهرب إلى الطريق السريع مجبراً بسبب ما فرضته الحداثة عليه من أساليب تجعله يركض دائماً.