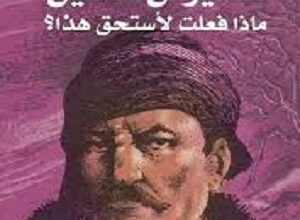رهانات الرواية في المرئيات

القراءة هي قدر كل نصّ كما يقول الناقد المغربي سعيد بنكراد، وعملية توالد الدلالات والتأويل وإضاءة المعاني المضمرة تبدأُ مع لحظة القراءة التي هي عبارة عن سدّ الفجوات في النصّ وتحقق للتجاورية بين الملفوظات التي يقومُ عليها خطابُ النصّ.
أصحاب نظرية التلقّي يذهبون إلى أنّ الحقيقة لا تكمنُ في النص بل هي وليدة أنماط وأشكال تثير القارئ الذي ينهضُ بصناعة الحقائق. هذه الرؤية ليست بعيدة عن مقولة نيتشة “لاتوجدُ الحقيقة إنما فقط التأويل”، طبعاً تتباين أنواع القرّاءِ ومستويات القراءة.
قد تكونُ القراءةُ غير منتجة ولا تُضيف إلى النصّ وتعجز عن إدراك ظلال الكلمة وجرس المعنى ولا تنفذُ إلى أبعد من ظاهر العبارات المُباشرة، فبالتالي تنفدُ شحنة الدلالة الإستعارية بينما هناك قراءة أخرى يُعَوَّلُ عليها لثراء النص واستنطاق معانٍ مُخبئة.
نص غير مُنكفئ
ما يفرّق النصّ الروائي عن نصوص أدبية أخرى هو مرونته وإمكانيةُ تصريفه في سياقات متعدّدة، وتحويله إلى صورة مرئيّة. لذا ما أنْ تنجحَ روايةُ وتتوسّع حلقةُ قرّائها حتى يزدادُ تحمّسُ صنّاع السينما لنقلها إلى الشاشة ليكون النصُّ بذلك مقروءاً ومرئيّاً في الوقت ذاته.
ربما يفسّر البعضُ هذا التلقّف لروايات ناجحة بأغراض تجارية تهدف إلى تأصيل ظاهرة الفرجة على كل المستويات، بحيثُ يخدمُ الفنُ والأدب حركة السوق، ويصبحُ الأبطالُ مروّجين للسلع، هذه النظرة لا تجانب الصواب غير أنَّ العملية بأكلمها لا تخلو من الفوائد بالنسبة للنصّ الأدبي، الذي يُشاهَدُ في حيز صورة سينمائية أو دراما تلفزيونية.
من الرواية إلى السينما
وفي هذا السياق، يحكي الفيسلوف والروائي الإيطالي إمبيرتو إيكو موقفاً طريفاً عن تحويل روايته “اسم الوردة” إلى عمل سينمائي، إذ لا ينكر دور الفيلم في الترويج للرواية أكثر، مشيراً إلى أنّ صبية قد صادفت روايته في إحدى المكتبات هتفت قائلة “لقد حوّلوا الفيلم إلى الرواية”.
هذا المنطوق يكشف عن التفاعل القائم بين الشاشة والنصّ الروائي، ناهيك أنّ عدداً كبيراً من الروائيين امتهنوا كتابة السيناريو، وكان نجيب محفوظ أشهر كاتب عربي تمّ تحويل معظم أعماله إلى الشاشة، فهو كتب سيناريو مجموعة من أفلام ناجحة.
وعمل الروائي الأميركي دان براون ضمن كتيبة كُتّاب السيناريو في هوليوود قبل أن يتّجه إلى الرواية. كما أنّ ماريو فارغا يوسا إختبر كتابة سيناريو فيلم مُقتبس من إحدى رواياته. وليس الروائي السوري خالد خليفة آخرَ مَن احترف صنعتين (الرواية والسيناريو).
قد تستشفُ مما ذكرَ آنفاً وجود التداخل بين الرواية وفنّ السينما، لكنّ هذا لا يعني تجاهل الاختلافات في الوسائل التعبيرية لدى صانع الفيلم ومؤلف العمل الروائي. وما يعتمدُ عليه الاثنان من المؤثّرات لتطعيم المادة بعناصر التشويق.
بين رؤيتين
من الواضح أنّ هناك تبايناً بين رؤيتي المخرج وكاتب النص الروائي، لذا يقول نجيب محفوظ بأنَّه مسؤول فقط عن نصّه المكتوب وعندما يتمُ استلهامه عبر وسائط تعبيرية أخرى يُفضّلُ عدم التعليق عليه نظراً لاختلاف الأدوات والشروط.
لعلَّ وجه الاختلاف الأبرز بين الرواية والفن السابع أنّ الأولى توظّف اللغة لبناء عالم موازِ، والثاني يراهنُ على الصورة بوصفها أداة رئيسية في تركيبة المادة الفيلمية، علماً أنّ الأفلام السينمائية في البداية كانت صامتةً غير ناطقة ومن ثُمَّ أصبحت اللغة مصدراً للمعلومات في بنية الفيلم.
يقولُ المخرج المصري الشهير صلاح أبو سيف إنّ اللغة السينمائية ليست هدفاً بحدّ ذاته ولا يجوز أنْ نَحْكُمَ على هذا العُنصر من الناحية الجمالية بل من مقدار الخدمة التي يؤدّيها للقصة. ويرى كريستيان ميتز بأنَّ لغة السينما بلا نظام شفري، ولا يُمكن إحالتها إلى شفرة كائنةٍ بخلاف اللغة اللفظية.
فوق هذا فإنَّ الإستعارات في السينما تقوم على تلاحم صورتين بواسطة التوليف بحيثُ تنتجُ عن مقابلة إحداهما بالأخرى صدمة سيكولوجية كما يشرح ذلك مارسيل مارتن في كتابه “اللغة السينمائية”، إذاً يكون التركيز في السينما على الصورة لمُخاطبة المتفرّج الذي ينساق وراء التأثير البصري حتى ولو كان الفيلم رديئاً للغاية، وهذا ما يميّز السينما عن الفنون الأخرى حسب رأي صلاح أبو سيف. إضافة إلى أنّ تعقيد المعنى في النصوص لا يصعبُ إيجاد ما يقابله من الصوَر المعبّرة في السينما.
ويكمنُ ذكاء المخرج في تحديد ما لا يخدمُ عمله في المادة المكتوبة ولا يضيفُه إلى البعد الدرامي في تسلسل الأحداث، لأنَّ لغة الصورة مؤسسة على الإيجاز والإيحاء وكما يقول جاك فايدر إنّ “المبدأَ في السينما هو الإيحاء”، إذ قد يكون التعبير عن مضي سنوات طويلة بصورة مرور سحاب أو بظهور تاريخ على الشاشة.
ونحنُ إذ ذكرنا بعض خصائص السينما علينا ألا نتغافل أنّ مُشاهد الفيلم محكوم برؤية المخرج وبما حدّده للنصّ من أطر صورية، بينما قارئ النص هو مشاهد خلّاق على حدّ قول ماريو فارغا يوسا يتخيلُ الصور كما يشاء.
غياب التواصل
وعلى رغم وفرة الإصدارات الروائية في السنوات الأخيرة، وتصاعد الاهتمام بهذا الجنس الأدبي على صعيد النخبة والعامة ورصد جوائز عديدة للأعمال الروائية، إلّا أنّ هناك شحّاً في المحاولات الرامية لنقلها إلى الشاشة، ونادراً ما نصادف ما يعرض على القنوات الفضائية عملاً درامياً مأخوذاً أو مقتبَساً من رواية ناجحة، إذ يقعُ معظم المخرجين في شرك تكرار الأعمال الأجنبية دون أن يفلحوا في تبيئتها، بعكس ما كان سائداً في الحقب السابقة، إذ لا تزال الأفلام والمسلسلات المستوحاة من روايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعي حاضرةً في ذاكرة الفن الدرامي والسينمائي، باعتبارها مُنبثقةً من واقع المُجتمع بأبعاده المختلفة، ومستمَدةً من أنماط المعيشة، والصراعات القائمة بين التيارات المُتعارضة.
التواصل بين النص الروائي والمرئيات يُضاعف من جودة الأعمال الدرامية ويثيرُ رغبة المتابعين للمقارنة بين ما يقع بين مستويَين (النص والصورة) مثلما نجد هذه الحالة مع الأفلام الأجنبية المأخوذة من الروايات إذ نجحت رواية “فتاة القطار” وحققت شهرة واسعة لكاتبها بولا هوكينز، لكن فشلت سينمائياً وفقاً لآراء غالبية النقاد والمشاهدين، وفي المقابل نجحت رواية “أنا قبلك” لجوجو مويس سينمائياً بعدما حظيت بمستويات رفيعة من المقروئية.
يُذكر أنّ بعض الروايات العربية الصادرة أخيراً منها “حي الدهشة” لمها حسن، “ليالي إيزيس كوبيا” لواسينى الأعرج تتحلّى بمواصفات ترشِّحها للمعالجة الدرامية لجهة رسم الشخصيات بالدقّة وتحديد البعد المكاني فضلاً عن التوتر والاصطراع النفسي والمجتمعي والتماسك في بناء النص.
ميدل إيست أونلاين