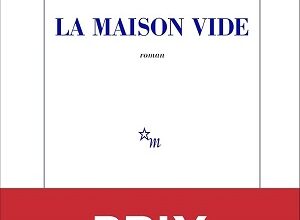على أبواب الذكرى الثالثة لـ”ثورات الربيع العربي” الخارطة مازالت متحركة (عامر راشد)
عامر راشد
مازالت بلدان "ثورات الربيع العربي" بعيدة عن تحقيق الشعارات التي رفعها الحراك الشعبي المعارض لأنظمة الحكم الاستبدادية، وفي غالبية تلك البلدان فشلت أنظمة الحكم الانتقالية في استعادة الأمن والاستقرار، والتخفيف من التوترات السياسية والمجتمعية، في ظل ميزان قوى متحرك تتجاذبه صراعات حلفاء الأمس في الثورات.
تختزل مشاهد الاحتراب السياسي التناحري في بلدان ما يصطلح على تسميته "الربيع العربي"، بين القوى والتيارات التي انخرطت في إطار الحراك الشعبي وأنشأت ائتلافات قيادية للثورات، وفي حالات أخرى مثل الحالة السورية، وبدرجة أقل الحالة الليبية، اتخذ الصراع أشكالاً دموية بين طرفي الأزمة، وزادت من عمقه وحدته التدخلات الخارجية بمظاهر شتى.
تونس صاحبة "ثورة الياسمين"، التي كانت الملهمة للحراك الشعبي في بلدان عربية أخرى، تقف اليوم على مفترق طرق سيحدد مصير الثورة، وذلك بنتيجة الاختبار الذي تخضع له منذ شهور قواها من حيث مقدرتها على حل التناقضات الداخلية بينها، عبر إيجاد أرضية وطنية مشتركة يقف الجميع عليها، قوامها برنامج مشترك يمنع الاستفراد والاستئثار بالسلطة والقرار الوطني، ودرء خطر ما يحمله الاستفراد والاستئثار من إعادة إنتاج نظام استبدادي شمولي تحت عباءة أخرى، تتهم القوى اليسارية والليبرالية قوى "الإسلام السياسي" بأنها تسعى إلى إنتاجها، بينما تتهم حركة "النهضة" خصومها بأنهم لا يحترمون نتائج صندوق الانتخابات ويريدون القفز عنها.
وبقراءة حجج وادعاءات كلا الطرفين، لا يمكن رسم صورة للمشهد التونسي تكون مفهومة ومعبرة عنه، إلا بأخذ خلاصة ما يستنتج من وجهتي النظر المتناقضتين، وهي أن القوى التي انخرطت في "ثورة الياسمين"، وساهمت إلى جانب الحراك الشعبي في الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لم تستطع أن تضبط تناقضاتها الداخلية، بما يشكل هذا شرطاً لوصول الثورة إلى بر الأمان، بتحقيق التغيير المنشود في نظام سياسي ديمقراطي تعددي، يصونه دستور مجمع عليه وطنياً في ظل دولة مؤسسات تحترم حقوق المواطنة، ولاسيما مؤسسة قضاء مستقلة ونزيهة وعادلة. وما علمتنا إياه التجربة التونسية في دروسها، التي مازالت تتوالى، أنه إذا كان من بديهيات الديمقراطية احترام نتائج صناديق الانتخاب، إلا أنه يجب أيضاً الانتباه إلى أن المزاج الجماهيري والسياسي سريع التغير في المراحل الانتقالية التي تمر بها الثورات، ومغبة ذلك على كل القوى السياسية والمجتمعية التمسك ببرنامج المشترك الوطني، لعبور المرحلة الانتقالية، أو بالأحرى المرحلة التأسيسية لنظام الحكم السياسي الجديد، بما يستجيب لمطالب وتطلعات الحراك الشعبي.
والقانون نفسه ينطبق على الحالة المصرية، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن حدة التناقضات بين تيار الإسلام السياسي" والقوى الليبرالية والقومية واليسارية كان أعمق بكثير من نظيرتها في الحالة التونسية، وهو ما أدى إلى انقسام قوى "ثورة 25 يناير" على نفسها، وتدخل الجيش إلى جانب من طالبوا في مظاهرات 30 يونيو/حزيران بعزل محمد مرسي أول رئيس منتخب. وليس من الواضح ما ستكون عليه الصورة في الأيام القليلة القادمة بالنسبة لـ"خارطة الطريق" التي وضعت لمرحلة ما بعد الرئيس مرسي.
وتواجه الحكومة الانتقالية في اليمن مهمات صعبة لاستكمال تنفيذ عناصر المرحلة الانتقالية، ليس فقط ضعف بنية مؤسسات الدولة والأوضاع الاقتصادية الخانقة والاقتتال القبلي والفساد وخطر تنظيم "القاعدة"، بل وفوق كل ما سبق محاولات تقسيم البلاد بالعودة إلى ما قبل دولة الوحدة ما بين دولتي الشمال والجنوب عام 1990، وكما في الحالات الأخرى في بلدان "الربيع العربي"، تظهر قوة تأثير أدوات الدولة العميقة وقدرتها على التأثير السلبي في التجربة الديمقراطية الوليدة.
وبدورها مازالت ليبيا تشكل استثناء في المسارات الخاصة التي اتخذتها في سياق "الربيع العربي"، بدءاً من مفاجأة انطلاق حراك شعبي ليبي معارض في بنغازي، مروراً بتحول الحراك الشعبي المعارض إلى صراع مسلح واستدعاء تدخل عسكري خارجي ومقتل العقيد معمر القذافي بوحشية مفرطة، وصولاً إلى إجراء أكثر من عملية انتخابية ناجحة، لكنها في الوقت عينه فشلت في حل التناقضات بين القوى السياسية، أو فرز حكومة قوية قادرة على استعادة الأمن والاستقرار، والشروع في بناء دولة مؤسسات، مازالت تفتقد لها ليبيا منذ عام 1969عندما فككت بنية الدولة وتم استبدالها بما سمي بسلطة "اللجان الثورية".
وبعطف المثال الليبي على الأمثلة السابقة، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، إن افتقار القوى السياسية والمجتمعية إلى رؤية مستقبلية مشتركة، أو متقاربة بالحدود الدنيا المطلوبة، يجعل المرحلة الانتقالية مفتوحة على كل الاحتمالات، حتى الآن معظمها لا يصب في مصلحة ليبيا الواحدة الموحدة، ولا أحد يستطيع أن يجزم في المآل الذي ستنتهي إليه الصراعات السياسية المتشعبة مع ما يرافقها من عنف وضغوط تمارسها الميلشيات القبلية والجهوية المسلحة، على خلفية مطالب فئوية تضرب المصالح الوطنية العليا عرض الحائط.
ويشكل العراق والسودان نموذجين خاصين بين البلدان العربية، حيث تأرجح البلدان في السنوات الماضية بين الحرب الأهلية والصراعات السياسية الحادة، وكانا الأكثر تأثراً بنتائج وتداعيات ثورات "الربيع العربي"، سواء لجهة الجوار الإقليمي، أو لجهة أن الأوضاع الداخلية للبلدين تشبه في عدم استقرارها السياسي والأمني، في العديد من الجوانب، أوضاع بعض بلدان "الربيع العربي"، وهما أيضاً المرشحان في المستقبل كي يكونا حلقات جديدة من حلقات حراكات شعبية واسعة تشق مسارات خاصة، تفرضها طبيعة المشكلات التي يواجهها البَلدان، وقد بات من المسلم أن بقاء القديم على قدمه لم يعد ممكناً.
النظام السياسي القائم في لبنان يرزح بدوره تحت مناورات الهروب من مأزق مرض الطائفية السياسية، التي ما عادت قادرة على حل تناقضاتها بصفقات سياسية فوقية، حيث تفجرت العلاقة بين مكوناتها بعد جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وألهبتها تداعيات الأزمة السورية، والشهور الخمسة القادمة يمكن أن ترسم ملامح المعادلات السياسية الداخلية الجديدة.
أما في سوريا فقد انتهى عملياً الشكل الجماهيري السلمي للحراك المعارض بعد انقضاء الشهور الستة الأولى من الأزمة، وانحرفت الأزمة إلى حرب بين الجيش النظامي وحركات المعارضة المسلحة، وفي الشهور الأخيرة برز حجم هائل من التناقضات بين صفوف الأخيرة، مما أضفى على الأزمة أبعاداً مركبة، فضلاً عن الخلافات الحادة بين الإطارات السياسية للمعارضة السورية، إزاء توصيف الأزمة والبحث عن حلول سياسية لها، واتضح ذلك في الموقف من بيان اجتماع "جنيف 1" والجهود المبذولة لعقد مؤتمر "جنيف 2".
وبتجميع كل أجزاء الصورة، ستبقى الخارطة السياسية متحركة في كل بلدان ما يصطلح على تسميته "الربيع العربي"، ومهما تغيرت مخرجاتها لا يمكن أن تعبر تلك البلدان المرحلة الانتقالية بأمان، أو إنهاء الحرب كما في الحالة السورية، والاحتقان السياسي- الطائفي كما في العراق ولبنان، إلا ببرامج قاسم وطني مشترك تفتح الطريق أمام التغيير الديمقراطي والتعددية بوسائل سلمية بعيداً عن العنف.