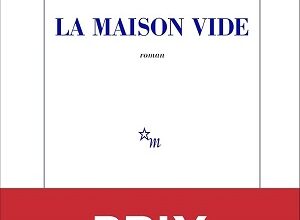قراءة في وثيقة تبرئة خالد محمد خالد الدين والحرية ورغيف الخبز

الجرأة هي في إعلاء شأن الفكر في مجتمع مغلق على معتقدات مبرمة ونهائية وقمعية. «فمجانين نحن إذا لم نستطع أن نفكر ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر»، كما قال أفلاطون، وهذا ما دفع خالد محمد خالد إلى تحدي «المقدس» الشعبي، وحصن المؤسسات الدينية الراسخة.
«إن ظلام العالم كله، ليعجز عن إطفاء شمعة»، وهذا ما حدث. في الحقب السود، في انعدام الرؤية، في طغيان العصبية، في انسداد الأفق، في بلوغ حافة اليأس، في فقدان الأمل، في تعاظم الجهل، في اختناق الحرية، في سيادة الأمية، في تفوق الموت على الحياة، في كل ذلك… يحدث أن تستيقظ من الكابوس، على قبس من ماض، يعيد الحياة إلى الروح، فيحثها على التشبث بالمحاولة… ما وصلت إليه الأمة من غيبوبة في وعيها، يمكن استعادته بشروط الحرية وبشروط الفكر الحر وانتصارهما على الجمود والتخلف والغباوة والظلم والاستبداد.
بتاريخ 27 أيار سنة 1950، أصدر رئيس محكمة القاهرة الابتدائية قراراً تاريخياً، أمر فيه بإلغاء الأمر الصادر بضبط كتاب «من هنا نبدأ» لمؤلفه خالد محمد خالد، والإفراج عن الكتاب فوراً. تفيد استعادة الحكاية، واستعراض الحجج التي أوردتها هيئة المحكمة دفاعاً عن الكتاب ومضمونه، رافضة بذلك الاتهامات التي ساقتها لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، التي خلصت إلى أن هذا الكتاب قد وضع بروح تناصب الدين العداء السافر.
دعمت لجنة الفتوى اتهاماتها بـ»البينات» التالية:
أ ـ حدد المؤلف «الحكومة الدينية بخصائص وغرائز من شأنها أن تبعث في النفوس محاربة هذا النوع من الحكم».
ب ـ «مهمة الدين لا تعدو الهداية والإرشاد».. وما قام به الرسول «من قيادة الجيوش والمفاوضات وعقد المعاهدات وغير من مظاهر السلطة التي يمارسها الحكام، لم يكن إلا لحكم ضرورات اجتماعية». أي ان المؤلف ينفي عن الرسول، في قيامه بهذه الأفعال، المهمة الدينية. فهو شأن زمني لا ديني.
ج ـ ان تنفيذ الحدود غير ممكن.. وجميعها موقوفة عن العمل، وليس هناك مجال لإقامتها، كحد السرقة وحد الزنى وحد الخمر. فالعقوبة لا تصلح المجتمع.
د ـ الهجوم على رجال الدين وعلى الرأسماليين وهذه سمة الشيوعية والشيوعيين.
قبل أن يتلى قرار المحكمة، كان الكتاب قد تعرض لمحاولات منع كثيرة، تظهر معاناة المفكر ومحنة الفكر وثبات التعارض بين فلول المنع المنظمة وأصحاب الرأي المتروكين في العراء، إلى أن يأتي أمر من نخـــــب فكرية وســـــياسية وقضائية، فتحتضن الشمــــعة وتمنع العتمة من ابتلاعـــــها.
كان اسم الكتاب: «بلاد من؟». وكانت فصوله خمسة: «إنسانيون ـ الدين لا الكهانة ـ الخبز هو السلام ـ أسرار المجتمع ـ الطريق». ولم يحضر فصل «قومية الحكم» في الكتاب، لأسباب لها علاقة بكون أصحاب الفكرة كانوا يومئذ في السجون والمعتقلات.
عندما دفع الكتاب للمرة الأولى إلى الطبع، زج به في القبو ومنع من القراءة. تغيّرت الوزارة، وحصل التماس بإعادة النظر في الكتاب الحبيس. فحصل الإذن، وتعدّل العنوان وحمل الكتاب اسمه الشهير، «من هنا نبدأ».
لم تعمر فترة السماح طويلاً. فعلى حين غفلة، انقض البولس على المكتبات وضبط نسخ الكتاب تمهيداً لمصادرته… ووقف الكتاب أمام القضاء متهماً بالخروج على الدين وترويج الشيوعية وتحريض الفقراء على الرأسماليين. وبعد الإفراج عنه، بدأ الحديث عن محاكمة أخرى، تجريها «هيئة كبار العلماء» بالأزهر. والقرار الذي أصدرته المحكمة جاء ليؤكد حق حرية التفكير، فكان القرار وثيقة من وثائق الحرية والعدل والرقي، ومنارة يستضاء بها في الأيام السود. ومن هنا كانت العودة إلى هذه الوثيقة التي تعتبر أساساً متقدماً على الأحكام القضائية التي صدرت في ما بعد، مستسهلة تكريس قاعدة المنع، في مصر ولبنان، ولا نأتي على ذكر البلدان الأخرى، لأنها متسلّحة بالصمت والقمع والخـــــوف من أصوات «الكهانة» التي تتمتع بذكاء انتـــــهازي متقدم وبغباء ديني متقادم.
ماذا كان في حيثيات قرار هيئة المحكمة؟ كيف رأت إلى الدين؟ كيف رأت إلى الحدود؟ كيف رأت إلى الدولة؟ كيف رأت إلى الزكاة والصدقة والنظم الاجتماعية؟ إن حيثياتها، إن تليت اليوم، في أزمنة التكفير وحقب التعصب، فستبدو هرطقة وكفراً واعتداء على الذات الإلهية وعلى مقام الرسول وعلى سلطة النص والأحاديث، ورواة السيرة.
فنّد القرار ما نسب إلى خالد محمد خالد من جرائم، ضد الدين ورجال الدين وضد الرأسمالية، باستعراض ما وفره الكاتب من حجج، بطريقة أبرز فضائلها، وأسندها إلى أصول في النص الديني، وفي التجربة التاريخية، وفي السيرة النبوية، وقد انتقى منها ما يفيد الكاتب وما يسفّه دعاة التجريم.
هنا بعض المسائل التي فندها القرار:
أ ـ الكتاب نادى بقومية الحكم، ورد على الرأي القائل بضرورة قيام حكومة دينية. وقد أيد قوله بأقوال للرسول، منها رواية عن عمر بن الخطاب، عندما دخل عليه فوجد الرسول مضطجعاً على حصير قد أثر في جنبه فقال له: «أفلا تتخذ فراشاً وطيئاً لينا يا رسول الله؟» فأجابه: «مهلاً يا عمر، أتظنها كسروية، إنها نبوّة لا ملك». وقال: «لست كأحدهم، إنما أنا رحمة مهداة».
إذا كانت حكومات العصر الإسلامي الأول قد حققت النجاح والتقدم، فإن ذلك يعود إلى الكفاية الشخصية والكمال الذاتي اللذين كان يتمتع بهما رؤساء تلك الحكومات، من الخلفاء الراشدين.
أما التجربة التاريخية فقد أفضت في الغالب، إلى تنافس على الحكم وفتنة بين الناس وقادتهم وبين القادة بعضهم بعضاً، وإلى نوع من الحكم ليس بينه وبين الدين وشيجة وان زعم أصحابه أنه حكم ديني، بل حكم الله ورسوله.
واستعرض القرار أقوال المؤلف في الحكومة الدينية: «الحكومة الدينية لا تستلهم مبادئها وسلوكها من كتاب الله وسنة رسوله بل من نفسية الحاكمين وأطماعهم ومنافعهم الذاتية، وهي تعتمد في قيامها على سلطة غامضة لا يعرف مأتاها ولا يعلم مداها… وحين تسأل عن دستورها، تقول الدين، هو القرآن. «لقد استغل بعض الحكام بعض آيات القرآن استغلالاً مغرضا». لقد استغلت الآيات نفسها إبان الصراع بين علي ومعاوية والخوارج. ما كانوا يقدمون من الآيات والأحاديث هي نفسها الآيات والأحاديث التي كان يحرّض بها أصحاب معاوية على ذم علي وقتاله، وببعض هذه الآيات قُتل عثمان، وبها ذاتها قتل الخوارج علياً، كما قتل يزيد الطاغية الحسين بن علي، مبرراً فعلته هذه بآية وحديث استمسك بهما.
ويؤكد القرار أن أسوأ الحكومات في التاريخ، هي الحكومات التي حكمت الناس باسم الدين، سواء كانت مسيحية أو إسلامية. هي الحكومات الأسوأ، ما عدا قلة فاضلة، ولا يبنى على الاستثناء.
ب ـ الحكومات الدينية لا تقضي على الرذائل، ولا تنتصر للفضائل. وليس من الضرورة إقامة الدولة الدينية لتطبيق الحدود، ففي الإمكان وصفها كنص قانوني في دولة لا دينية. ثم إن تطبيق بعض الحدود يبدو صعباً إلى حد الاستحالة. فلقد أقيم حد الزنا أيام الرسول مرات معدودة، وما كان تطبيق الحد بالبينة، بل باعتراف المرتكب، نزولاً عند حالة تطهر أو تطبيق لمبدأ تطهير النفس. «إن الإقرار بالزنا نادر الحصول وبينته أربعة شهود عدول مسلمين ويشترط فيهم أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة كالمرور في المكحلة والرشاء في البئر. فهل يعقل أن يحدث ذلك؟. أما بينة الخمر فيلزمها شاهدان مع اعتبار أن الشارب شربها مختاراً عالماً بأنه مسكر»، فمن يعرف ما إذا كان الشارب عالماً أم جاهلاً؟ وهكذا دواليك. أما حد السرقة، فقد ألغاه عمر في زمن المجاعة.
ج ـ لا حاجة للدين إلى دولة، فهو حقائق خالدة لا تتغير ووظيفة الدين الهداية والإرشاد إلى أنبل ما في الحياة من فضائل… وكلام الله يهدي إلى الحق والفضيلة والصلاح… السياسة في الدولة الدينية لا تمت إلى نص الدين وروحه. رجال السياسة في الدول الدينية يستغلون القرآن استغلالاً سيئاً ويسفكون دم المسلمين، متسلحين ببعض الآيات والأحاديث، مستغلين ما تحتمله من معان ومن وجوه. والقرآن «حمال أوجه» و«ذلول ذو وجوه» (عن أبي تميم) وان «لكل آية ستين ألف فهم» (الألوسي) الخ.
وتعلق المحكمة على كل ذلك، بأن المؤلف لم ينكر ركناً من أركان الدين ولم ينتقص من قدر رسول الله، وما جاء في هذا المقام، مؤيد بالعقل ووقائع التاريخ وغايات الرسالة. وجاء في نص القرار، أن المؤلف «لم يطعن في الدين ولم يجحد كتاب الله وسنة رسوله… بل قال: إنه يجب تقديم الدين للناس وضيئا متألقاً كيوم نزوله من لدن عزيز حكيم، وهو لم يخرج عن حد البحث العلمي والفلسفي، وإذا صح انه أخطأ في شيء مما كتب، فإن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شيء، وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شيء آخر». وما جاء في الكتاب لا جريمة فيه ولا عقاب يستحقه.
وتدافع هيئة المحكمة عن موقف المؤلف من الزكاة، ومن النقد الذي يوجهه لنظام الزكاة والرأسمالية المجحفة والكهانة التي تتمثل بتسليم الدين، وهو شأن عظيم، لمن لا يقرأ ولا يفقه ولمن يأخذ النص على ما يهواه وما يطيقه عقله وما يلبي نزواته. ومن خلال مطالعة المحكمة يستشف من فهمها أنها تدرك الارتباط العميق، بين الكهانة بين الأنظمة الجائرة والمستبدة اقتصادياً. تقول المطالعة إن المؤلف استعرض الحالة الاجتماعية في البلد (مصر) ونقد منها ما رآه خليقاً بالنقد، وحسن ما رآه حسناً. فقد نقد الرجعية الاقتصادية والرأسمالية المتطرفة وأفصح عما تعانيه غالبية الشعب من فقر وحرمان وما بدا عليها من تذمر، بينما قلة من الشعب تنعم بالثراء الوفير… هذا نقد إصلاح».
ما حدث في مصر منذ 64 عاماً، بات أمراً منسياً. استذكاره اليوم، إعادة لروح التفاؤل بالعقل واحترام حرية التفكير. ولو ان هذا الكتاب عرض على محكمة مدنية، لاضطرت لأن تخضع إلى ما يقوله «كهنة» الدين، مسلمين ومسيحيين، ولقد سبق أن أقدمت المحاكم في لبنان على ارتكاب أحكام ضد حرية الفكر، وحرية التعبير الفني، أبرزها محاكمة صادق جلال العظم. أما مقص رقابة الأفلام والمسرح، فهو يعمل بوحي وحيد، هو وحي المرجعيات المذهبية.
وللدلالة على خطورة ما بلغناه، في زمن «داعش»، ما يمكن أن يحصل للكتاب وصاحبه أن حمل العناوين التالية. «الكهانة تتوسل بالمسجد والمنبر تقويض المجتمع»، «الكهانة تحارب العقل»، «الفرق بين الدين والكهانة»، «مواكب الجمعة (المساجد التي يعلو منابرها أميون ويجرعون الملايين كل صنوف السموم) «لا روحانية مع الحرمان» نقد «اشتراكية الصدقات»..
ولعل أفضل ما يستند إليه في كتابه هو قول لفولتير: «رجل الدين الغبي الجاهل يثير احتقارنا، ورجل الدين الشرير الرديء يولد الجزع في نفوسنا، أما الناضج المتسامح، البعيد عن الخرافات، فهو الجدير بحبنا واحترامنا».
إن إعادة الاعتبار لهذه الأنوار، أمر ضروري وصحي في عصر الظلمات الذي يجتاح هذه المنطقة. عصر إبادة الدين والعقل والحرية والإنسان.
صحيفة السفير اللبنانية