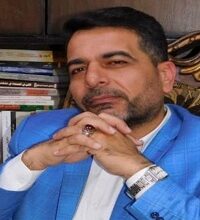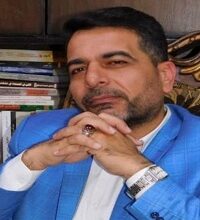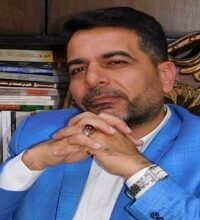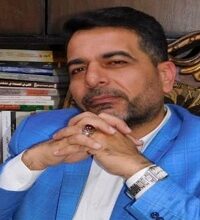المُساهَمات التي قدَّمَها معظمُ الباحثينَ المُشاركينَ في وقائع اللقاء تجاوزَت ما اعتادَتْهُ قاعاتُ الفِكْرِ المُكرَّرِ في غالبيّةِ دُوَلِنا العربيّة، إلى درجةِ أنَّ بعضَ المُشارِكينَ والحاضرينَ في قاعة “أوتار” في فندق “البريستول” نظرَ كُلٌّ منهم إلى الآخرِ بدهشةٍ لا تخلو من السّعادةِ والأمل بأنْ يكونَ هذا الطرحُ وهذه المُقارَباتُ خطوةً أولى في الانتقال العمليِّ إلى فضاءٍ تنويريٍّ حقيقيٍّ في المجال العربيّ، على الرَّغْمِ من صُعوبةِ الأسئلة في هذا الجانب، وانعدام الإجابة عنها في أحيانٍ كثيرة، وتوالي الصَّدَماتِ، وحال الذُّلِّ والتّخلُّفِ التي أصابَتْنا، واسْتَحْكَمَتْ فينا.
وإذا كانت مسألةُ التَّحْقيب والارتكاز المُطلَق على المركزيّةِ الأورُبّيّة في مسألة التنوير قد جعَلَتْنا أسْرى هذه القناعاتِ المُضلِّلة فإنَّ تاريخَ المنطقةِ والعالم يشهدُ على مُحاولاتٍ تنويريّةٍ ضاربةٍ في عُمقِ التاريخ والحضارة في بلادِ الرافدين وفي مصر وسورية والصّين، وهي مُحاولاتٌ تعودُ إلى أكثرَ من ثمانيةِ آلافِ عامٍ في بعض البُلدان، لكنَّ الانبهارَ بالآخر ورَفْضَ تعميقِ البحث وتوسيع دائرة التَّفاكُر العلميّ والمعرفيّ والحضاريّ يجعلُ أبناءَ الأُمّةِ ينتقلونَ من ظُلْمةٍ إلى أُخْرى، ومن جهلٍ إلى تَخلُّفٍ، بعيداً عن الفكر العقلانيِّ الذي يجبُ أن يكونَ شديدَ السَّعَةِ والاستيعاب للآخَر، وأن يكونَ قائماً على التَّحريكِ المُستمرِّ للوَعْي، وهو تحريكٌ مُرتبطٌ بفحصِ المُسلَّماتِ التي غالباً ما تقودُنا إلى الاقتتالِ والاحترابِ والارتماءِ في أعماقِ الجهلِ المعرفيّ، ولعلَّ هذا عائدٌ إلى الوصايةِ والولايةِ المُتحكّمةِ بالعقلِ العربيّ وبآليّاتِ تفكيره، وهي وصايةٌ من شِقَّين: شقّ مُقدَّس يقومُ على التأثيمِ والتَّفْسيقِ والتكفير لكُلِّ مَنْ يُحاوِلُ إعمالَ عَقْلِهِ وانتقادَ الزَّيفِ الدينيِّ المُقدَّس المُوصِلِ إلى الجهلِ والمانعِ لسُلوكِ طُرُقِ التنوير، وشقّ يقومُ على التبعية للغربِ وتنويره وعَدِّهِ المُخلِّصَ لنا ممّا لَحِقَ بنا من جهلٍ وتَخلُّفٍ دونَ البحث في الدَّوْرِ الغربيّ في هذا، ولعلَّ ما قامتْ به المملكةُ المُتّحدةُ والإمبراطوريةُ النمساويةُ من منعِ إبراهيم باشا من الوصول إلى الأستانة ودفاعهما عن الإمبراطوريّة العُثمانيّة على الرغم من العَداءِ معَها، يُجيبُ عن بعض الأسئلة المُسْتَعْصِيَةِ في هذا الشأن.
إنَّ الاعتمادَ على الإسنادِ الداخليِّ للمشروعِ التنويريِّ العربيّ القائمِ على توعيةِ الجماهير وتثقيفها وتحريرها من عُقَدِ الخوف ورهبة الحاكم هو الأساسُ في العمل التنويريّ، سواءٌ أكانَ السياسيُّ داعماً لهذا العملِ بقراره أم رافضاً لهُ بقَمْعِهِ ومُعْتَقلاتِه.
لقد كانَ التَّنويرُ عربيّاً، ولا يزالُ، في مِحَنٍ كثيرة، ولعلَّ من أسباب هذه المِحَن الأزماتِ الحادّةَ التي تعيشُها الثقافةُ، وعلاقة النّصّ الدينيّ بالفلسفة والعقل، بل إنّ مُحاولاتِ التوفيق بينهما بقيتْ شَكْلِيّةً، ولا يزالُ سُلْطانُ النّصِّ الدينيّ هو الأقوى، حتّى هذه اللحظة، مع العلمِ أنَّ النّصَّ الدينيَّ في أساسِه قائمٌ على الانفتاح والتنوير والديمقراطيّة كما في الحوار القُرآنيّ الراقي بين الخالقِ، سُبحانَهُ وتعالى، وبينَ إبليس، لكنَّ حاخاماتِ النُّصوصِ الدِّينيّة المُقدَّسة يَنْأَوْنَ بأنفُسِهمْ وفِكْرِهمْ عن هذه النُّصوصِ التنويريّةِ الحضاريّةِ، ويَسْتأثِرُونَ ببعضِ النُّصوصِ، مُحاوِلينَ لَيَّ أعناقِها لتكونَ نُصوصاً دَمَويّةً قاتلة، بعيداً عن مقاصدِ النّصِّ الدّينيِّ وتأويلاتِه الإنسانيّة والحضاريّة الراقية.
صحيحٌ أنَّ الفلسفةَ أخْفَقَتْ في اقتحامِ قلعةِ الدِّينِ في زمنِ التنوير العربيّ، وَفْقَ ما قالَهُ أحدُ الباحثينَ في ورقتِه المُقدَّمة، وأنَّ المُصلِحينَ والتَّنويريّينَ حُورِبُوا أو ظُلِمُوا، سواءٌ أكانوا أفراداً أم جماعاتٍ (ابن رشد، المعريّ، المُعتزلة، إخوان الصّفا، السّهرورديّ، الحلّاج، فرج فودة)، وغيرهم، لكنَّ هذا يجبُ أن يكونَ مُحرِّضاً لنا على مزيدٍ من الفعلِ التنويريِّ الحقيقيِّ المُتجاوزِ للاستيرادِ والتقليدِ على حَدٍّ سواء، والحريصِ على إخراجِ العقل العربيِّ من شقائِهِ ومن أزمتِه، وهو ما حَرَصَتْ عليهِ مُساهماتُ المُشارِكينَ في جلساتِ لقاء “الفِكْر التنويريّ في المجال العربيّ والتّحديّات الراهنة” المُنعقدِ في العاصمةِ الأردُنيّة عمّان مطلعَ تمّوز (٢٠٢٥).
بوابة الشرق الأوسط الجديدة