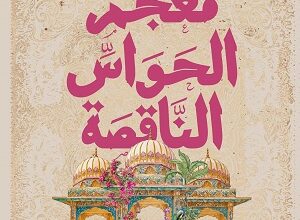مصر حكمها أبناؤها بفضل كتاب “الإسلام وأصول الحكم”

في عام 1925؛ نشر العالم الأزهري والقاضي، علي عبدالرازق، كتابه “الإسلام وأصول الحكم”، مع عنوان فرعي، هو: “بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام”، وهو مشروع نقد موجّه لوجود نظرية، أو تشريع، أو نظام خاص بالدولة في الإسلام.
أثار الكتاب الجدل والنقاشات، بل والمحاكمات، ولم يزل صداه يتردّد إلى اليوم، ولأنّ ذلك النمط من الكتب كثيراً ما يتم ذكره دون قراءته، سواء من قبل المؤيدين أو المعارضين، وهو ما يستدعي إعادة الاشتباك مع المضمون.
إنّ الخطوط العريضة لعمل عبدالرازق تتمثل في إنكاره للخلافة، ورفضه إضفاء القدسية عليها، باعتبارها مكوناً من مكونات عقيدة الإسلام، محاولاً البرهنة على كونها نتاجاً/ اختراعاً تاريخياً ودنيوياً خالصاً، وأنّ لا شأن لها بصحيح الدين، فلم تكن يوماً فرضاً إلهياً، ولا واجباً شرعياً. مقارِناً بين قيادة الرسول، صلى الله عليه وسلّم، وزعامة الملوك، ناقداً أدلة الفقهاء على الخلافة، وعلى وجود بناء واضح ومعتمد للدولة في الإسلام، فانتهى إلى التمييز بين الشريعة والسياسة، مُحدِداً وظيفة الأولى برعاية مصالح البشر الدينية، والثانية بجلب وحماية الأغراض والمصالح الدنيوية التي جعل الله الناس أحراراً في تدبيرها.
رسالة لا حكم
يجادل عبدالرازق بأنّه لا يوجد دليل واحد صريح، في الكتاب أو السنّة، يُقرّ بالخلافة، وأنّ مُشرّعيها اتخذوا سبيل القياس، فاستحدثوا مصدرين لسلطة الخليفة هما: سلطان الله تعالى؛ حيث الخليفة حامل الكافة/الناس على مقتضى النظر الشرعي. وسلطان الأمة؛ حيث يضمن منصبه “إظهار الشعائر الدينية، وصلاح الرعية”، وبالتالي اختلفوا حول ما إذا كان وجوب الخلافة عقلياً أم شرعياً؟ واختلفوا ومالوا أكثر إلى أحد دليلي الوجوب وهما: 1- إجماع الصحابة، رضي الله عنهم، والتابعين على تعيين خلفاء بعد وفاة النبي، صلى الله عليه وسلّم، ومبادرتهم لبيعة أبي بكر، رضي الله عنه، وأنه قد تمّ في كلّ عصر “تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبيّ، صلى الله عليه وسلّم، على امتناع خلو الوقت من إمام.
لقد كان القرآن الكريم صريحاً في أنّ حقّ النبي، عليه السلام، على أمته لم يكن “غير حقّ الرسالة”، إنّه يفصل بين مهام الأخيرة، ومهام الحكم؛ لأنّه يمنع النبي من حقّ إكراه الناس على الإيمان بصفته مُوكَلاً بضمان ذلك، أو مسؤولاً “حفيظاً” عنه؛ فهو ليس بحامل الناس على أن يتبعوا دعوته بالقوة، وبالطريقة التي يحمل بها الملوك دعواتهم على الناس، كعبيد عندهم أو ممتلكاً من ممتلكاتهم، فيما لم يستعبد النبي، صلى الله عليه وسلّم، أو يمتلك رقاب الناس، وذلك بنصّ القرآن الكريم نفسه، وبالتالي؛ فإنّ من لم يكن حفيظاً ولا مُسيطِراً ليس بملك، لأنّ من لوازم الملك السيطرة العامة والجبروت، وسلطاناً غير محدود. من ثمّ، فإنّ ادعاء سلطة سياسية للخليفة مستمدة من الرسول، عليه الصلاة السلام، وظيفتها حفظ الكليات الستّ؛ هو ادعاء باطل، حتى ولو ثبت عن الرسول، عليه الصلاة السلام، ممارسة أمور الحكم والسياسة، فإنّه قد مارسها لتوفير القاعدة الثابتة من الحرية والمساحة الملائمة لنشر الدعوة، فإذا ما توافرت تلك الشروط بشكل مُسبَق، لم تعد به حاجة إلى الحكم. إنّ كلّ عمل حكومي أو مظهر للملك والدولة في سيرة الرسول “لم يكن سوى وسيلة من الوسائل التي كان عليه أن يلجأ إليها لتثبيت الدين وتأييد الدعوة” في بداياتها، وفق تقاليد ذلك العصر الذي ظهر فيه الإسلام، وذلك لضمان ألا يزول.
ذلك ما كان للنبي، عليه الصلاة السلام، من زعامة، وحكم مشروط بصفته نبياً ورسولاً، وهي وظيفة لا شريك له فيها من الناس تتمثل في “رعاية الظاهر والباطن، وتدبير أمور الجسم والروح”، ويرتبط بخصوصية تلك الوظيفة ما أقرّه الإسلام من “عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات” كان على النبي إقرارها في قومه، والتي تظلّ “شرعاً دينياً خالصاً لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير، وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا، وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا، فذلك مما لا ينظر الشرع السماوي إليه”.
إنّ الحكم والقضاء ومراكز الدولة هي “خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها، ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى إحكام العقل، وتجارب الأمم. هكذا نقد عبدالرازق الدليل الثاني، فقد ترك الله للبشر إدارة شؤونهم الدنيوية والاجتماعية، وفق ما توصلوا إليه عبر التجربة، وما اكتسبوه من خبرة وحكمة أخلاقية تحفظ مقاصد الشريعة، دون أن تؤول من وسائلها القديمة ما يُعطّل المقاصد ذاتها.
أما إذا كانت إقامة شعائر الإسلام، وحفظ عقيدته، في حاجة إلى مؤسسة سياسية تحميهما، فإنّ التاريخ يبرهن على العكس، فعند ابن خلدون مثلاً؛ الخلافة المثالية التي يتحدث عنها الفقهاء، وكما يقدّرها ويبجلها ابن خلدون نفسه، قد انتهت منذ عصر هارون الرشيد وبعض أولاده، لتتحول بعد ذلك إلى مُلك بحت، كما هو في ملوك العجم بالمشرق، ليس فيه من حكم النبي شيء، وقد حدث ذلك دون أن يهز من دعائم الإسلام، وأنه لما كانت الخلافة تتداعى في بغداد، وأراضي المسلمين مقسمة إلى دول شبه مستقلة، أو مستقلة بالكامل عنها، فقد استمرت شعائر وأركان الدين رغم ذلك، فإن كان الدين نفسه ليس في حاجة إلى “تلك الأصنام” التي يدعونها خلفاء، كما أنّ الله تعالى “لا يريد لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة، ولا تحت رحمة الخلفاء”، وإنما نابع من أنفسهم، فكيف للشؤون الدنيوية التي هي محلّ تدبير وتنظيم عملي وواقعي، أن تكون في حاجة إلى الخلافة؟ لقد اكتمل الدين في حياة النبي، عليه والصلاة السلام، فإذا كان قد أنشأ دولة سياسية بالفعل، فما كان يمنعه من بيان أمرها بوضوح تحقيقاً لذلك الكمال، من دون أن يترك أمرها غامضاً ومبهماً، تاركاً أصحابه وأتباعه في حيرة، وتناحر، حتى قبل أن يتم دفنه؛ فيصلون لاحقاً إلى حدّ الصراع المسلح، وإذا حدث العكس، أي أنّ النبي، عليه الصلاة السلام، قد أقر نظاماً سياسياً واضح المعالم بالفعل، وذا حصانة مقدسة بقداسة الرسالة نفسها، فلماذا اختلف أوائل أصحابه وأتباعه في ذلك النظام الجلي الواضح؟
لقد بنى العرب دولتهم، بلا شكّ، على أساس وحدتهم الدينية، لكن الجدالات والصراعات التي أنجبت تلك الدولة، كانت بالأساس سياسية، كما أنّها احتكمت، في المقام الأول، إلى القوة والسيف، كما كانت تفعل حكومات كلّ الأمم في ذلك الوقت. لا ينكر عبدالرازق دور تلك الدولة في “تحول الإسلام وتطوره”، لكنّها ظلت في رأيه “دولة عربية، أيدت سلطان العرب، وروّجت مصالح العرب” كأمة ناهضة فاتحة، وقد أدرك رجال السقيفة تلك المصالح بوضوح، وقد دار جدالهم على من هو الأقدر على ضمانها، لقد كان جدالاً حول “حكومة مدنية دنيوية”، ونزاعاً في “ملوكية ملك، لا في قواعد دين، ولا في أصول إيمان، وبالتالي تواجدت المعارضة منذ اليوم الأول، وهو الدليل على أنّ المسلمين في تعاملهم مع الخلافة استحلوا “الخلاف لها، وهم يعلمون أنّهم إنما يختلفون في أمر من أمور الدنيا، لا من أمور الدين، وأنهم إنما يتنازعون في شأن سياسي، لا يمسّ دينهم، ولا يزعزع إيمانهم.
لم تكن القوة وحدها عامل الحسم في حالة أبي بكر، رضي الله عنه، بقدر ما كانت مكانته السامية كأقرب صحابة الرسول، عليه السلام، وسابقته في الإسلام، ما خلق حوله نوعاً من التوافق، غير التام، بل المُهدّد بالزوال في بعض الأحيان، حيث لم يُمتنع وجود تململ، ومعارضة عبرت عنها صراحة “الردة”، ففي رأي عبدالرازق: “نشأ لقب مرتدين لمرتدين حقيقيين عن الإسلام، ثم بقي لقباً لكلّ من حاربهم أبوبكر بعد ذلك، سواء كانوا خصوماً دينيين ومرتدين حقيقيين، أم كانوا خصوماً سياسيين غير مرتدين.