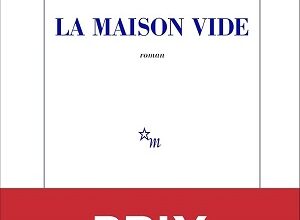نوافذ للحوار| لينا هويان الحسن: لستُ ابنة الحظ … والأدب شغوف بالأسرار النسائية

لينا هويان الحسن، هي ابنة الصحراء التي وجدت «بوصلتها» في عالم البداوة، فاختارت أن تحفر في ذاكرة المكان الصحراوي بأبعاده النفسية والعمرانية والاجتماعية، لتكون من أوائل الروائيات اللواتي اشتغلن على البادية السورية كتيمة أدبية. ولكن، بعد روايات عدّة تدور في المُناخ الصحراوي نفسه مثل «بنات نعش» و «سلطانات الرمل»، اختارت أخيراً أن تُغيّر اتجاهاتها لتنفتح على موضوعات من الحياة المدينية، من غير أن تبتعد عن التاريخ والتوثيق كأسلوب روائي، فكان لها «نازك خانم» (منشورات ضفاف، 2014) و «ألماس ونساء» (دار الآداب، 2014)، المرشحة لجائزة البوكر في دورتها الحالية. عن تجربتها الروائية وموقفها من الأحداث السورية وظروف الكتابة خارج حدود الوطن، إضافة إلى رأيها في الجوائز والروايات المنافسة، تحدثت الكاتبة السورية لينا هويان الحسن فكان هذا الحوار:
> بعد سبع روايات، أخيراً أنت في البوكر. هذا هو الترشيح الأول لك لجائزة بهذا المستوى. ما الذي يُميّز «ألماس ونساء» عن سائر أعمالك؟ هل هي أكثر نضجاً أم أكثر حظاً؟
– عندما كتبت رواياتي الأولى لم تكن هنالك جوائز، وتحديداً البوكر. فالجوائز التي تشجع أدب الشباب هي جوائز حديثة نسبياً. كتبتُ بعفوية، وأعتبر بعض نصوصي الأولى مجرّد تمارين على الأدب، تجارب صقلت قلمي، عندما كتبتُ فعلت في وقت مبكر جداً من عمري، كنتُ على مقاعد الدراسة الجامعية، كنت فقط أكتب. مع رواية بنات نعش (2005) بدأت أشعر بأنّ لي قرّاء ينفتحون على كتاباتي، ثم جاءت بعد ذلك روايتي الأثيرة إلى قلبي «سلطانات الرمل»، يومذاك رشحَتها الناشرة الراحلة إلهام عدوان (صاحبة دار ممدوح عدوان) بحماسة كبيرة إلى جائزة البوكر، لكنّ الرواية لم يكن لها نصيب في الفوز أو حتى الترشح. وبسبب تزامن صدور «نازك خانم» و «ألماس ونساء»، ضاع على نازك ترشيحها للجائزة. مثلما للجهد دور في كل شيء، فللحظ دوره أيضاً. لكنني قطعاً لست ابنة الحظ، هناك جهد سنين طويلة ومتراكمة لأعمال كثيرة صمدت بفضل متابعة القارئ لها.
> ترصد روايتك «ألماس ونساء» مسارات مختلفة لنساء سوريات في بلاد المهجر إبّان الحرب العالمية الأولى، فهل أردت توثيق موقف المرأة السورية في الأزمات الكبرى، لا سيّما أنها تعيش اليوم أشدّ الظروف ضراوة؟
– كانت فرجينيا وولف تقول: «في معظم الأحداث التاريخية كان المجهول، امرأة». وأنا حاولت إخراج هذا المجهول إلى الضوء. فـ «الذكور» استأثروا بكتابة التاريخ والأدب قروناً طويلة، ودائماً كتبوا عن المرأة وفق المنظور الذي تقتضيه الذكورة المتسلطة بذريعة الدين. من المهم والجميل أن نكتب نحن النساء تاريخنا، بعيداً من سلطة التقاليد، السلطة التي تؤججها السلطات السياسية وترعاها. اخترت المرأة التي غادرت بسبب اختلاف منظورها عن العالم وعن معنى وجودها، عن منظور غيرها من النساء اللواتي يعشن في ظرف اجتماعي وسياسي واحد. وهنا هي أنثى رافضة ومتمردة ومعترضة وغير خانعة بالمطلق.
> هل يُمكن القول أنّك اتكأت على التاريخ في كتابة «ألماس ونساء» للإضاءة على واقع ما زالت الكتابة عنه يشوبها شيء من التعثّر أو الغموض؟
– منذ البدايات الأولى للتاريخ، كان الأدب الوسيلة المفضلة لكتابة التاريخ، كالإلياذة والأوديسة وغلغامش. زمن الملاحم لم يكن إلا تاريخاً مكتوباً بلغة الشعر الروائي، أنامل التاريخ لم تكف يوماً عن تسوية ملامح المجتمع والجغرافيا. لا براءة للتاريخ إزاء حاضرنا. لو أردنا فهم الحاضر علينا أن نقرأ الماضي. من يتجاهل ماضيه فمحكوم عليه بإعادته، وبمرارة، وإلا كيف نقرأ هذه اللحظة الراهنة المكسورة ونضعها في سياقها التاريخي الصحيح؟!
> في روايتَي «نازك خانم» و «ألماس ونساء»، عام 2014، قدّمت نماذج لنساء متمردات، متحررات، هل تقصّدت ذلك في ظلّ تشدد فكري وعقائدي يُريد بنساء اليوم العودة إلى زمن القرون الوسطى؟
– قد أجيب عن هذا السؤال بمقاربة من الأجواء الصحراوية، فالغزلان في الصحراء تعيش ضمن قطعان صغيرة تكون في حدود الثلاثين غزالة، والقطيع تقوده أنثى نسميها في الصحراء «النجود»، وهذه النجود هي الغزالة التي تفرّ حالما تلمح الصياد، ليلحق بها من ثمّ القطيع كله. هذا ينطبق على المرأة التي تكتشف أنها مقيمة في ذاتها المحرومة من حريتها الشخصية في تفكيرها وتعبيرها وأسلوبها في الحياة، فتنفر إلى مكان آخر يحمي وجودها الشخصي، وهي تغدو مثالاً يحتذى به، وقد يسارع المجتمع إلى إدانتها، لكنّ الأدب يُعيد إلى المرأة دورها القيادي وهو يبقى السلاح الحقيقي والمضاد لكل أشكال السلطات.
> تميل معظم أعمالك إلى التوثيق والموروث الشفهي التقليدي، هل هذا الجانب هو نتيجة تربيتك الصحراوية البدوية؟
– الأدب إبداع وخلق. هو يُكتب عادة انطلاقاً من أحداث مختزنة في الذاكرة. هناك في البادية السورية منطقة جغرافية ووجدانية أملكها، لا يمكن أحداً أن يشاطرني إياها. هناك امتلكت بوصلتي التي تحدد لي الاتجاهات الصحيحة في الحياة. وعندما كتبت، انطلقت من هناك. من عالم ساحر مغيّب ومنسي ومغبون، هذه «محفّزات» حقيقية للكتابة.
> كنت من أوائل الروائيات اللواتي اشتغلن على كشف مفهوم البداوة بفلسفته وأهله وعمرانه، فلجأت في «سلطانات الرمل» و «بنات نعش» مثلاً إلى الحفر في ذاكرة المكان، ولكن في رواياتك الأخيرة ابتعدت من عوالم البدو متجهة صوب الحياة المدينية أكثر. لماذا؟
– ينفر الأدب من فكرة الاعتياد، لو استمرت كتاباتي في العوالم ذاتها لوقعت في فخ التكرار واجترار مواضيعي. عليّ أن أحمي نفسي من إغراء تقليد نفسي. ليس مريحاً أن أظل أسيرة التعريفات والتصنيفات، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أمتلك أيضاً «مخزوني» الحضري. الروائي عادة يرضخ لمغريات الحكاية. ما المانع من إحياء قصة جميلة؟ أذكر أنه خلال دراستي الجامعية كان لي صديقة دمشقية تحدثني دائماً عن جدتها التي تزوجت كونت فرنسياً من أصول لبنانية وغادرت معه إلى باريس. وصديقة أخرى تحمل اسماً هندياً غريباً، سمراء ببشرة غامقة لكنّ ملامحها آسرة، كانت تروي لي دائماً عن جدة والدتها الهندوسية. هكذا، في رواية «ألماس ونساء»، حضرت فعلاً ألماظ التي تزوجت الكونت اللبناني، وبابور الهندوسية التي حملت معها ماسة زرقاء تحرّك عجلة السرد في الرواية. الأدب شغوف بالأسرار النسائية، بخاصة حين تأخذ هذه الأسرار أبعاداً سياسية واجتماعية.
> ألا تفكرين في كتابة رواية تصوّر الأحداث السورية الراهنة بدلاً من اللجوء دوماً إلى التاريخ؟
– أؤمن مع سارتر أن «الكلمات أفعال»، أؤمن أن الأدب رسالة ومسؤولية، في أي مكان يمكن أن يوجد فيه. خرجتُ من سورية، وأنا أنوء تحت حمولة حزن كبيرة بسبب مقتل شقيقي على يد طرف من الأطراف المتقاتلة، أحتاج إلى مزيد من الزمن لأكتب نصّاً نظيفاً من التحيزات السياسية. فنحن في لحظة تاريخية يتحكم فيها الموت.
> ماذا بقي من البادية السورية في ظلّ كلّ هذا الدمار؟ وهل تشعرين بأنّ هويتك مهددة أمام امّحاء البادية بطبيعتها الخلابة وثقافتها الغنية؟
– لم أعتبر يوماً أن هويتي مرتبطة بمكان بعينه. هويتي هي نصوصي، ولحظتي الراهنة. ممنوع على الأديب أن يقع في فخ «الهويات القاتلة»، مهمة الأدب أن نصنع هوية جديدة. البداوة كطراز حياة اندثر تماماً. لا بداوة بعد الآن، كل ما هنالك تشوهات اجتماعية صنعتها الظروف السياسية، بحيث أصبحت البادية مأهولة بسكان يتبنون عادات هجينة تنوس بين أخلاق البدوي والفلاح. وانخرط معظمهم اليوم تحت رايات غريبة تقاتل وتساهم في «المحرقة» السورية العامة.
> هل قرأت الروايات المتنافسة في البوكر؟ أيها تستحق الفوز بالجائزة؟
– قرأتها كلها تقريباً. هي روايات تستحق القراءة والوقوف عندها، ومن الصعب المفاضلة في ما بينها. هناك مهمة صعبة أمام لجنة التحكيم عند اختيار الفائز.
> ما رأيك بالهجوم الذي شنّ على لجنة تحكيم بوكر هذا العام، بالتالي الروايات المرشحة للفوز؟
– اعتدنا ذلك سنوياً. وعلى رغم أن الجوائز الأدبية أصبحت متوافرة في شكل معقول في الساحة الأدبية العربية، إلا أنّ جائزة البوكر تحديداً تعني انتشاراً كبيراً. الجوائز ظاهرة صحية وعلى كل من يثق بالأدب والكتابة أن يشجعها، ولا ننسى صعوبة اتفاق كل الآراء والأذواق، على روايات بعينها، فالقارئ عندما يختار رواية ليقرأها فإنه يحكِّم ذائقته، والأذواق لا تُناقش.
> ما الذي يمكن أن تضفيه الجوائز إلى الكاتب؟
– ترسيخ حضور الكاتب، أيضاً إحساساً معنوياً يشجعه على مواصلة الكتابة، أضف إلى ذلك قيمتها المادية الضرورية على اعتبار أنها تساهم في شكل ما بتوفير الوقت اللازم للكتابة.
> تعيشين منذ مدّة في بيروت التي لمع فيها اسمك صحافياً وأدبياً، فهل أعطتك بيروت ما لم تعطك إيّاه دمشق؟ هل يمكن أن تغدو الكتابة أكثر سحراً حين يتعمّق الشعور بالغربة والفقد؟
– دمشق حرّكت قدري، حتى في أتعس الظروف، علمتني أن ثمة أملاً يستحق أن نعيش من أجله. كنتُ دائماً معجبة بهندسة هذه المدينة التي استثمرت أربع جهات لفتح سبع بوابات، فجأة شرعت كل تلك البوابات ليس لأدخلها، إنما لأغادرها لأسباب خارجة عن إرادتي.
أما بيروت فهي مدينة الضوء. كانت دائماً منبراً حقيقياً للتعددية. أتاحت أمامي مسافة تسمح لي برؤية أكثر وضوحا لماضيّ الشخصي، وحتى مشروعي الروائي، من دون أن تحرمني من مناخ الشجن اللازم لكتابة الأدب. وقد يكون قربها الجغرافي من دمشق خفف حدة الإحساس بالبعد والغربة. ها أنا جئتُ إلى بيروت ونسيت أن أغادرها.
صحيفة الحياة اللندنية