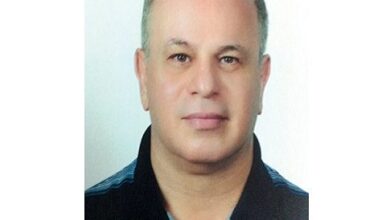تُعدّ منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدًا وتشابكًا على الصعيدين التاريخي والسياسي، إذ تتداخل فيها عوامل الجغرافيا والتاريخ والعقيدة والمصالح الدولية، ما يجعل أي محاولة لإيجاد حلول جذرية لمشكلاتها أمرًا محفوفًا بالعوائق. وتتوزع الإشكاليات الأساسية على ثلاثة محاور رئيسية: التركيبة السكانية الفسيفسائية المعقّدة للمجتمعات، الصراعات العقائدية الممتدة عبر التاريخ، وأطماع القوى الكبرى المستمرة في استغلال هذه المنطقة.
أولًا: التركيبة السكانية الفسيفسائية المعقدة
يتميّز الشرق الأوسط بتنوعه العرقي والديني والمذهبي، حيث يتعايش العرب والكرد والتركمان والفرس والأرمن، إلى جانب جماعات أصغر إثنيًا، في فسيفساء بشرية متعددة. وعلى الصعيد الديني، تضم المنطقة المسلمين بمذاهبهم المختلفة، والمسيحيين بطوائفهم، واليهود، إلى جانب جماعات دينية وتاريخية كاليزيديين والصابئة والدرزية.
هذا التنوع، الذي يمكن أن يكون مصدر ثراء حضاري، تحوّل عبر القرون إلى عامل توتر بسبب غياب نظم سياسية عادلة تضمن المساواة في الحقوق والواجبات. ومع غياب المؤسسات الجامعة التي تُعلي من قيمة المواطنة على حساب الانتماءات الضيقة، تحوّل الاختلاف إلى تنافس، ثم إلى نزاع مسلح في كثير من الحالات. وقد زادت هذه الانقسامات من هشاشة النسيج الاجتماعي، وجعلت أي مشروع للوحدة أو التعاون عرضة للانهيار عند أول خلاف.
ثانيًا: الصراعات العقائدية والتاريخ الممتد للنزاعات
تاريخ المنطقة مثقل بصراعات دينية ومذهبية تعود جذورها إلى قرون طويلة. فالأحداث الكبرى، من الفتوحات والحروب الصليبية إلى الصراع العثماني – الصفوي، تركت رواسب عميقة في الوعي الجمعي للشعوب. هذه الرواسب لم تذُب مع الزمن، بل غالبًا ما تُستحضر في الأزمات المعاصرة كجزء من خطاب التحشيد السياسي أو الطائفي.
الصراعات العقائدية ليست محصورة في الدين وحده، بل تشمل أيضًا أيديولوجيات قومية وحداثية واشتراكية وإسلامية سياسية، تنافست جميعها على قيادة المجتمعات. هذا التنازع جعل بناء توافق سياسي شامل مهمة شبه مستحيلة، إذ إن كل تيار يرى في الحل منطلقًا من رؤيته الخاصة، لا من صيغة وسطية تعترف بالآخر.
وتكمن خطورة هذا العامل في أنه يولّد “ذاكرة صراع” تنتقل بين الأجيال، فتظل النزاعات مستمرة حتى بعد تغيّر الظروف السياسية والاقتصادية.
ثالثًا: الأطماع الجيوسياسية للقوى الكبرى
منذ العصور القديمة، شكّل الشرق الأوسط نقطة جذب للإمبراطوريات بسبب موقعه الاستراتيجي الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ووفرة موارده الطبيعية، وخاصة النفط والغاز. القوى الاستعمارية، من العثمانيين إلى البريطانيين والفرنسيين، وصولًا إلى النفوذ الأمريكي والروسي المعاصر، تعاملت مع المنطقة باعتبارها ساحة نفوذ ومصدر ثروات.
هذا التدخل الخارجي لم يكن مجرد استغلال اقتصادي، بل تَمثّل أيضًا في رسم حدود دول لم تراعِ الواقع الديمغرافي، وإقامة أنظمة موالية، وإشعال صراعات بالوكالة لتأمين النفوذ. النتيجة أن معظم النزاعات في الشرق الأوسط لا تُدار فقط بين أطراف محلية، بل تُغذّى وتُوجَّه من قوى خارجية تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الاستقرار الداخلي.
نعود إلى تداخل العوامل وتعقيد الحلول فمن الصعب فصل هذه العوامل الثلاثة عن بعضها، فهي مترابطة وتغذّي بعضها البعض. فالتركيبة الفسيفسائية تجعل المجتمعات هشّة أمام أي توتر، والصراعات العقائدية تضاعف احتمالات الانقسام، بينما تتدخل القوى الخارجية لاستثمار هذه الانقسامات لصالح أجنداتها.
وبسبب هذا التشابك، تبدو محاولات الحل الجذري بعيدة المنال. حتى المبادرات الإقليمية أو الدولية التي طرحت على مدى العقود الماضية اصطدمت بواقع معقّد يجعل من “السلام الشامل” هدفًا مؤجلًا أو مثاليًا أكثر منه خطة واقعية.
اما بخصوص عوائق التنمية والاستقرار فالنتيجة المباشرة لهذا الوضع هي بيئة سياسية واقتصادية غير مستقرة، تمنع تحقيق التنمية المستدامة. فالنزاعات المسلحة تستنزف الموارد، وتؤدي إلى موجات نزوح وهجرة، وتعرقل الاستثمار، وتضعف المؤسسات. كما أن استمرار الصراع يولّد دوائر متكررة من الفقر والبطالة، ما يغذّي التطرف ويعيد إنتاج العنف.
هذه الحلقة المفرغة تجعل المنطقة دائمًا في حالة “إدارة أزمة” بدلًا من “حل أزمة”، ما يحرم شعوبها من فرص بناء مستقبل مزدهر.
والسؤال الذي دائما يتبادر إلى الذهن ،هل من أفق للحل؟
رغم قتامة المشهد، يمكن القول إن تجاوز هذه المعضلة ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب شروطًا صعبة التحقق، منها:
- بناء نظم سياسية جامعة تعزز مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، وتُخرج الهوية الوطنية من أسر الهويات الفرعية.
- معالجة إرث الصراعات التاريخية من خلال مصالحة حقيقية، تشمل إصلاح المناهج التعليمية والخطاب الإعلامي لتشجيع ثقافة التسامح.
- تحييد التدخلات الخارجية عبر بناء تكتلات إقليمية قوية قادرة على التفاوض من موقع الندية مع القوى الكبرى.
- إطلاق مشاريع تنموية مشتركة تقلل من دوافع الصراع على الموارد، وتخلق مصالح اقتصادية متبادلة بين الدول والمجتمعات.
والاستنتاج الذي يراد الوصول اليه في هذا المقال من إن الإشكال العميق في إيجاد حلول لمشاكل الشرق الأوسط ليس وليد عامل واحد، بل هو نتيجة تفاعل معقد بين تركيبة سكانية شديدة التنوع، وصراعات عقائدية ضاربة الجذور، وأطماع خارجية متجددة.
هذه العوامل تتشابك لتنتج واقعًا دائم الاضطراب، يقف عائقًا أمام أي مسار للتنمية والتطور والسلام.
ورغم أن الطريق نحو الحل يبدو طويلًا، فإن الاعتراف بهذه المعضلة المركبة وفهم أبعادها بدقة هو الخطوة الأولى نحو كسر دائرة الأزمات التي حكمت هذه المنطقة لقرون.
فالتاريخ يثبت أن الشعوب التي واجهت تعقيداتها بشجاعة وواقعية على مدى التاريخ استطاعت، ولو بعد زمن طويل، أن تبني نظمًا أكثر استقرارًا وعدلًا مع التمنيات ان يسمح لنا المستقبل بعيش هذا الحلم .
بوابة الشرق الأوسط الجديدة