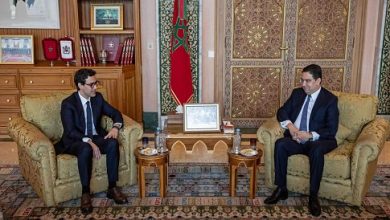جمال الغيطاني يكتب ملامح من سيرته

يستعصي نصّ جمال الغيطاني «حكايات هائمة» على التصنيف وفق الأنواع الأدبية المتعارف عليها، وهو إن كان اعتاد التجريب كما في ثلاثيته «التجليات» أو سباعيته «دفاتر التدوين»، إلا أنه فارق في نصه الجديد المحطات التي كان حطَّ فيها رحاله عبر أعماله السابقة، من روايات وقصص وتأملات وسير ودراسات ومشاهدات.
في «حكايات هائمة» نحن أمام مزيج من الإبداع الخالص والتناص الظاهر، بل الاقتطاف الكامل الذي يأخذ عن الآخرين بعض أقوالهم ويضعها كما هي أو بتصرف، موزعة على فلسفات ورؤى وأساطير وحكايات متعددة، آتية من الشرق والغرب، من عند الأقدمين والمحدثين والمعاصرين، عرباً وعجماً، أوروبيين وآسيويين، مما هو تحت أقدامنا وما وراء الحجب.
ولم يفت الكاتب نفسه أن يخط معالم التعامل مع نصه، بحيث يقول في مستهله: «هذه حكايات هائمة في الذاكرة، بعضها ربما تكون له أصول في الواقع، إلا أنه يصعب تحديدها، وبعضها توهم محض. المصادر المذكورة لا أصول لها، ربما فُقدت إلى الأبد، وربما لا توجد إلا في مخيلتي».
وهنا يتفاوت عطاء الغيطاني بين ما تنتجه قريحته الساردة، وما يختاره من حصيلة قراءاته المتنوعة، وهي مسألة يدل عليها النص ذاته حين خصص كاتبه جزءاً بعنوان «حكايات الكتب»، توالت فيه عناوين من قبيل: «كتاب الكتب»، و»كتب ما لم يكتب»، و»كتاب الحدائق»، و»كتاب الخاص»، و»ما لم يرد في كتب»، و»كتب الوصول»، و»كتب وافدة»، و»كتاب البحر»، و»مجنون الكتب» و»كتاب الوجود»…، ليستعرض بعض ما يقرأه الآن، وهو ما يدل عليه قوله: «بعد تقاعده لزم مكتبته التي أمضى عمره في تكوينها، يرجع الأمر إلى سنوات النشأة الأولى، عندما بدأ يكتشف روعة القراءة، وإطلاقها المخيال».
تتفاوت اللغة بين القديمة في تراكيبها ومفرداتها وتصويرها للذات والمجتمع والكون، وبين معاصرة تتبسط فصاحتها إلى حد السائد والمتداول في الحياة اليومية أو تتعقد لتصبح بعيدة من متناول عموم الناس، مقصورة على أفهام الخاصة. لكنها في الحالتين لا تفقد جماليتها، وتحتاج إلى مقدار من التأمل والتبصر في سبيل فك شفراتها، والوقوف على ما وراء ظاهر النص.
وهذه الطريقة سار عليها الغيطاني منذ روايته «الزيني بركات»، التي رأت النور قبل خمسة وثلاثين عاماً، فبعدها تكرّر الأمر في أعمال مثل «التحاف الزمان بحكاية جلبي السلطان»، و»رسالة البصائر في المصائر» وغيرهما، بحيث فُتن الغيطاني بلغة الحكي القديمة، لاسيما تلك التي انطوى عليها كتاب ابن إياس الحنفي المصري «بدائع الزهور في وقائع الدهور». وهو تأثر به إلى حد عميق، ثم فتن بالنص الصوفي الذي سيطر عليه منذ روايته «شطح المدينة». لكنّ الغيطاني أديب يعيش في زماننا، ولم يكن بوسعه أن يهمل ما تمنحه إياه تجربته من قصص وروايات، فصوَّر شخصيات وحكايات من زماننا، وبلغته وطريقته في التفكير والتعبير، ومن وحي تجاربه في الطفولة والصبا والكهولة.
يجسد نص «حكايات هائمة»، الذي يتقلب راويه بين ضميري «الأنا» و»الغائب»، هذا التنوع والتوزع بين القديم والجديد، فيأتي القديم من أحاديث منسوبة إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وقراءات تطل فيه وجوه الصوفي الكبير «ذو النون المصري» الذي توفي 245 هـ، وأخرى لـ «لاو تساو» صاحب «الطاوية» وأشعار للمتنبي وعروة بن الورد، وأقوال الفرعوني تحوتي والجاحظ والإمام الشافعي وابن عطاء الله السكندري ونظريات الاصطخري في الطير والدينوري في النبات وعظات وحكم صينية وهندية قديمة… إضافة إلى استدعاء حالات صوفية عاشها غيره. ويأتي الجديد متمثلاً في نثار من روائع الأدب العالمي والفلسفات المعاصرة، وتفسير سيغموند فرويد للأحلام وأشعار الأبنودي وخبرات الطفولة وحصاد الترحال.
لكنّ الجديد لا يقف عند حد الاستعانة والاستعارة، ولا التناص والاقتطاف، إنما يتجلى أساساً في أمرين: الأول هو هضم القديم ثم إخراجه في شكل جديد، يتماهى مع النص في عمومه، أو يضيف إليه ويشـــرحه ويعمـــقه بمرور الصفحات والوقفات، والثاني هو النبش في الذاكرة لاستدعاء خبرات الطفولة والشباب، وتأمّل ما يجري أمام عينيّ كاتب بلغ السبعين من عمره، في حلّه وترحاله.
وقد يختلط القديم بالجديد كما في «حكايات مراكشية»، حين يستفيد الغيطاني من اهتمامه بعمارة الزمن الوسيط وآثاره، كما يختلط الواقعي عندما يتحدث الكاتب عن رحلاته وقراءته بالعجائبي حين يتحدث عن الطير والشجر.
ويصل ذروته في تلك المقطوعة التي عنونها بـ «خبر» حين يقول: «جاء في الجزء المفقود من كتاب النبات للدينوري، أنه يوجد شجر في جزر الخالدات، إذا ضاجعه الإنسان يتأوه، ويغنج وينزل، ثم يحمل ويلد. أما من وصلوا إلى عمق ديار الهند، فقطعوا بوجود شجر إذا قطع ثمره المستدير، والذي يشبه رأس البشر، ينبت محله على الفور، وفي أقصى بلاد ما وراء النهر شجر إذا ذبلت واحدة منها ينكس سائر النوع أغصانه وفروعه لمدة أربعين يوماً حتى لو وجد في الطرف الآخر من المعمورة». تبدو «حكايات هائمة» من زاوية أخرى أشبه بأدب السيرة، التي لم يشأ الغيطاني أن يكتبها بطريقة مباشرة، إنما أراد أن يعرض لنا طرفاً من تجربته الحياتية وتأملاته وقراءاته وانحيازاته في الحياة، ويطرح لنا بعض الأقوال والحكم والمأثورات التي أحبها، أو تلك التي تتماشى مع ما يريد أن يقوله أو يكتبه أو يضعه لافتة تعبّر عنه، أو يوافق ويجاري خط السرد أو هدف النص الذي أنتجه.
وكل هذا لا ينفصل عن ذات الكاتب بل ينبع منه، ويدل عليه، ويشير إليه، ويتجاوز الحدود التي تمارسها ثقافة الأديب وتجربته والسياق الذي يحيط به على إبداعه الروائي والقصصي، لتصل في جوانب كثيرة منها إلى تعبير مباشر عن الكاتب نفسه، من البداية وحتى النهاية، وعما أدهشه وأمتعه في الدنيا التي عاشها. فقسَّم كتابه على الطير والشجر والكتب والسفر وعالمَي الغيب والشهادة. ومن الأجنحة والأغصان والصفحات والرحلات والتهويمات تطل معالم حياته، منذ أن تفتَّح وعيه على الدنيا وحتى اللحظة التي يفارقها.
فالغيطاني لا ينهي نصه من دون أن يطرح تساؤلات يبدأها: «هل من هناك عندما أمضي إلى هناك؟ هل من جهة أسلكها عندما يبدأ تفرقي عني أم أهيم إلى كل صوب؟ هل من مستقر أم سأتبع كل نسمة، وتحملني كل ريح، وتنقلني كل موجة إلى حيث لا أدري»، وهنا يستعين بآيتين قرآنيتين هما: «وحنانا من لدنا»، «ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت». وكأنه أراد هنا أن يؤكد أن الموت فقط هو الذي سيحول بينه وبين أن يطرح أسئلته ويبوح بمكنون نفسه، رغم أنه في كل الأحوال لن يستطيع أن يفي بكل ما يريد، أو يجيب عن التساؤلات التي تستعر في رأسه من البداية وإلى النهاية وهو ما يعبر عنه حين يقول: «ليس لي إلا طرح الأسئلة، وما دام النطق قد وقع فربما يجيء حين لا ألم به الآن، ولا أعلم عنه شيئاً، يتحقق باعث التوق، رغم أن كافة ما قدرت على البوح به ظل وسيظل معلقاً».
صحيفة السفير اللبنانية