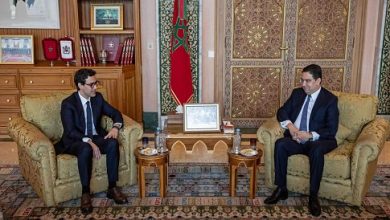حصاد الثقافة 2012 (1)
حرب داحس والغبراء سيطرت على المشهد في سوريا وظهرت مصطلحات جديدة. وبين مثقفي الداخل والخارج، تصدّعت الاتحادات وبرزت «انشقاقات» وسادت لغة التخوين وطالت شظاياها شعراء وكتّاباً كانوا حتى الأمس القريب في مرتبة الأيقونات. وبينما عاشت بيروت عاماً آخر عادياً، تصدّرت مصر الواجهة: محاصرة الإبداع وقمع حرية التعبير وتهميش المثقف قابلتها ثورة جديدة لوقف سيطرة الإسلاميين على مفاصل الحياة، فيما انتقلت عدوى القمع بين دول الخليج، واستُبعدت الخنساء من مهرجان «عكاظ» واستُبدلت بعنترة بن شداد، وسارت الموسيقى البديلة بخطى واثقة في الأردن رغم انطفاء مشاريع كان يعوَّل عليها كثيراً.
عام الانقسامات الحادة: بيروت لم تعد كما هي
حسين بن حمزة
كانت الظروف الأمنية تقضم أجزاءً كبيرة من السنة الثقافية. لكن حين غابت هذه الأسباب أخيراً، لم تعد بيروت إلى ما كانت عليه. كأنّ المدينة اعتادت على تلك الأسباب، وصارت تستجيب لها في غيابها أيضاً. لا يمكن أن نكون في بحبوحة ثقافية. الأوضاع ليست متفجرة، لكنّ الانقسامات تلعب دوراً مماثلاً في ضرب ضرب الثقافة وتيئيس العاملين فيها.
ولا ننسى «الربيع العربي» وارتداداته على لبنان. القصد أنّنا بتنا محكومين بسنة ثقافية عادية. لا تزال المواعيد تملأ أيام السنة، لكن باستثناء بعض الفعاليات المضيئة، وقعت معظم المواعيد وقعت بين المتوسط والعادي كما هي حال بيروت المتوسطة والعادية في هذه الفترة.
كما في العام الماضي، أُقيمت النشاطات في مواعيدها، وكان آخرها النسخة الـ20 من «معرض الكتاب الفرنكوفوني» والنسخة 56 من «معرض بيروت للكتاب»، وحفلات زياد الرحباني في ضبية والأونيسكو، ومسرحية «مقتل إن وأخواتها» لريمون جبارة. عودة أحد معلمي المسرح اللبناني ترافقت مع تقديم نص «الدكتاتور» لمجايله الراحل عصام محفوظ بإخراج لينا أبيض.
هكذا، بدا المسرح أفضل حالاً من العام الماضي رغم التراجع العام، وغياب التمويل الذي يؤمن برمجة سنوية قوية. أُغلق «مسرح بيروت»، وكان مهدداً بالهدم لولا تدخل وزارة الثقافة لحمايته، بينما تابعنا عروضاً قليلة ومتفاوتة الجودة، فاستقبل «مسرح بابل» عرض «سنديانة» للتونسية زهيرة بن عمار، و«ميديا» لكارول عبود. في «مسرح مونو»، شاهدنا «الأربعا بنص الجمعة» لبتي توتل، وقدم منذر بعلبكي «حركة العين السريعة» في «أشكال ألوان»، وعرضت فرقة «زقاق» مسرحية «مشرح وطني»، بينما قدم التونسي وحيد عجمي «يا ما كان» في «مسرح دوار الشمس» الذي شهد عروضاً أخرى ضمن مهرجان «منصة». في «مسرح المدينة»، شاهدنا «أسباب لتكوني جميلة» لنادين لبكي، بينما استضافت المسارح ذاتها عروض «ملتقى الرقص المعاصر» الذي نظمته جمعية «مقامات». ولا ننسى العروض المغايرة التي قدمها «مترو المدينة» بقيادة هشام جابر، إلى جانب فوز ربيع مروة بـ «جائزة الأمير كلاوس».
في السياق نفسه، أُقيمت مهرجانات بعلبك وبيت الدين وبيبلوس في موعدها، بينما شهدت عروض أخرى سجالات حادة على خلفية حملات المقاطعة لفنانين وفرق أجنبية سبق أن زارت إسرائيل، وهو ما أجبر المغنية لارا فابيان على إلغاء حفلاتها، بينما حضرت فرقة «ريد هوت تشيلي بيبرز». في السينما. أُقيم «مهرجان بيروت السينمائي الدولي» في موعده، وكذلك «مهرجان السينما الأوروبية»، وأثار فيلم My My Last Valentine In beirut سجالاً رقابياً، وتعرض فيلم «تنورة ماكسي» لجو بو عيد لهجوم أكليروسي، وعُرض فيلما «الحوض الخامس» لسيمون الهبر، و«تاكسي البلد» لدانيال جوزيف. ونال فيلم «الهجوم» لزياد دويري جائزة «مهرجان مراكش».
في النشر، صدر «طوق العمامة» لوضاح شرارة، و«حرير وحديد» لفواز طرابلسي، و«الانهيار المديد» لحازم صاغية، وصدرت رواية «لا طريق إلى الجنة» لحسن داوود، و«ساعة التخلي» لعباس بيضون، بينما فازت رواية «دروز بلغراد» لربيع جابر بجائزة «بوكر» العربية، ودخل أمين معلوف إلى الأكاديمية الفرنسية. في الشعر، قرأنا ديوانين في كتاب واحد لوديع سعادة، و«ظل الوردة» لحسن عبد الله، و«برهان الخائف» لمنغانا الحاج، و«معطف علق حياتك عليه» لسوزان عليوان، وشهد العام إطلاق مجلة «بدايات» التي يرأس تحريرها فواز طرابلسي.
في الفن التشكيلي، نذكر المعرض الاستعادي لشفيق عبود، ومعرضي حسين ماضي، وريم الجندي، إضافةً لحضور رسامين سوريين، ومنهم: بهرام حاجو، وعبد الكريم مجدل بيك، وقيس سلمان.
أخيراً، لا يكتمل حصاد السنة الحالية من دون ذكر وداعنا للصحافي غسان تويني، والمعماري عاصم سلام.
مثقفون في رحى الحرب الأهلية
خليل صويلح
«تأجّلَ ولم يُلغَ» هي العبارة الأكثر تداولاً في خريطة الثقافة السورية في هذا العام الملتهب. تأجيل وليس إلغاء، هذا ما كان يصرّح به مسؤولو المهرجانات. لكن في النهاية، لن نذهب إلى مكان. في موازاة الحرب التي تدور في المدن، خاض المثقفون حروباً طاحنة عنوانها الإقصاء والتخوين تبعاً لمواقفهم المتباينة من «الربيع السوري». ستتمزّق المؤسسات الثقافية بين الداخل والخارج باستعارة مفردة عسكرية طارئة هي «الانشقاق»: «رابطة الكتّاب السوريين» في مواجهة «اتحاد الكتّاب العرب»، والأمر عينه للتشكيليين والفنانين.
بيانات، وبيانات مضادة، وما بينهما اتهامات ناريّة طالت قامات ثقافية كانت حتى الأمس أيقونات مقدّسة. ليس أدونيس المثال الوحيد. هناك عشرات المثقفين ممن أصابتهم سهام الرّدة بطعنات متفاوتة. حالما يطأ مثقف حدود بلاد أخرى، يدلي بالبيان رقم واحد، داعياً إلى مناصرة انقلابه «العظيم» وإلا سيضع الآخرين في خندق الأعداء بتهمة التواطؤ مع نظام الاستبداد (!). في المقابل، هناك من استغلّ الفوضى الخلّاقة في الداخل لتحقيق مكاسب شخصية بإقامة مهرجانات وهميّة لا يحضرها أحد. شخصية العام بلا منازع، هي رياض عصمت، وزير الثقافة السابق الذي حجز موسم المسرح القومي باسمه، عبر 5 عروض حملت توقيعه كمؤلف ودراماتورغ. ثم التفت إلى «الهيئة العامة السورية للكتاب»، وأهداها سبعة كتب من مؤلفاته قبل أن يفقد منصبه.
من جهته، تعرّض «اتحاد الكتاب العرب» لهزّات متتالية، أبرزها انسحاب ثلاثة أعضاء من مكتبه التنفيذي، احتجاجاً على ممارسات رئيسه حسين جمعة، وتجاهله مقتل اثنين من أعضائه، هما: محمد رشيد الرويلي وإبراهيم خريط، بعدما اعتقلتهما الأجهزة في دير الزور. لكن مهلاً، ألم يصدر الاتحاد قراراً شجاعاً بفصل رفعت الأسد من عضويته؟ في المقابل، لم تسلم «رابطة الكتاب السوريين» أول مولود «ديموقراطي»، انتخبت المفكر صادق جلال العظم رئيساً لها، من الاتهامات والانسحابات، احتجاجاً على استحواذ بعض أعضائها على توجهات الرابطة وغموض تمويلها.
هكذا استبدل المثقفون خواء المشهد على الأرض بفضاء افتراضي وجدوا فيه ملاذاً للتعبير عن مواقفهم، وإذا بنا حيال مدوّنة ضخمة للسجال والعراك والمبارزة. عدا حفنة أسماء نقدية جادة، أفرزتها الانتفاضة، سنجد نصوصاً ركيكة وظلامية وطائفية، تسعى لاحتلال الواجهة بأي ثمن. من ضفةٍ أخرى، كرّمت محافل دولية أسماءً سورية أسهمت في الحراك، فحصدت سمر يزبك جائزة «هارولد بنتر» مناصفة مع الشاعرة كارول آن دافي، عن كتابها «تقاطع نيران»، ونال ياسين الحاج صالح جائزة «الأمير كلاوس»، وذهبت جائزة «مؤسسة ابن رشد» إلى رزان زيتونة، فيما فاز رسام الكاريكاتور علي فرزات بجائزة «جبران تويني». في مقابل تكريم هؤلاء، قام «مهرجان القاهرة السينمائي»، وتلاه «دبي» بمعاقبة 3 مخرجين سوريين بمنع عرض أفلامهم، هم: عبد اللطيف عبد الحميد (العاشق)، وجود سعيد (صديقي الأخير)، وباسل الخطيب (مريم) بذريعة أنّ هذه الأفلام أنتجتها جهة رسمية سورية هي «المؤسسة العامة للسينما». احتضار المشهد الثقافي تجسّد أيضاً في مهنة النشر. أغلقت معظم المطابع لعدم توفّر الورق، وبسبب وجود بعضها في المناطق الساخنة، ما أدى إلى انحسار عدد العناوين المطبوعة. إنه عام الخسارات بامتياز، أقله، لجهة الأضرار المدمّرة التي لحقت بالمواقع الأثرية وسرقة الآثار من قلعة الحصن وقلعة المضيق إلى إيبلا، وحلب القديمة، بما يذكّر بالسيناريو العراقي بعد الاحتلال الأميركي لبغداد.
محاصرة الإبداع وتهميش المثقف
سيد محمود
في بلد شهد ثورة تعاني من مدّ وجزر وتتراوح مواقف مثقفيها بين الحماسة والإحباط، من الطبيعي أن تطغى السياسة على الثقافة. الركود كان سمة المؤسسات الثقافية المصرية التي لم تشهد تغييراً جوهرياً في المنظومة الحاكمة لها، بل على العكس. لم تؤدّ التغييرات في قمة وزارة الثقافة وهيئاتها الرئيسية إلا الى تكريس خطاب الإحباط والتوجس.
المؤسسات التي تكوّنت في الستينيات لا تزال مصرة على احتكار عمليات إنتاج الثقافة أكثر من رعايتها، كما لا تزال تعاني ارتباكاً نظراً إلى تعرّضها لضغوط من طرفين: الأول تمثّله السلطة الحاكمة الجديدة التي جاءت مع تمكن قوى الاسلام السياسي من أجهزة الدولة الإيديولوجية، والثاني تمثّله الجماعة الثقافية التي ترى في نفسها ممثلة لخطاب الثورة القائم على التنوير والوعي. وزاد من صعوبة الأمر طغيان خطاب الاستقطاب السياسي الى جانب حالة رعب دفعت المبدعين إلى رفع شعار الشاعر صلاح عبد الصبور: «رعباً أكبر من ذلك سيجيء»، في إشارة الى توقّعات بأن يؤدي حكم الإخوان الى محاصرة حرية الفكر والتعبير. وهي نبوءة تقيس على مواقف سابقة لنواب الإخوان خلال عهد مبارك كانت تسعى الى تقييد حرية الفكر والتعبير، كما تستند الى حالات شهدها العام الذي تميز بحصار فرضته قوى الإسلام السياسي على منابر إعلامية ومثقفين بسبب موقفهم من حكم الرئيس محمد مرسي والإخوان. ويتغذى خطاب المثقفين المتوجسين بمسار تجربة إيران بعد ثورة 1979 التي أدت الى تهميش المثقفين والمبدعين بل الى هجرة بعضهم. وفي قلب هذه الصورة، ثمة علامات يمكن القول إنّها رسمت مسار الثقافة المصرية، إذ تمت عملية الانتهاء من كتابة دستور وإمراره رغم أنف المؤسسات الثقافية الاهلية والرسمية. في المقابل، لم تؤدّ عملية تهميش المثقف ومحاصرة حرية الإبداع إلا إلى دفعه مجدداً إلى الشارع والانخراط في الثورة والمطالبة بنصوص في الدستور تحمي حرية الفكر والابداع.
ومثلت وزارة الثقافة لغزاً للعديد من المثقفين. من ناحية، اكتفى وزيرها صابر عرب بأداء الأدوار البيروقراطية وتجنّب الخوض في نقاش معمق بشأن تعديلات تشريعات ثقافية جديدة. وقد كان محلاً لانتقادات حين قدم استقالة صورية من منصبه في الأيام الأخيرة لحكومة كمال الجنزوري ليضمن الفوز بـ«جائزة الدولة التقديرية». لكن اللافت أنّ غالبية جوائز الدولة نالها مثقفون ظلوا أصحاب خطاب يناهض الدولة الدينية مثل وحيد حامد، وعمار علي حسن، وحسن طلب، وعبد الهادي الوشاحي، وأحمد النجار. وتجلت قوة مواقع التواصل الاجتماعي التي قدمت دعماً للفضاءات المستقلة. وشهد العام رحيل عدد من القامات أبرزها الكاتبان إبراهيم أصلان ومحمد البساطي.
وبالمثل خسرت مصر أسماءً كان رهانها تعميق خطاب المواطنة، وأبرزها ميلاد حنا. ولم ينته العام الا بخسارة قامة ثقافية بارزة من جيل الخمسينيات هو عبد الغفار مكاوي أول من عرّف المثقفين المصريين إلى الشعر الحديث بكتابه الرائد «ثورة الشعر الحديث».
الحفاوة تليق بفلسطين
رشا حلوة
منذ بدايته، بدا 2012 كأنّ يحتفي بالكتّاب والأدب الفلسطينيين، أكان على مستوى النشر، أم على مستوى «احتفالية فلسطين للأدب» التي أقيمت للمرة الأولى في غزة بحضور كتاب فلسطينيين وعرب. بداية، شهد العام إطلاق سلسلة «راية عربية» (دار راية) في حيفا لصاحبها الشاعر بشير شلش. هذا المشروع المهم يعدّ «نافذة فلسطين إلى العالم العربي» عبر إصدار أعمال لسعدي يوسف ونوري الجراح وغيرهما من الكتّاب العرب في فلسطين.
في النشر أيضاً، أصدرت «دار الفيل» (القدس) التي أسسها الشاعر الزميل نجوان درويش رواية «رام الله الشقراء» للزميل عبّاد يحيى. وفي خانة الإصدارات، يضاف «كارلا بروني عشيقتي السرية» للكاتب والصحافي علاء حليحل (كتب قديتا). ولعلّ الحدث الأهم ضمن الاحتفاء بالكتاب هو «احتفالية فلسطين للأدب» (بالفِسْت) التي أقيمت للمرة الأولى في غزة، وكانت بمثابة كسر الحصار المفروض على القطاع منذ 2007. منذ اليوم الأول للاحتفالية، وصلت إلى غزة مجموعة من الأدباء والشعراء الفلسطينيين والعرب. إلا أن المفاجأة المؤسفة حدثت في اليوم الاختتامي للمهرجان حين أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «حماس» على اقتحام «قصر الباشا» وفضّت الاحتفالية.
بالإضافة إلى «احتفالية فلسطين للأدب»، امتاز موسم الصيف بالمهرجانات الموسيقية، خصوصاً في الضفة والقدس المحتلة من خلال ثلاثة مهرجانات هي: «مهرجان فلسطين الدولي»، ومهرجان «وين عَ رام الله» و«مهرجان القدس». لم يطرأ أي تغيير على بنية المهرجانات، فهي لا زالت تخصص منصاتها للموسيقى والرقص أحياناً واستقبلت فنانين شباباً عرباً كالمصرية مريم صالح. وتوالت هذا العام نجاحات حملات المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل، إذ أُفشل فيلم «24 ساعة في القدس» التطبيعي. وكان القائمون على المشروع («آرتي» الفرنسية الألمانية) يريدون إحضار مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين للعمل على شريط يحكي «قصة القدس» من المنظور الاجتماعي. وكان يُفترض أن يقام بالتعاون مع شركة إنتاج إسرائيلية مدعومة من «صندوق القدس للتلفزيون والسينما» التابع لبلدية القدس والمخصص لتهويد البلدة، ومع شركة فلسطينية هي «كتاب للإنتاج» عملت على إخفاء وجود شريك إسرائيلي عن المخرجين الفلسطينيين الذين تواصلت معهم. إلا أنّ انكشاف الأمر أوقف العمل على الفيلم، فعدسة الكاميرا في القدس لا ترى سوى بندقية المُحتَل.
صحيفة الأخبار اللبنانية