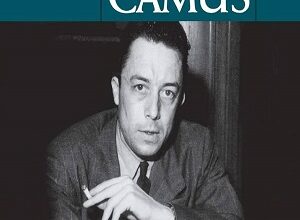نزار عبد الستار: لعبة الأمم على الشعوب الضعيفة

في روايته «الأدميرال لا يحب الشاي» (دار الساقي)، يتابع الروائي نزار عبد الستار مشروعه الروائي الذي بدأه في «ليلة الملاك»، حيث يعتمد على استراتيجية المداخلة بين التاريخ والحاضر وتفكيك العلاقات المتشابكة بينهما. يعمد إلى اختيار فضاءات تاريخية وشخصيات لها أثر في هذا التاريخ، بحيث يمكن إسقاطها على الواقع المَعيش.
وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية، يتخذ الكاتب العراقي من تاريخ «شركة الهند الشرقية» أرضيةً أو مناخاً إن صح التعبير لروايته «الأدميرال لا يحب الشاي»، لكنه أراد أن يوضح من خلال هذا التاريخ، لعبة الأمم على الشعوب الضعيفة واستغلالها. إنها ببساطة «رواية معنية بالسنوات الأخيرة لـ«شركة الهند الشرقية» البريطانية، وتسلط الضوء على ما قبل الثورة الهندية» على حد تعبير صاحب «الأميركان في بيتي».
ولا أعتقد أن الرواية تريد أن تقصّ لنا حكاية عزيز لانكستر آل السفان ذي الأصول العربية التي تمتد إلى البصرة، لكنه كان الذريعة التي اتخذها الكاتب ليتحدث عن حكايات البلاد من الصين إلى الهند، وصولاً إلى البصرة، حيث ستتصارع الدول وتتواطأ لفرض سيطرتها عبر «شركة الهند الشرقية من خلال جسر وحيد هو دماء وأرواح الشعوب».
«شركة الهند الشرقية» التي أصبحت في ما بعد «شركة الهند الشرقية البريطانية»، تأسّست عام 1600 كشركة تجارية مع جيش ضخم ودعم من الحكومة البريطانية، ونهبت شبه القارة الهندية منذ عام 1757 حتى استلزمت الفوضى أن تتدخل الحكومة وتستولي على ممتلكات الشركة عام 1858. كانت «شركة الهند الشرقية» هي الوسيلة التي نفّذت بها بريطانيا سياساتها الإمبريالية في آسيا، وحقّقت الملايين من خلال تجارتها العالمية في التوابل والشاي والأفيون، وقد تعرّضت لانتقادات كثيرة بسبب فسادها وقد جرفت «شركة الهند الشرقية» الحكام الذين وقفوا في طريقها، واختلست الموارد بلا هوادة، وقمعت الممارسات الثقافية للشعوب التي تعيش داخل أراضيها الشاسعة. ببساطة، كانت الشركة رأس الحربة الحادة للإمبراطورية البريطانية، وقد اكتسب مديروها ثروات هائلة، وأصبحت الهند أكثر فقراً. إنّ «شركة الهند الشرقية» أكثر بكثير من مجرد شركة تجارية، لقد كانت دولة داخل دولة، وقد تمتّعت بالحق الحصري في التجارة مع الهند. على الرغم من أنه لم تكن لها السيادة على مناطق عملياتها، إلا أنه سُمح لها بممارسة السيادة باسم التاج الإنكليزي والحكومة.
لانكستر أو الأدميرال كما يُلقب في الرواية، الذي يعلن أصوله العربية عند الحاجة ويتخلى عنها عندما يقتضي الأمر، هو الباب الذي يفتحه الروائي ليدخل عوالم «شركة الهند الشرقية» وأساليبها للسيطرة على موارد العالم التي لا تختلف عما يجري اليوم، وإن بأسماء مختلفة. محور الرواية في الظاهر، هو الأدميرال الذي يقضي عقوبة النفي في مقر «شركة الهند الشرقية» المهجور في البصرة. وعندما حُملت إليه الصناديق بحسب العائدية، استغل الأدميرال حرباً دموية ليجعل من الشاي المشروب المفضّل في البصرة، متحدياً في ذلك هولندا التي كانت تحتكر تجارة القهوة مع البصريين.
يعتمد صاحب «يوليانا» على خاصية التبئير، فهو يوجه تلسكوبه السردي إلى شخصية الأدميرال لانكستر وممارساته. هو من أكثر أبطال «شركة الهند الشرقية» شهرةً، وهو المسؤول عن زراعة الأفيون في مستعمرة الهند البريطانية، وله تاريخ دموي في تجارة المخدرات مع الصين، لكن تم نفيه إلى البصرة بعد استيلائه على سفينة محمّلة بالفضة. في البصرة يستغل الأدميرال خبرته في القرصنة، ومفاهيمه العنيفة واللاأخلاقية والدموية بهدف إجبار المدينة على حبّ الشاي.
وعبر التبئير الداخلي، يكشف عن الشخصية التي توجه منظور السرد من نظرها. يبدو الراوي كسارد كأنه عليم ببواطن الشخصيات، معتمداً على ضمير الغائب الذي يمكّنه من تمرير وجهات نظره من دون أن يكون تدخّله فجاً، وهو كذلك وسيلة يتوارى خلفها السارد ويجنّبه الوقوع في فخ الأنا الذي يؤدي إلى ما يُسمّى سوء الفهم السردي، والأمر المهم هنا أنه يفصل زمن الحكاية عن زمن الحكي على الأقل ظاهرياً، ما يدفع السرد إلى الأمام من دون عثرات واضحة انطلاقاً من الماضي. تبدأ الرواية من الحاضر مع جلوس الأدميرال على الشرفة بعد نفيه إلى البصرة في مقر «شركة الهند الشرقية». ثم يعود بنا الكاتب إلى الخلف إلى تاريخ الشركة وتاريخ الأدميرال الملوّث بالدماء عبر تقنية الخطف خلفاً، مع تدوير زوايا الرؤية التي يبقى الأدميرال وحياته وخططه لجعل الشاي المشروب الأول في البصرة البؤرة الأساسية للسرد.. هذه الطريقة في السرد وباستخدام ضمير الغائب، تحمي السارد من إثم الكذب، فهو مجرد راوٍ، وللقارئ الحرية في التصديق من عدمه. ويكون بذلك السرد الذي من أجله كانت الحكاية. «وهو الذي من يجعل السرد رواية والرواية سرداً» بحسب الباحث عبد الملك مرتاض.
يستخدم عبد الستار إطاراً تاريخياً لسرد راهن مَعيش، لأنه أدرك بذكاء الراوي، أن الرواية ترتبط ارتباطاً جدلياً بالتاريخ، فهي أقرب الفنون إليه، وكلاهما يقوم على السرد والاهتمام بالأحداث والشخصيات، فإذا كان التاريخ رواية الماضي، فالرواية بلا شك هي رواية الحاضر.
وهنا يمكن القول بالتأكيد بأنّ صاحب «ترتر» لم يكتب رواية تاريخية، بل حاول أن يخلق حياة موازية كما يؤكد دوماً، وهنا يمكننا أن نعتبر أن الرواية هي مصدر غير تقليدي للتاريخ، إذ يقول في أحد حواراته: «لقد أردت شد الانتباه إلى تحكّم الشركات الكبرى بمصير العالم، وهذا موضوع أراه يشكل مأساة البشرية. إنّها رواية عن فن التجارة، وكيف أن العالم الذي نعيش فيه صُنع بطرق ملتوية ومخاوفنا الحالية هي نفسها التي كانت موجودة قبل أكثر من قرنين».
في «الأدميرال لا يحب الشاي»، تغلغل الراوي في طيات المجتمع، وخبايا النفوس، واستطاع الحديث عن المسكوت عنه في الخطاب الثقافي والسياسي والاجتماعي العام، بدءاً من العنوان الذي لا يهتدي القارئ إلى دلالته إلا بعد أن يقطع شوطاً عظيماً في قراءة الرواية فيقف على الأسرار المختبئة في زوايا السرد، ويكتشف أن العنوان كان مدخلاً إلى عمارة النص الروائي وإضاءة بارعة لممراته المتشابكة، وأن العلاقة بينه وبين النص هي علاقة جدلية تتمثل في تفاعل النص معه عبر الانسجام تارة، والتغريض الدلالي طوراً.
ذهب عبد الستار بعيداً في التاريخ المنسيّ إلى تفاصيل ينساها التاريخ. ينشغل بتدوين الأحداث الكبيرة والأسماء العظيمة، وينسى تداعيات تلك الأحداث على الأرض والبشر. حاول تدوين حياة الشخصيات المرمية على هامش الحياة والتاريخ، وهو في ذلك يؤكد ما قاله كارلوس فونتين: «أعتقد أنّ الرواية تمثل تعويضاً للتاريخ، إنها تقول ما يمتنع التاريخ عن قوله»، وترك لنا فرصة البحث والتقصي بالمتعة ذاتها التي تركتها قراءة الرواية بأسلوبها الشيّق وسلاسة لغتها.