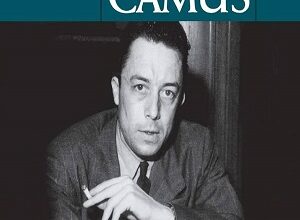بوهيميا اللغة وديستوبيا البقاء| رواية “الدّيزل” لثاني السويدي

أختفي.. عبر اللغة السحرية وأُدخل فضاء رواية “الديزل” لثاني السويدي، حيث يأتي التشكيل المكثف أعلى من المألوف، وتنفرج دلالات سابحة في عبثها الأبديّ، مزج سحريّ بين رماد الأساطير وتحولات الأرض والتمرّد على القناعات القديمة.
ورغم أنه العمل التجريبي الأول والوحيد، لبناء نص سردي طويل، إلى أنه تجاوز الأطر التقليدية المتعارف عليها في بناء الرواية والسلوك البوهيمي للفكرة واللغة، إنها أشبه بالبرق الخاطف، الرواية الومضة، الومضة المغامرة الأطول من القصة القصيرة، والأقصر من الرواية، والتي تنتمي من حيث التوصيف الأدبي إلى “النوفيلا”، رغم أن ثاني السويدي لم يضع لها تصنيفاً، وحتى الآن هي عبارة عن نص سردي متدفق بالمجاز والرمز.
أما الفضاء المتراقص ما بين سرابها وواقعها فهو فضاء ديستيوبيّ تعلوه غيمة تتحسس نبضات الوجود الراهن ما بين فرص تقبّل التحوّل أو الإذعان إلى التوحّش وخيبات الواقع التي ألقتْ بظلالها على بطل الرواية.
والجدير بالذكر أن ثاني السويدي أصدر الرواية عام 1994 إلا أن هناك شعورا استباقيا بالحاضر الذي يعيش فيه الإنسان تحت وطأة تفاقم أنانية الفرد وثقافة المال والاستهلاك والانجراف نحو الأزمنة السائلة ومُستنبت اللايقين.
حيث المرحلة التي ينطبق عليها توصيف زيجمونت باومان بقوله “معاً.. لكن فُرادى”.
يشكل انتقال البلدة من “الصّلابة = وحدة القرية = تكاتف القبيلة ” إلى “السيولة = تفكك المدينة = اغتراب الأفراد”، هي المرحلة المفصلية في تاريخ الأرض، تتحلل فيها القيم وتنصهر بسرعة تفوق الزمن اللازم لتشكّلها. كل ذلك يصيغه السويدي في روايته بلغة لمّاحة شعرية مُكثفة، وممهورة بالموروث الحكائي الشعبي، لكن ليس باجتراره وتكراره، وإنما بإعادة إنتاج حكاية سحرية مصطبغة برائحة القديمة، تخفف من وقع السوداوية التي تبسطها الديستوبيا.
و أدب “الديستوبيا”، يجيء نقيضاً لـ”اليوتوبيا”، التي هي نوع يعبّر عن حلم المدينة الفاضلة الذي كان قد تمناه وتخيله الفيلسوف اليوناني أفلاطون، وعلى العكس من ذلك جاءت “الديستوبيا”، التي تعبر عن هواجس المدينة المُظلِمة التائهة في طفرة التحولات والتكنولوجيا المهددة بزوال القيم الإنسانية.
ولعل أكثر ما أغرى الأدباء في كتابة الديستوبيا، أنها شديدة التعبير عن واقع الأزمات التي يعيشها البشر في القرن العشرين، ولأنها أيضاً مثلت طريقاً للحالمين بالتغيير. وأظن أن ثاني السويدي كتب بعفوية مستنداً إلى كينونته وتكوينه الثقافي وظروف المجتمع ومتغيراته، أما المصطلحات والمفاهيم فهي من اجتهادات النقاد والقُرّاء.
أجواء الرواية
الرواية تنبني على حوار كامل في ليلة واحدة، تنعقد خيوط السرد عبر حوار وُلِد ليكون عقيماً، ضمير متكلّم واحد يتدفق من لسان الرّاوي العليم، صبيّ مدعو بـ”ديزل”، وهنا يمكرُ الكاتب بالقارئ ويطمس اسم البطل فلا يكاد يظهر أو يبين إلا في منتصف الرواية، عند بلوغ البطل مرحلة الانتباه والتقصّي والفضول بالجسد والافتتان بالصوت الشجيّ العذب الذي يملأ الأصقاع وعالم البحار بالغناء الوجودي الذي لا شبيه له.
“ديزل” هنا اسم صبي يسرد مراحل نموه، بلوغه، بلوغ الخطر، ونموّ البلدة في وجه الشمس الجديدة والتحوّل من الطين إلى الإسمنت، ومن لغة الماء إلى لغة الدّيزل “كانت بلدتنا بسيطة، وما زالت حتى الآن يتخمّرُ فيها أملُ الشواطئ حين يرى بيوت الفقراء تفنى، هذه البلدة، مثل لسانك يا صاحبي، كل بيوتها وجدرانها تشهد أن أُذني تسلّقت جدار الصّمت خلف البيوت، عرفتْ أسرارها من ثقوبها الحقيقية، ونرجسية الكهرباء الجديدة” (ص 15).
الثنائية الضدّية
أذان/أغنية..
صوت/صمت
ثنائية ضدية مثيرة للجدل يوظفها ثاني السويدي في روايته، ورغم جرأة هذه الضدية إلا أنها ممهدة للقارئ بالرّمز الذي خفف بدوره ظُلم المتلقي.
فحين يصل الصبيّ ديزل إلى مراحل البلوغ، ترتفع من حنجرته ألحانٌ الأبد والعدم في هذا الكون المتداعي الأركان، ألحان الجهات الأربع، أو ألحان بلا جهات لأوتارها، صوتٌ من زمن مردة الجن والسّحرة والينابيع وخيوط الفجر الأول، يملأ الوجود سحراً وجاذبية، فيهيمن على الأرض بسحر صوته، تخضع له البلدة بولاتها ورؤسائها، ثم يخضع له الوجود بأسره. لكن دوام الحال من المحال، تأتي الإشارات في الحُلم مذكرة اقتراب موعد العجز، ليُصاب بعدها ديزل بعجز وشلل تام يذكّره بأنه مجرد إنسان في هذا الكون، مجبول على الضعف والوهن والفناء. ورغم الشلل، يبقى الصوتُ مرغوباً بين الأنام ومحبوباً في الأصقاع، لتعود الروح إلى الحُنجرة السماوية، ويظل غناء ديزل يتردد في الأكوان محبة ونوراً وخضوعاً وجاذبية.
صوتٌ موحد ومكثّف وخاطف، يأتي بارزاً بضمير المتكلم، يقابله ضمير أبكم، يفيض الحوار الوجودي من طرف واحد، يقابله صمت مُطبق دائم السكون، إلا من ضحكة واحدة هازئة عبّر الرّاوي عنها بنقطة من الفراغ الهائل، كلسعة تهكمية مؤلمة إبان نقاش وجداني جاد، برز ذلك الحوار عبر (الحديث مع الجار) كصوت موحّد يسهب في الحكي لكنه إسهاب خاطف ومكثّف وشعري طارد لفكرة الملل، بدا الحوار أشبه بالمناجاة أو رسالة جوانيّة تخاطرية، وكأن الصبي “ديزل” في حالة مونولوج متدفق وسابح بين الأزمنة، فتارة يستبق الزمن، وتارة يتخذ من الاسترجاع أداة للتدفق بين مسارات الرواية. ينكشف لنا في النهاية أن الشخص المستمع الذي يُكلّمه ديزل – هو صبي آخر يجاوره الجلوس في ركن قصيّ في المسجد وهو “أبكم “. والبُكم هنا قد يكون مجازياً، يحتمل رمزاً دلالياً وإسقاطاً رمزياً للخرس الذي أصيبت به البلدة في طور تزاوجها بالحداثة السائلة. وما يحملنا إلى التأويل الرمزي هي صيغة الأذان التي يأمر بها البطل جاره الأبكم، “آه لو تعرف يا صديقي من أنا؟ أعرفُ جيداً أنني أتعبتُ أُذنيك هذه الليلة كثيراً، لم يعد باستطاعتي الحديث، هيّا هيّا يا صديقي الأبكم.. قد اقترب الفجرُ قُم، قُمْ وأذّن!” (ص 60).
لقد كانت صيغة أذان الأبكم صمتاً مدوّياً في الفراغ الهائل بالخيبات والتوجّس الذي ختم به ثاني السويدي روايته، إنه صمت ديستوبي ملأ مسرح النهاية بالصحاري القاحلة والرماد والأشباح والأرواح الطليقة، فما معنى أن يأتي الأذان من المسجد بصيغة الصمت اللانهائي؟
الزمان والمكان
الزمان سقف الرواية، بينما المكان هو الأرضية التي تتحرك عليها الأحداث والشخوص، وهما أهم عناصر البناء الروائي، لكن ماذا لو غُيبا وفق رسم تلاعبي ذكيّ فلسفيّ تأخذ فيه اللغة الرمزية أهمية بالغة في الدلالة على وجودهما كعنصرين ثانويين؟
يبدو الزمان في رواية الديزل حُلميّاً مُغبّشاً ومتشظياً، كذلك يبدو المكان، فلا يمكننا تحديد زمن الحدث فلكياً ومكانه الجغرافي تحديداً دقيقاً، وإنما عن طريق بعض المفردات نتمكن من الاستطالة أكثر في التخمينات للوصول إلى زمن العتبة، عتبة تحوّل الجزيرة العربية وساحل الخليج العربي في أولى محاولات بروز حقول النفط والغاز، وهناك مفردات دالة بشكل مركّز على مدلولها البيئي (بيئة رأس الخيمة القديمة جداً)، ولكن دونما تحديد زمني مفصليّ. من ضمن هذه المفردات الدالة على المكان المؤسس للزمن (البرقع/عمامات بيضاء/خناجر/حكايات سحرة يطيرون على الجبال/أصوات الرجال على الجبال كعواء الذئاب” دلالة على الندبة عند قبائل رؤوس جبال الحجر). لكن سرعان ما يتلاشى هذا التخمين حين يبرز لنا رسم آخر مؤلف من رموز زمنية دالة على حِقبة ما قبل الإسلام، حيث زمن الآلهة والأساطير الموروثة وطقوس تقديسها في شبه الجزيرة العربية “حين تقدّمتُ نحوهم قاموا ووضعوا نِعالهم فوق رؤوسهم، وظلوا يرقصون تحية لي، مُعتقدين أن الآلهة تمشي فوقهم وتلبَسُ نعالهم، وعليهم أن يرقصوا بها تحية لي” ( ص 52).
هذا ما يؤكد لنا أن ثاني السويدي لم يرغب بتحديد الزمان وإنما بتعزيز فكرة فلسفية قائمة على تشظيه وتناثره وحدوث الأحداث المترامية كلها داخل بوتقة زمنية واحدة هي “الحلم”. بدليل أن كل الأشياء تندمج لتتداعى بعيداً ثم تتوالى بعدها أحداث أخرى وأخرى، فتبدو لنا المشاهد بعين الكاميرا كفلاشات سينمائية سريعة وامضة وسحرية.
إن عنصر الفضاء الزمني في الرواية مسكون بموضوعات زمنية من شأنها أن حرّكت المكان ومنحته بُعداً أصيلاً وجذورياً ومُستقبلياً، فرواية الديزل زمنية بامتياز، وستقرأ على مدى تعاقب الأجيال. ومن هذه الموضوعات الزمنية التي شكّلت بؤراً مركزية داخل الرواية: الخطيئة، الرحيل، الفقد، التحوّل، قصص الجن، السّحر، الخرافات والأساطير، الموت الذي هو مبتدأ الحياة، القماط الذي هو الكفن ذاته ومنتهى الحدث، الديزل بما فيه من حمولات الزمن والتحوّل إلى المعاصرة… وغيرها.
كما أن استثمار الأفكار الفلسفية وجرأة الأسئلة الوجودية وصياغتها شعرياً دفّق من سحر النص ومنحه بُعداً متحدّياً ومتحركاً بين الأزمنة، “هؤلاء البشر مُحنّطون، يعرفون البحر والسماء والمسجد، لكنهم لم يسألوا أنفسهم يوماً لماذا يغرقون؟ لماذا لم يتعوّدون العيش تحت الماء.. وتتعوّد الأسماك العيش في البر؟ لماذا هذا التقييد والحصار الإلهي؟ لماذا أعطى الرّب الجزء الأكبر من الأرض للأسماك. ولماذا يفوقُ عددهم البشر؟ قد يظن الناس أن هذه إرادة إلهية هدفها أن يأكلوا فقط” (ص 27).
ونجد ذلك الحس الفلسفي في العناد والتساؤل، يحتويه حاضن شعري آمِن، في قوله، “هذه الشمس التي ما زالت، ومنذ الأزل، تبكي ضوءًا، ونحن نرى ونتدفأ ببُكائها، مُعتقدين أنها ضاحكة، مُبتسمة، تنام كما ننام، ولا أحد يتساءل: أيٌّ منا ينام قبلاً، نحن أم الشمس؟” (ص 52).
الأيقونات في الرواية
- البحر: رمز للتحوّل وعدم الاستقرار، رمز للحركة والتجدد والديمومة المتقلّبة، وحضور البحر في الرواية يأخذ طابعاً ذكورياً متحكماً بمصير البلدة وأرزاقها ونسائها، فتارة تستأنس به البلدة، وتارة تأنف جبروته الهائل، وهو مصدر للهرب إلى البعيد في اللامتناهي من العالم، لذا في مشهد حسي سوريالي نجد إحدى نساء الرواية وهي أخت البطل، تختار البحر زوجاً لها وتنجبُ منه الأبناء لتطلق عليهم اسم “الخطايا الملونة”، وتعطي لكل سمكة اسماً من أسماء البر، وهذا بلا شك توظيف لخرافة شعبية دارجة في دول الخليج، وتعبير رمزي يحيل إلى بحث إناث البلدة عن مصدر للهروب من الأعراف الضيقة، وإن كان هذا المصدر هو مركز لمدارات شاسعة من الضياع والخوف والاضطراب، إلا أنه الوحيد الذي يملك حق الأسماء، “البحرُ، آه هذا البحر، كم وددتُ أن أركب هذا الجمل المائي، أتموّج فوق سنامه نحو رحلةٍ لا أعرفُ إن كان شيءٌ من جلد أختي باقياً بعد أن سرقه المِلح وهي تبحثُ عن زوجٍ بحريّ” (ص 28).
- المرأة: المرأة في الرواية هي واحدة، ومتعددة، ومتحوّلة إلى أدوار مختلفة.
- المرأة الأخت التي تزوجتْ البحر (ص 12).
- امرأة الظلام التي جلست بين الشيخ وبين الصبي ديزل (ص 24).
- جُثة الأم وعباءتها تحت شجرة السّدر (ص 25).
- امرأة الماء، امرأة واحدة وصامتة على وجهها البرقع تظهر مع قبيلة من الرجال في جزيرة غامضة، وتحمل في يديها جرّة الماء، تنظر إلى ديزل وتجتاز مراحل البصر في داخله (ص 37).
ويبقى الجوهر دالاً على أنثى واحدة متمركزة في الذاكرة الوجدانية عند الكاتب ثاني السويدي، وكأنه أراد أن يعيدنا إلى فكرة عززتها فلسفات دينية في الهند التي تصوّر الذكاء والوضوح جزءً من العقل الذكوريّ، أما الاستيعاب والسكون فهما جزء من العقل الأنثوي، فالمرأة وحدها تستطيع أن تستوعب وتحتوي، ولهذا تصبح حاملاً، إنها تمتلك الرّحم.
كذلك في الأساطير القديمة وأسفار العهد القديم منذ فجر السلالات في جزيرة العرب وحضارات وادي الرافدين، نجد الأسطورة البابلية “الإينوما إيليش” تُصوِّرُ على نحو دقيق ما حصل من انقلاب على الآلهة الأم. ففي الأصل كان الوجود أنثى، وكانت الأشياء في جوهرها أمومية، ولكن بعد تحولات الأرض وحِراكها صار النظام الكونيّ أبويّاً.
فالأنثى الأم في الأساطير العتيقة وبعض ديانات الشرق القديم وشرق آسيا مثّلت السكون والهدوء الذي يشبه طبيعة الأرحام والطبيعة البكر، حيث الإذعان والتقبّل وبقاء الأشياء في الفوضى الأولى من الخلق، ولكنها فوضى منظمة وهادئة وساكنة. وهنا يُسقط ثاني السويدي هذه الرمزية على الاستقرار والتقبّل على المرأة، الواحدة المتعددة في كل مجالات الحياة والرواية.
بينما الذكورة الأبوية في تلك المعتقدات قد مثّلت النشاط والحركة المتجددة والثورات، رغبة التغيير والتحكم والتّحول والانجراف نحو المستقبل، نحو المدينة والحضارات. وهنا يُسقط ثاني السويدي هذه الرمزية على البحر.. وعلى المتغيرات القادمة نحو البلدة الصغيرة الوديعة.
- العناكب: تحضر العناكب بصورة رمزية كابوسية بين حين وآخر وتنسج خيوطها بين مفاصل البيوت في البلدة كدلالة واضحة على الوهن الاجتماعي، فنجدها على الأغلب تزحف على جدران البلدة وتغتال الفتيات قويات الإرادة اللواتي يفكرن خارج الصندوق ويحاولن الاقتراب من البحر.. من حدود البلدة. حتى اختلطت أرواح البشر بأرواح العناكب، ثم بدأت العناكب تغيّر وجهتها، وتلتهم الخثاق الذي يمثل قوت الأسرة الواحدة في البلدة. وهنا ينقلب أصل الوهن الاجتماعي المتعارف عليه طبيعياً داخل بيت العنكبوت وبين فصائلها “تبدأ الأنثى ببناء البيت كعامل جذب تستقطب به الذكر، وبعد أن تتم مرحلة التزاوج، تقوم الأنثى بقتل الذكر وأكله”. فبيت العنكبوت واهن اجتماعياً وقائم على أساس الاغتيال بين الزوجين والأبناء، ولا روابط للرحمة فيه. وهذا إسقاط نفسي عنيف على تأثير العولمة والحداثة السائلة على المجتمعات القروية المتلاحمة.
و قد يأخذنا تأويل نسيج العناكب بنسيج الزمن وتحديات القَدَر والدوائر الوجودية والتماثلية، وقد يرمز إلى الفخاخ في العالم وإلى هشاشة البشر وسهولة وقوعهم في الفخ، كما يرمز أيضاً إلى مكر الأشرار وخبثهم. ونسج العنكبوت في عالم الفلك هو قمريّ، حيث يصوّر دائرة الحياة والموت والعالم الظاهر وعجلة الوجود، باعتبارها الرحلة الخطرة التي تجوب متاهات النفس البشرية.
- ديزل: اسم بطل الرواية، يحمل المدلول الرمزي الأكبر والمركز المحوري الذي تدور حول نطاقه مجريات التحوّل، بدءًا بالتحول الشخصي داخل أنسجة خلايا البطل الصبي الذي يستشعر القلق الفكري والاحتراق الداخلي وتمور طفرة أمومية أنثوية بداخله تعيده إلى أصل الأشياء والتساؤل حول أصل الكون. وينطبق ذلك تماماً على وقود الديزل الذي في صميمه عبارة عن تحوّل ناتج عن الاحتراق الداخلي، فينتج خليط من عدة عناصر متجانسة وغير متجانسة لتوليد الطاقة الحركية وهذا ما يحدث للأرض، من تمدّن وتدخل الإنسان في مجريات الطبيعة وتحويل الخام إلى صناعة استهلاكية تدرّ بالأموال الطائلة.
- خيمياء الصوت: يصير للصبيّ ديزل صوت خيميائي يسحر به كل الأقاليم والبلدان والمدن البعيدة، وتخضع له شموس جديدة، وتنفتح له بيوت المحافظين والأثرياء، ويركض وراءه حشد كبير، رَتْلٌ منهم يحاول لمس يديه ليبارك له كل ما فيه حتى خطيئته، ويصبح ديزل ملك البلدان، يُفرحها ويُبكيها.
وهنا إحالة إلى اللجوء والتهافت البشري إلى الحلول العولمية، صوت ديزل الحسن والشجيّ في الرواية يملأ العالم، موازياً لصوت الاقتصاد والصناعات والثراء الشكليّ وإلى كل ما يخرجهم من فقرهم المدقع ويخدّر مشاعرهم ويؤمن لهم سهولة العيش، ويمنحهم حقاً في الراحة من مفاجآت الطبيعة، ولو بمحاربتها وإخضاعها قسراً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدّيزل رواية لثاني السويدي، صدرت عام 1994 من دار عيون الملايين في بيروت. وأعيد إصدارها في عام 2011 عن دار الجديد، بيروت. وفي 2012 قام ويليام هوتكنز بترجمتها إلى الإنجليزية.