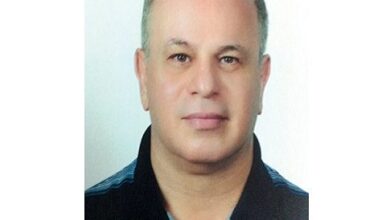الفسيفساء العرقي والديني في بلاد الشام: الأسباب التاريخية والواقعية في التباين والتعايش بينها ..
ماهر عصام المملوك

تُعدّ بلاد الشام واحدة من أكثر المناطق تنوعًا في العالم من حيث الأعراق والأديان، إذ كانت عبر التاريخ نقطة التقاء الحضارات، ومسرحًا لتحولات سياسية وديموغرافية عميقة. رغم هذا التنوع، فإنّ الفسيفساء العرقية والدينية في هذه المنطقة لم تكن متجانسة بشكل كامل، بل شهدت تفاوتات وتوترات تاريخية أثّرت على طبيعة التفاعل بين المجموعات المختلفة. تتجذر أسباب هذا التباين في عوامل تاريخية، سياسية، اقتصادية، وديموغرافية، بعضها قديم يعود لآلاف السنين، وبعضها حديث نتج عن الاستعمار والتغيرات الجيوسياسية الحديثة.
وفي عجالة سريعة سنستعرض الأسباب الحقيقية وراء عدم تجانس الفسيفساء العرقية والدينية في بلاد الشام، متناولين العوامل التاريخية والواقعية بشكل هادئ وتاريخي وتذكيري سريع والتي ساهمت في تشكيل هذه الظاهرة.
فالجذور التاريخية لعدم التجانس العرقي والديني في بلاد الشام يعود إلى أقدم العصور، والتي شكّلت بلاد الشام بموقعيها الخاص منطقة عبور بين الحضارات الكبرى مثل الحضارة المصرية، وبلاد ما بين النهرين، والأناضول، والبحر الأبيض المتوسط. وأدى موقعها الجغرافي إلى دخول موجات متعددة من الشعوب، مثل الأكاديين، الكنعانيين، الآراميين، الفرس، الإغريق، الرومان، العرب، والأتراك، مما خلق تنوعًا عرقيًا واسعًا.
كما شكلت الفتوحات والهجرات الكبرى عاملًا رئيسيًا في تشكيل التركيبة السكانية لبلاد الشام. فعلى سبيل المثال:
- الفتح الإسلامي (القرن السابع الميلادي): أدى إلى دخول العرب المسلمين إلى المنطقة، مما غيّر التوازن الديموغرافي لصالح العرب المسلمين تدريجيًا، لكن دون القضاء التام على الأقليات الأخرى مثل المسيحيين واليهود.
- الحملات الصليبية (القرن الحادي عشر والثاني عشر): جلبت موجات جديدة من الأوروبيين، وأسهمت في صراعات طويلة الأمد بين المسلمين والمسيحيين، مما زاد من الانقسامات الطائفية.
- الاجتياحات المغولية والتيمورية: تسببت في دمار واسع وتهجير العديد من السكان الأصليين، ما أدى إلى تغييرات في توزيع الأقليات العرقية والدينية.
- الهجرة التركية في العهد العثماني: عزز العثمانيون الوجود التركي في بلاد الشام، خاصة في المدن الكبرى، ما أضاف عنصرًا جديدًا إلى التشكيلة العرقية.
كما من الضرورة بمكان ان نشير إلى الكم من الإمبراطوريات التي تعاقبت على بلاد الشام مثل الإمبراطورية الرومانية، البيزنطية، الإسلامية، والمملوكية، والعثمانية. هذه الإمبراطوريات فرضت سياسات مختلفة تجاه المجموعات الدينية والعرقية، مما أدى إلى تقلبات في نسب وأوضاع هذه المجموعات داخل المجتمع الشامل .
فالعوامل السياسية والاجتماعية التي أدت لعدم التجانس في العصور الحديثة هي :
1. تقسيمات سايكس-بيكو وتأثير الاستعمار
بعد الحرب العالمية الأولى، قسّمت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام وفق اتفاقية سايكس-بيكو (1916)، ما أدى إلى تجزئة المنطقة إلى عدة كيانات (سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن)، وفرض واقع جغرافي وسياسي جديد.
من نتائج هذا التقسيم:
- خلق كيانات غير متجانسة ديموغرافيًا، حيث ضُمّت مجموعات دينية وعرقية مختلفة إلى دول حديثة لم تتشكل بشكل طبيعي.
- إثارة النزاعات الطائفية والعرقية، حيث اعتمد الاستعمار سياسة “فرّق تسد”، مما عزز الخلافات بين المسلمين والمسيحيين، والعرب والأكراد، والسنة والشيعة.
2. القضية الفلسطينية وتأثيرها على التركيبة السكانية
والتي كان لقيام دولة إسرائيل عام 1948 أثر هائل على عدم تجانس الفسيفساء الديموغرافية في بلاد الشام، إذ أدّى إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان، وسوريا، والأردن، مما غيّر التوازن العرقي والديني في هذه الدول. كما أدى الصراع العربي الإسرائيلي إلى نزاعات طائفية وعرقية جديدة.
3. الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية
- الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990): كانت مثالًا واضحًا على تفكك النسيج الاجتماعي بسبب العوامل الطائفية، حيث لعبت الفروقات الدينية دورًا أساسيًا في الصراع.
- الأزمة السورية (2011 – حتى الآن): أظهرت التوترات بين المجموعات العرقية والدينية المختلفة، وأدت إلى تغييرات ديموغرافية واسعة نتيجة النزوح والهجرة القسرية.
ويجب ان نشير إلى العوامل الاقتصادية والجغرافية وتأثيرها على عدم التجانس:
1. التفاوت الاقتصادي بين الجماعات المختلفة
لطالما ارتبط التفاوت الاقتصادي في بلاد الشام بالعوامل العرقية والطائفية. فعلى سبيل المثال:
- في لبنان: كانت بعض الجماعات مثل المسيحيين الموارنة أكثر نفوذًا اقتصاديًا من المسلمين الشيعة قبل الحرب الأهلية، مما ولّد احتقانًا طائفيًا.
- في سوريا: سيطرت بعض العائلات العلوية منذ عهد الأسد على الاقتصاد والسياسة، مما أدى إلى توترات داخلية.
2. الجغرافيا كعامل مؤثر في التنوع السكاني
تاريخيًا، استقرت بعض الأقليات في المناطق الجبلية (مثل العلويين والدروز في سوريا ولبنان) بسبب الحاجة إلى الدفاع عن أنفسهم، في حين تمركزت الجماعات الأكبر في السهول والمدن الكبرى. هذا التوزيع الجغرافي عزّز الفصل بين الجماعات العرقية والدينية.
وهنا يحب ان نعود إلى ردور الأيديولوجيات الحديثة في تعميق الانقسامات:
1. صعود القومية العربية والإسلام السياسي
- القومية العربية: خلال القرن العشرين، حاولت الحركات القومية العربية، مثل البعثية والناصرية، توحيد المكونات العرقية والدينية تحت راية العروبة، لكنها واجهت مقاومة من الأقليات غير العربية مثل الأكراد.
- الإسلام السياسي: مع تصاعد نفوذ الحركات الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين في سوريا، أو حزب الله في لبنان، زادت الاستقطابات الدينية والطائفية، مما عمّق حالة عدم التجانس.
2. التدخلات الخارجية وتأثيرها على عدم التجانس
أدت التدخلات الأجنبية (الإيرانية، التركية، الأمريكية، والروسية) إلى دعم بعض الجماعات على حساب الأخرى، مما ساهم في تفكيك الهوية الوطنية وتعميق الانقسامات الطائفية والعرقية.
وفي ختام هذا المقال فإن عدم تجانس الفسيفساء العرقية والدينية في بلاد الشام ليس نتيجة عامل واحد، بل هو نتاج قرون من الأحداث التاريخية، والتغيرات السياسية، والتدخلات الخارجية، والعوامل الاقتصادية والجغرافية.
ومع استمرار التحديات الحالية، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل يمكن تحقيق تجانس اجتماعي في المستقبل، أم أن بلاد الشام ستظل ساحة لصراعات مستمرة؟
إنّ فهم الأسباب الحقيقية وراء عدم التجانس هو الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا، يقوم على التعددية والتعايش السلمي بين مختلف المكونات.
بوابة الشرق الأوسط الجديدة
لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك
لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر