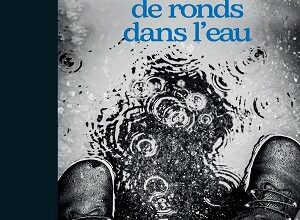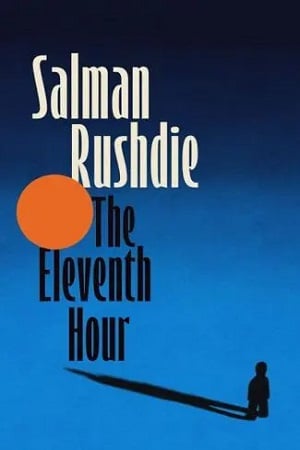
يكاد يكون من المستحيل الكتابة عن سلمان رشدي دون استحضار الظل الطويل الذي يسبقه أينما ذهب: نصه الأشهر «آيات شيطانية». الكاتب، الذي تفوقت شهرة اسمه على شهرة كتاباته بفضل فتوى الإمام الخميني بهدر دمه عام 1989، لم يعد في عالم اليوم مجرد روائي؛ بل غدا «قضية» و«رمزاً» عند البعض، و«هدفاً مشروعاً» عند البعض الآخر.
لقد تكرس لشخصية الروائي المبدع صاحب «أطفال منتصف الليل»، هوية ودور آخرين: كحامل للواء حرية التعبير. ولأكثر من ثلاثة عقود، بدا أن الهوية الثانية تطغى على الأولى. وجاء الهجوم الوحشي عليه في تشاتاكوا عام 2022 ليؤكد هذا الواقع، وليجعل من الرجل الذي كاد يموت حرفياً من أجل الكلمات تجسيداً حياً، ودامياً، لضراوة العمى الآيديولوجي الذي لا يلين.
بعد تشاتاكوا، انتظر كثيرون منه الصمت أو الاكتفاء باجترار الذكريات. لكنه اقترف العكس تماماً. لقد ردّ على السكين التي استهدفته بعملين: الأول كان مذكراته «سكين»، وهو مواجهة مباشرة وصريحة للفعل الوحشي، كأنها تغلب للغة على العنف. والثاني، وهو ما صدر للتو، عمل أدبي إبداعي، يأتي بعنوان دال، ومقلق: «الساعة الحادية عشرة».
لقد كان الهجوم محاولة لإسكاته، لكنه، في مفارقة «رشديّة» نموذجية، منحه صوتاً أعلى، ودافعاً ملحاً للكتابة. إنها مجموعته القصصية الخيالية الأولى منذ سنوات، وهي عمل يكتسب في الأوساط الأدبية ثقلاً هائلاً ليس فقط في سياق كتابته، ولكن بسبب موضوعه. فهذه خماسية قصصية تدور بأكملها حول ثيمات الموت، الشيخوخة، الإرث، والوداع الأخير. الرجل البالغ من العمر 78 عاماً والذي نجا مما كاد أن يكون نهايته، اختار الكتابة، لا عن سيرة «الفتوى»، بل عن مواجهة «الفناء».
لكنها مواجهة تختلف عن أي شيء كتبه سابقاً. فالموت هنا ليس فكرة مجردة أو استعارة سحرية بقدر ما هو واقع ملموس لكاتب نجا من بين أنيابه بالأمس. هذه القصص لا تسأل «ماذا لو؟» بل تسأل «ماذا الآن؟». إنها كتابة ما بعد العراك مع الموت، حيث كل يوم كما «الساعة الحادية عشرة»: وقت مستقطع يسبق النهاية الحتمية.
تتألف المجموعة من خمس قصص، أو بالأحرى خمس روايات قصيرة، تتنقل بين أوطانه الثلاثة التي خبر: الهند، وبريطانيا، والولايات المتحدة. قد يبدو العنوان كئيباً، لكن رشدي، كعادته، يرفض الاستسلام للكآبة. فالقصص موتورة دون شك، على أنها ليست يائسة، بل مفعمة بالحياة واللغة والحب في مواجهة القدر المحتم.
تستكشف القصص ما يعنيه أن يعيش المرء الفصل الأخير من الحياة. في قصة بعنوان «في الجنوب»، نلتقي برجلين مسنين يتشاجران في تشيناي الهندية، حيث تتبدى المأساة الخاصة على خلفية الكارثة الوطنية. هنا، يستعرض رشدي قدرته على التقاط التفاصيل الإنسانية الدقيقة، والحوارات الساخرة التي تخفي ألماً عميقاً.
وفي قصة «موسيقار كاهاني» يعود ببراعة إلى الحي الذي شهد ميلاد رائعته «أطفال منتصف الليل» في بومباي مستخدماً الواقعية السحرية كأداة لتشريح الطبقات الاجتماعية والرغبات المكبوتة في قصة موسيقار عبقري يجد نفسه في زواج تعيس من شخصية فاحشة الثراء. لكن القصة الأكثر غرابة وقوة ربما تكون «متأخر»، حيث يلتقي شبح أكاديمي بطالب وحيد في كلية بجامعة كامبريدج، ويطلب منه الانتقام من معذبه القديم. إنها قصة أشباح، لكنها أيضاً تأمل عميق في الإرث، والجرائم الإمبراطورية، وما الذي يبقى من الإنسان بعد الرحيل.
هل هذا هو رشدي في ذروته؟ لعله ليس سهلاً تجاوز «أطفال منتصف الليل» التي قد تظل أقوى أعماله على الإطلاق. ولذلك يمكن القول بإن «الساعة الحادية عشرة» ليست عملاً تأسيسياً، بقدر ما هي ختام تأملي يكاد يكون وداعاً أخيراً.
النضج الفلسفي جليّ في المجموعة وثمة عمق بيّن في تناول جدل الشيخوخة والموت التي يواجهها رشدي بحكمة ساخرة وقبول فكاهي أحياناً. إنه يكتب كرجل «رأى كل شيء»، ومع ذلك يأتي نثره مفعماً بالحيوية، مضحكاً ومرحاً، مع قدرة استثنائية فريدة على التلاعب بالجمل، والقفز بين الصياغات اللغوية ببراعة لا تضاهى.
على أن العديد من النقاد في الغرب اعتبروا عودته إلى حكايات بومباي أو استخدامه للواقعية السحرية (شبح كامبريدج) بمثابة إعادة تدوير لثيماته القديمة والتي تبدو في «الساعة الحادية عشرة» وكأنها صدى أكثر من كونها صوتاً ملحاً. كما لاموه على توظيف بعض الكليشيهات في تصوير الأثرياء والعبقريّة الفنية. لكن نقاداً آخرين قالوا إن خيارات رشدي لا تبدو بمجملها كسلاً، بل أقرب لتكون استدعاءً متمهلاً واعياً لإرثه الشخصي الخاص، وفحص له تحت ضوء جديد.
والحقيقة أن هذا الجدل النقدي يرافق رشدي منذ عقود. فأسلوبه يعتمد دائماً على التكرار والتضخيم وبناء عالم واسع متصل. اتهامه بـ «إعادة التدوير» يشبه اتهام ماركيز بالعودة إلى ماكوندو. ربما يكون هؤلاء النقاد على حق في أن الصوت الملح الفج لشبابه قد هدأ، لكن ما حلّ مكانه كان صوت الحكيم الذي يمتلك ترف ومأساة النظر إلى إرثه بالكامل كشبح حي.
لكن حتى نقاط الضعف هذه تتضاءل أمام السياق. هذا ليس مجرد كتاب، إنه بيان في معنى البقاء. فرشدي الذي اتهم بالتشكيك في المقدس يعود الآن، في شيخوخته، وبعد أن نجا من الموت بأعجوبة، ليتجرأ على التحديق في «المقدس» الآخر الذي لا يملك أحد أن يشكك فيه: الموت. إنه نص من رجل يدرك أنه يعيش في الوقت الإضافي، يكتب ضد الزمن، ليس كـ«حامل لواء» حريات، بل كما أراد دائماً: كـ«حكواتي». وهذا، في حد ذاته، سجل عظيم يذكرنا بأن الكلمات، حتى لو خذلتنا في وصف الموت، فهي الشيء الوحيد الذي ينقذنا من صمت القبور.
ختتم إحدى قصص المجموعة، بعبارة: «كلماتنا تخذلنا». إنها جملة حاسمة وقاسية من كاتب كرّس حياته للكلمات. لكن المفارقة تكمن في أن المجموعة نفسها تثبت العكس تماماً. إنه انتصار الحكواتي في ساعته قبل الأخيرة. لقد أثبت رشدي أن الكلمات، في النهاية، لا تخذلنا؛ بل هي وحدها التي تبقى وتنتصر على الموت وتجار الموت.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية