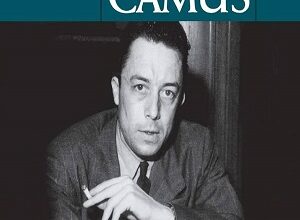نثر ما بعد الحداثة| قراءة في كتاب “العقود” لمحمد خضير

في كتاب محمد خضير “العقود”، الذي أردفه بعنوان ثانوي “سرديات”، ثمة قصدية واضحة في ترتيب وتنظيم الكتاب، وأبوابه التسعة المرتبة حسب العقود (الأول إلى تسعين)، وكل باب يتكون من عدة عنوانات/موضوعات/سرديات، وكل عنوان عبارة عن نص سردي هو أقرب إلى الحكاية منه إلى القصة القصيرة، الحكاية المشبعة بأجواء بورخس، لكنه لا يريده أن يكون قصةً، أو جنساً مقيداً بضوابط معينة. وكلمة “سرديات” هي جمع لكلمة سردية؛ وهذا ما يوحي بالعلاقة بين الشعر والشعر الحر، وبين النثر والنثر الحر، أو كما سماه السرد والسرد الحر، ولكنه يستحوذ على عناصر السرد الأخرى كالحوار، وتسلسل الأفكار المنطقي، وبناء المشهد السردي، وتفاعل روح السرد مع الكتابة بوصفها لعبةً بلاغية ًومغامرةً ثقافيةً.
وهذا الكتاب ليس مقالات أدبية أو إنشائية، كما فعل في بعض كتبه، ومنها “رسائل من ثقب السرطان”، و”أحلام باصورا” أو “أحلام اليقظة والتدوين”؛ وإنما يشكل كتاب “العقود” مرحلةً وسطى بين القصة والمقالة الإنشائية، ولا يعني ذلك العودة إلى ما سمّي في وقته بـ”المقاصة”، وإنما ثمة محاولة لإنتاج نوع نثري حر وجديد.
يحيل العنوان الثانوي “سرديات” إلى وجود نصوص كتابية، تبدو غير ملتزمة بنظام كتابي معين، ولكنها تعد نوعاً من المشاهد والتصورات لعنوانات وأمكنة وأشياء تشبه الأحلام لا بدّ من رصدها، يصورها الكاتب على طريقته الخاصة، فهي تحمل معها نوعاً من الابتكار للتخلص من مؤثرات البدايات القصصية الصارمة، حيث اللقاء بين الصورة والصوت، والمكان والزمان.
يبدأ الكاتب نصه الأول من العقد الأول بقوله “تأتي أعوامي بوجوه جانبيه، متقلبة لا تلبث أن تزول، لكن عمري المديد يلتقط جانبها الظليل كما يلتقط وجه الحياة الخاطف كبرقٍ لامع لا يدوم أمام النظر سوى لمحة. جمعت هذه التجربة ما لا يقل عن تسع صور جانبية، ظهرت وراء مصاريع دوّارة، في مكان شبيه بمتحف طبيعي”. (كتاب العقود، سرديات: محمد خضير، منشورات الجمل، بيروت– بغداد،2021، ص 7).
فالبداية كانت مع الصورة بوصفها وثيقة لا يمكن تجاوزها، صورة واقع في نوع من الاستذكار، كما فعل في كتابه “حدائق الوجوه”. ولربما يحمل النص الأول من العقد الأول معه نوعاً من التمهيد/التنويه إلى هوية الكتاب السردي هذا، والذي لا يصرح كاتبه بأنه قصص أو حكايات أو يوميات، أو مقالات، أو مذكرات، ولكنه يحيلنا الى محطات تصويرية فيها شيء من الغرائبية/العجائبية توحي بنثريات ما بعد الحداثة التي ربما تقتفي خطى بورخس، والأدب العجائبي/السحرية/الفتنازي، وهو ليس بجديد، وإنما هو إعادة إنتاج لسحر “ألف ليلة وليلة”. ولعله أول من رسّخه ودفعه إلى الواجهة في السرد، وهو مع ذلك ليس سرداً عفوياً/فطرياً؛ لهذا لا يميل الى تصوير ما هو عفوي خالص، وإن كان يميل إلى تجسيد الجانب الإبداعي المدروس بعناية فائقة بعيداً عن اللعبة السردية التي تكتب لذاتها فقط، وإن بقي مشدوداً الى صور المدينة الفاضلة/اليوتوبيا التي أطلق عليها اسم “مدينة التسعين” من خلال الانطلاق من “الوجه النصفي للنسغ الدائر فكان لسُحلية خضراء، قضمت أسنان التُرس خلال اندساسها في ثقب على البرج” (ص 8).
كل هذا يحصل بفعل صورة لسُحلية بلغت العقد التاسع في رفقة “جُعل” يحفر مع أنثاه الخنفساء حُفرةً؛ بما يوحي بأن العجائبي هنا له صلة بالحيوانات النادرة كالسحلية والخنفساء والجعل لكي يؤسس في خياله متحفاً يزوره بين عقد وعقد لحيوانات عديدة مثل “الكلب، السلحفاة، اللقلق، الحيّة، الحصان، النملة، السرطان، السنجاب، ثم السحلية والجُعل في عقده التاسع” (ص 9)، فصار كل حيوان أيقونة، حيث مثلت السلحفاة العقد الخامس، والنملة العقد السادس؛ واقترن اللقلق والحية بعقدي “الصبا والشباب”، وصار اللقلق شعاراً للحذق والصبوة. وكانت النملة رمزاً دينياً يتعلق بالنبي سليمان؛ مما يفتح الأفق أمامه للمرور من الحكاية إلى الحلم وتفسيرهما، ثم يأتي رمز الأسد وعلاقته بالإمام علي، ورمز السحلية الخضراء التي تشير إلى الزمن القادم حيث تسد “الأبواب، ويحمل الناس على خشبة جرداء، ليدفنوا بجوار المتحف” (ص 10).
-2-
يرتبط النص الثاني “الظفر المقلوع” بالنص السابق من خلال رمزية السلحفاة، وعلاقتها بنظام العقود الذي يستوحي صوره من “قلادة أصابع البامياء” التي علقتها جدته مع دخوله المدرسة الابتدائية عام 1948، حيث اختل “نظام العقود حينما تغيّرت الأحداث والأشخاص والحكومات بأمر اضطراري” (ص 11). وعلاقة ذلك بإعدام التاجر اليهودي شفيق عدس في البصرة، انتقاماً لنكبة العرب في فلسطين، وانسحاب الجيش العراقي في تموز عام 1948، فما الذي يعنيه الظفر في هذه الحوادث، ثم انقلاع ظفره في تموز 1958؟
العلاقة بين 1948 – 1958 هي علاقة بثقافة العقود أولاً، حينما قام الضباط الأحرار بقتل الملك الشاب ووصيّه؛ فصارت لوحات الأظافر المقلوعة على جدران البنايات في إحالة رمزية إلى قلع الرؤوس، وهو في الغالب مستقى من تاريخ مدينة البصرة (بصرياثا).
أما القسم الثالث من كتاب العقود، فهو “الأبلّية” نسبة إلى ميناء “الأبلّة” القديم في البصرة قبل تمصيرها، والذي وصفه ياقوت الحموي، بأنه سمّي باسم امرأة خمارة تعرف بهبوب في زمن النبط فطلبها قوم من النبط فقيل لهم هولّاطا (بتشديد اللام)،أي ليست هوب ههنا فجاءت الفرس فغلطت فقالت (هوبلت) فعربتها، فقالت العرب الأبلّة (معجم البلدان، 1/77، طبعة دار صادر).
فهل يعيد التاريخ نفسه أو يعيد صيغة التاريخ على وفق متغيرات ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق بطريقة غير مباشرة، وكأنه تكملة لكتابه “حدائق الوجوه”، حيث يشير الى القابلة “الأبلّية” التي جمعت “مصاليخ” الأحياء القريبين منها، وهي صورة للمرأة التي عاشت في “بصرياثا”؛ ضمن إيحاء خفي إلى التنوع الديني والاجتماعي، والعرقي لهذه المدينة، فقد كان يحضر مجلسها سُمراً وبيضاً وسوداً، غلاظاً وخفافاً، سماناً ونحافاً… وهكذا، وهي تموسق كلامها بحيث تقترن الصورة لديها بالصوت، مع الأشياء الأخرى كالدمى والفزاعات والقوارير والوشم، لأن الصورة هي المعوّل عليها في الوصف وإضمار الحوار وطريقة السرد.
وبالرغم من أن الكتاب مرتّب حسب العقود من الأول إلى التسعين، إلا أن كل عقد هو عبارة عن سرديات أدبية، تميل إلى السرد الحكائي، وأحياناً تتواضع فتقترب من المقالة الإنشائية، وهي ربما كتابات حرة بطريقة ما، وهذا ما يبدو على “بلاد الأسماء المتشابهة”، وهو موضوع يحمل معه الطرافة والمفارقة، ولربما يحيل إلى ظروف ما بعد الاحتلال. وكأنه يحيل القارئ إلى رسائل الجاحظ ومقامات مدني صالح، وهذا يحيلنا إلى توصيف طبيعة هذا النص، بوصفه مجموعة وحدات سردية متشظية حسب العقود؛ بحيث تتكشف طبيعة البناء السردي والنفسي لمجمل هذه السرديات. ومحمد خضير في هذا متمكن بحيث غدت “الميم” الحرف الأول من اسمه أيقونة لإحدى عشرة وحدة سردية، كما نوّه بذلك؛ فأصبحت لديه “ميم” المكاري والصراف والتلميذ والمشعوذ والقاتل والبريء والنقاش والمسافر والعطار والبستاني والنساخ. حينما يقول “إني (م) الفخّار أمنح المواليد المجهولين (ميم) البلاد التي أحرقت سجلاتها المدينة، وأعادت تسمية أبنائها المتشابهين في السحنة والمخاض والحياة والموت بحروفٍ صُمٍّ لا توَّرث الا لأمثالهم ممّن يحملونها” (ص19)، فيرسم كل واحد من هذه الميمات مشهداً عن موقف ما له صلة بالموروث العربي والأحداث التاريخية حتى يبلغ ذلك تعبيراً عن الهويات الغامضة وللأسماء المتشابهة. وهنا ينتهي العقد الأول بعد توطئته للعقود التالية.
-3-
يتكون العقد الثاني (العشرون) من ستة نصوص/سرود؛ بينما كان العقد الأول يتكون من أربعة نصوص، وهو يبدأ الأول (النداء) بإحالة إلى نص للشاعر الهندي طاغور، ويفترض حكاية تبدو أقرب إلى الحكايات العربية التراثية، في هواجسها التاريخية، ولكن بصيغة السارد المعاصر، وهي كغيرها مرآة عاكسة، أو وصف أرسطي للفن؛ لهذا قال فيه “تنهّد وحدّق إلى القمر الساطع حتى غشيت عينيه نداوة باردة كسرت مرآة الهور قطعاً صغيرة أمام بصره. أنكر القمر، وتشظت أشعته الفضية وانسلّت في ثقوب القصب والبردي” (ص29).
تنهل طريقة الكاتب في سرد هذه النصوص من أسلوب تصوير المشاهد المنبثقة من أجواء الجنوب، كما هي الحال في سردية “الجيفة” التي تشير إلى حياة المعلمين في الأرياف، حيث تبدو شخصية “المعلم الأعور” أقرب إلى شخصية “الأعمى” وهو يتماهى مع شخصية بورخس وحكاياته المستمدة من “ألف ليلة وليلة”. فإذا كان الطفل هو موضع الاهتمام لدى الباقين الثلاثة لأنه “ظل على ثباته، تلتقط أصابعه حبت العنقود المتناقصة” (ص 36 – 37).
وفي سردية “القرطة” الحيوان شبه الخرافي، وفيها يتابع حركة الصبي وهو يدخل على صورة خرافية معينة في أنها تقرط (تأكل) من تهجم عليه، تقرط وتهرب، لمن يقتحم عليها حياتها. ولكن الفلاحين نسجوا حولها العديد من الحكايات الخرافية، وهنا تبدو صورة الذكورة المتضخمة واضحة، إلى جانب بقاء المرآة العاكسة في حضورها حين “كانت صفحة النهر كمرآة عكست حركة السرد[أي سرب طيور الزاغ] حتى تلاشيه في السماء الصافية” (ص 42).
ولعل الكاتب وظف حيوان القرطة كنوع من الاقتراب من سرديات ما بعد الحداثة في الاحتفاء بما هو فانتازي، كما فعل في سردية “التشييع” حينما وظف طائر “الزيطة” التي تنسجم مع التضخم الذكوري مع التيار العجائبي، أما سرديته “المنعطف” فتكاد تكون قصة قصيرة بمواصفات خاصة، وكذلك الحال في سردية “مطعم الطبيعة” حيث يكثر من ذكر أسماء التصغير، كما في “شكيّر، هليّل” كنوع من التدليل والتحقير، فشخصية هليّل تقترن مع” جوقة من الأبقار والثيران والكلاب والأفاعي والغربان” (ص 53).
-4-
كان العقد (الثلاثون) بمثابة الباب الثالث لكتاب العقود، وقد استهله بنصه “البطات البحرية”؛ وهي ذات صلة بقصة “البطات البرية”، وقصة “(ساعات كالخيول”، فهي تتحدث عن حركة الزمن ودقات الساعة، وبطلها “مصطفى” يعمل في أحد المصارف، يصف المرأة التي تنتظره ببيته بالبطة، بردائها المنزلي الأزرق المطرز بطيور البحر البيض، حيث يشعر بوطأة الزمن وبلوغه الأربعين عاماً، يحمل معه الكعكة هدية لها بمناسبة ذكرى زواجه الثالث، وهو يوازن بين اللوحة والحياة، وبين المرأة والبطة، مع ثنائيات أخرى تعبّر عن هيمنة حركة الزمن وسطوتها، فإلى جانب البطة البحرية توجد إوزات رمادية، حيث تصبح حياة البحر، والبط لغة الحلقة السردية هذه، حتى أنه شبّه السمنة بـ”طائر ذو تغريد حزين”، حيث الانتقال من حركة الساعة إلى حركة البط، ليصبح عمر البطات محوراً للحديث عن البطة العجوز التي تلقي بنفسها من أعلى الصخرة.
أما سردية “تحنيط” فقد نشرت سابقاً في مجموعته “تحنيط” وهي أشبه بالاختيارات في مصر في التسعينات، بصفة قصة قصيرة، بطلها يتحدث عن حضور أمه الكاسح، حتى أنه كان “يشم رائحتها ككلب مدرب عاش سنوات بين النفايات الأمومية والآثار النسوية المختلفة، على الشرشف والطسوت والمهود في حجرات المنزل العديدة” (ص65) وهاذا الكلام يذكرنا برواية “العطر” المعروفة، حيث تسود الرائحة أو تهيمن حاسة الشم، ثم تنتقل إلى مادة “التحنيط”، وكأن القصة هي حفر بما هو قديم وآثري وغاطس.
في سردية “كأس القدر” يميل إلى شيء من الاستذكار، وسرد السيرة الذاتية، ولكن تقنية القصة القصيرة التي يجيد صياغتها وحبكها تهيمن عليه، إلى جانب ضعف القدرة على كتابة الرواية كما حصل له في “كراسة كانون” والتي استعان فيها بأدوات وأجناس كتابية أخرى، كاللوحة والتشكيل، فضلاً عن سرديات ما وراء الرواية، وهو في هذه السردية يستعين بأسلوب الحديث/السرد القائم على الاستذكار، حين يقول في البداية “حدثني صديق كان يقاسمني السكن في جناح ملحق بمدرسة ريفية نائية، عن ليالي اعتقاله، إبان واحدة من نوبات العنف السياسي، في العقد الستيني” (ص72)، ويبدو من طريقة السرد، أن هذا النص يتعلق به شخصياً، فهو تعبير عن تجربة ذاتية، ولأنه يكتب نصاً، فإنه رأى بإمكانه أن يوزع تلك السيرة على عدد من السرديات حتى لا يبرز التضخم الذاتي لديه، وإنما تعبر عن مرحلة سياسية عاشتها؛ لهذا استعان بصورة بأحد أصدقائه لكي يساعده في جمع تلك الاستذكارات.
ثم ربط هذه الاستذكارات بالموسيقى، كما فعل في روايته “كراسة كانون” حين ربط السرد بالتشكيل، حينما ربط علاقته بالأغنية والموسيقى بمذكرات الموسيقار اليوناني “ثيودور راكيس” وظروف اعتقاله في الحرب الأهلية اليونانية، في سجن بجزيرة في بحر إيجه، وهو يستخدم الشخصيات والأمكنة والأحداث لتكون تعبيراً عن معاناته الذاتية، بطريقة غير مباشرة، وأنه لم يتمكن من نقل أفكار هذا الموسيقار حول آلام التعذيب، ولأن صديقه قد افترق عنه، فغنه يعترف بقوله “أنا أعرف اليوم أن اعترافات الألم ليست متشابهة، وطرق التعذيب أشد ضراوة، ومذكرات الضمير ليست واحدة. ارتحل صاحبي المعذّب مع أغنية وصوت” (ص75)، ولعله يقصد بصديقه ضميره الداخلي الذي يؤنبه ويلزمه بالتصريح بتاريخه السري الذي يتماشى والحديث عنه.
-5-
يبدأ عقده (الأربعون) بسردية عنوانها “بلاغات من المرصد” ومن كلمة “المرصد”رتبدو الإشارة إلى سنوات الحرب العراقية– الإيرانية، وما حصل فيها، حيث تكون السيادة لحاسة الشم، منذ البداية، حين يقول “تشمّمت الأرض حريقها، بعد انتهاء المعارك، شواء اللحم، هشيم الأعشاب، الرماد والتفسخ” (ص79)، فإذا كانت الحرب هي عنصر الهدم في المسيرة الإنسانية فإنه ينتقل منها إلى عنصر البناء، وإلى النهر، وهو واحد من تجليات النماء والخصب والتعبير عن حقيقة الزمان والوجود، فيقول “يسلخ المجرى البطيء جلد النهر الأخضر فيكتشف اللون البنيّ للمياه المخبوطة، ثم يزيدها الغروب خمرة واعتكارا” (ص79).
وهو لم ينتقل من الهدم إلى البناء فقط، وإنما انتقل معهما من الشم إلى اللون، أو من الأنف إلى العين، حيث يكون المرصد وسيلة الاتصال بين حاستين، مع الاحتفاظ بحقه في المراقبة من خلال استخدامه ضمير الغائب “هو”؛ بينما سرد نصه “كأس القدر” بضمير المتكلم “أنا”، ثم ينتقل إلى حاسة السمع، عبر حضور آلة الهاتف، ثم البلاغ الليلي، والصمت اللاسلكي، حيث يتسرب اليه الملل بعد “ساعات طويلة صارت تفصله عن البلاغ الليلي الرئيس” (ص 80).
ولأنه معنيّ بسيرة المكان أكثر من سيرة الشخصيات، إلا ما ندر، فإنه يمنح المكان/المرصد أهمية خاصة في الوصف، وهو وصف قريب من تقنيات القصة القصيرة، لأنها أقل اهتماماً به، وهو لا ينسى مراقبة متاعب الراصد، ثم يتحوّل إلى نوع من السيميائية من خلال قيام الراصد بصنع علامة مرتفعة تدل على عزلته المكانية، ومناوبته الزمانية، والمرصد كمكان يعبر عن مهمة صعبة، محاطة بالمخاطر، ترتبط بالإنسان مكانياً وزمانياً، مكانياً لأنه ملزم بالعمل، وزمانياً محدود بوقت معين، وغالباً ما يكون ثقيلاً وخطراً، وبالتالي يقوم الراصد بمهمته ليلاً ونهاراً، وهذا ما يزيد من متاعبه تماماً؛ ولأن محمد خضير دائماً يبحث عن متكأٍ يتكئ عليه لإدامة زخم السرد والوصف والمتابعة، فإنه استدعى ذاكرته لتدعمه بما تحمله عن قصة قرأها في مجلة “الرقيب”، أو “المرصد” وهنا ينتقل من موضوعه الرئيس/المرصد إلى موضوع القصة من خلال أسلوب الميتا سرد، فالقصة “تتحدث عن وحش بحري منقرض يبلغ طوله مئة قدم (…) يسعى الوحش ويشقّ سطح البحر في ليلة ثبتة” (ص84).
ثم ينتقل بين أكثر من موضوع، وهو في كل هذه النصوص تبدو النخلة جسداً شامخاً وجزءاً من حركة السرد، ومكملة لحركة الوصف الذي يوقف حركة الزمن، في القصة، ولأن الكاتب لا تناسبه كتابة قصة، أو تجنيس ما يكتب، فإنه يتحرك بحرية تامة نحو المثابات التي يرصدها، كما في “رسالة جندي” التي تقترب من موضوع المرصد، والنص هو على شكل رسالة، مشحون بحماسة عالية يخاطب به أباه وأمه وزوجته وأبناءه وأصحابه، ليقول “أنا لا أخشى الموت الآن. قاتلت بضراوة. منذ ستة أيام ونحن في قلب الجحيم” (ص 88).
وهذا ما يتيح له وصف المعركة/الحرب من الداخل، وهنا يأخذ الوصف جانباً مهماً، لأنّ السرد تتركز حول بؤرة صغيرة من الأرض هي فضاء المعركة، وهذا الوصف يحاول الموازنة بين صوت الذات وصوت السارد بضمير المتكلم، والوصف الذي يوازن به بين الإنسان والدمار، في نهاية السرد، تتوقف الحرب، حيث يجد حارس البساتين الرسالة المبللة حائلة الحروف، مخفية تحت بطانة الخوذة؛ مما يوحي بأن كاتب الرسالة الذي لا يخاف من الموت قد يكون قتل، لأن وجود خوذته وورقة الرسالة تحت بطانة الخوذة لدليل على وضع مربك، بناء السردية هو بناء ميتا سردي، يشبه بناء رواية كويلو “خمس عشرة دقيقة”.
في سردية “المهرجان” يتكئ على قصيدة لمايكوفسكي “غيمة في بنطلون” لتصبح هي محور النص، بما يوحي للباحث بأنه يبدأ بكل سردية على وفق تخطيط مسبق، ليجعل الفكرة التي يستند عليها حاضرة في ترتيب السردية، من البداية والنهاية والحشو، كلها تعمل على تأسيس جماليات الابداع السردي، حيث تكون شخصية “الشاعر الأحدب” هي الشخصية الأكثر توهجاً؛ لهذا تنتهي السردية مع رحيل القطار، والرحيل له صلة بحياة الكاتب وحركته مع القطارات الصاعدة والنازلة. وهو يطرح جملة توازيات في هذه السردية، منها توازي الخصب والتعذيب على جذع النخلة (شرب الماء، والشد على الجذع)؛ وتوازي النخلة مع العمة، والشجرة العراقية مع شجرة البمبر (المجلوبة من الهند)، بين ناقوط الماء ولزوجة البمبر، والتوازي بين الحلم والواقع، والتوازي بين الحلم والأرض، وبين السرد والعلم. وهو في هذا العقد (الخمسون) يحاول أن يعقد موازنة غير مصرح بها بين السرد القصصي المنضبط وبين ملامحه التاريخية والشعبية؛ وهو ما يفعله في “رجل التوافه” الذي يحتويه سوق الهرج، حيث تباع بعض الأشياء ذات التاريخ المنسي، وكذلك يعمل على حصول التوازي بين صور هذه اللُّقى وبين لوحة فان كوخ، حيث حكاية رجل التوافه تبدو ظاهرة وتخفي خلفها اللوحة، وكذلك التوازي بين السطح والسرداب، أو بين الأمكنة الظاهرة والأمكنة الخفية كالسراديب، كما فعل في مجموعته “المملكة السوداء”.
-6-
في العقد (الخمسون) ثمة عدة سرديات، واحد منها بعنوان “آخر العباسيين” يستحضر فيه تاريخ البصرة القديم، وسور جامع “الكواوزة” ومئذنته، مما يذكرنا بقصة “المئذنة” في “المملكة السوداء”، وكالعادة يتكئ على فكرة/ثيمة تاريخية قديمة يجعلها سنداً له لأنه يكتب سردياته المرتبطة بالمكان بكل مؤثراتها، مثل (ثورة الزنج/عاصمتها المختارة، الصالحية، شط العرب، وجذع النخلة)، وهو بذلك يوازن بين حركة الجفاف والألم والجوع بحركة المياه والخصب، والارتباط الصميمي بين الإنسان والنخلة حيث شدّ على جذعها كوز الماء بالحبال، وشد بها أبوه وجُلِد قبل سقوطه من قمتها، كما كانت عمته التي ذوى جذعها تتوكأ على عُرجون وتقترب بدبيب غير محسوس من النخلة لترشق زيق ثوبها بقبضة ماء بارد من ناقوط الكوز. لقد كان المفتاح بالنسبة إلى رجل التوافه هو دليله الذي سرق منه، حيث بدا المفتاح تعبيراً عن الافتضاض والنهاية المحتملة بالنسبة إلى امرأة المفتاح.
في سردية “س” مقابل “ص” يحيلنا إلى قصتين كل واحدة يمثلها واحد من هذين الحرفين، حيث يعود إلى سيرة التوازي بين الماضي والحاضر، فتكون البدايات “مجسدة في السمين رمزيين، وهميين.. التقابل المباشر بين عنوانين طالما سيطرا على نصوصك.. الاستعارة مقابل التصريح، والحياة مقابل المجازفة، والوهم مقابل الحقيقة” (ص 114).
ومثلما كان النص السابق، كان المكان/العشار وأم البروم، كانت سردية “متر مربع من الرصيف” حيث تستمر لعبة التوازي، ويستمر الاتكاء على ثيمة معينة، متمثلة بالمعلومات التاريخية على سرديات مضمرة أو ظاهرة، مثل إشارته إلى “قيان بغداد” لعبد الكريم العلاف.
-7-
يتكون باب (الستون) من ثلاث سريات (الطالع الأخير، الصفر، الموسوعة)، الأولى كتبت بصفة قصة قصيرة، وهو يرتكز في كل منها على ثيمة معينة، تعد هي مركز السردية وتحولاتها النصية؛ ففي الأولى يستند على فكرة المقهى والجميزة، وعلى وفق توازيات واضحة بين المكان والجميزة، ثم يشير إلى علاقة السردية بالرقم (ستين)، حيث “الشارع خالٍ، دهليز البريد هامد. فئران الساعة الكبيرة قرضت الرسائل. خادم المقهى يُفرغ بقية شاي الصباح في البالوعة” (ص 123)؛ فالزمن متمثلاً بالساعات يلتقي مع البريد/الرسائل/الاتصالات، الحياة في المقهى تشكل نوعاً من القلق والاستراحة المؤقتة؛ من خلال صورة “الساعاتي الكهل الذي نصب الساعة القديمة على واجهة دائرة البريد. منذ أعوام وقلب الساعاتي ينبض بانتظام مؤقتاً ساعة البريد عن بُعد”.
إذ يخيم الزمن والكهولة على مناخ السردية وسيرورة الحياة، وصور شخصيات أدبية قديمة عراقية وعربية وعالمية، ثم يصبح الرقم “صفر” هو محور اهتمامه لأنه لا ينفصل ولا يتجزأ. أما السردية الثالثة “الموسوعة” فهي استشرافية، من خلال صورة البروفيسور لبيب الشميساني وأفكاره التي تجعل المستقبل موازياً للحاضر.
أما (السبعون) فيتكون من سرديتين، هما “عيون المشنوقين”، و”الطفل المخطوط”؛ وهما تشيران إلى الموت والخوف والإرهاب والترهيب، وان كانت الأولى تتحدث عن المشنوقين في سجون المستبدين، حيث تكون العيون مقلوعة، وهي تتكون من:
بحيرة العيون.
مقلع العيون.
النوتي.
حقل العيون.
البشارة.
وهذه أغلبها عن العيون، ففي الأول، يلمّح إلى اللون الأحمر، لون الفجر، وربما لون علم الحزب الشيوعي، وفيه تلميح إلى سجون وأعلام المناضلين، وفي الثاني إشارة إلى غرفة الإعدام وقلع العيون في السجن المركزي، وفي الثالث نتعرف على اثني عشر معدوماً. في السردية إشارة، فإذا كان عدد الجثث هو “12” جثة، فإن يوحنا النوني ينزل “العميان الاثني عشر في حقل متموج بالسنابل الناضجة في ظاهر بغداد” (ص 146). وفي هذه السردية إشارة إلى رؤيا النبي يوسف حول السبع سنابل الخضر، والأخرى اليابسات، وفي “حقل العيون” يشير إلى العيون في البحيرة الحمراء، في إحالة رمزية إلى تاريخ الحزب الشيوعي.
تتكون السردية الثانية “الطفل المخطوط” من قسمين، وفيها إحالات إلى كتابه “رسائل من ثقب السرطان” حين يقول “يطيب للسرطان أن يغادر ثقبه” (ص 149)؛ وهي تتحدث عن ثلاثة أعوام على اختطاف طفل حول ما يشيع الآن في العراق.
-8-
في الباب (الثمانون) كتب عنواناً ثانوياً (قصص تحت الأرض) في إشارة إلى جنس هذه السرديات، أي أنها تجمع بين كتابة الرسالة القصصية والقصة؛ كما فعل ذلك عبدالستار ناصر في “رسائل إلى امرأة عاشقة”؛ وهي خمس رسائل قصيرة، باستثناء الأخيرة التي عنوانها “رسالة”، وإن لم تكتب بصفة رسالة تماماً، فقد كتب مقالاته بعنوان رسائل في كتابه “رسائل من ثقب السرطان” حيث الإحالة إلى اللعبة السياسية، وما تخفيه من مفاجآت، حيث صار السجّان يلبّي حاجات السجين، وقد حمل سرجون رسالة ملكه إلى لوكال زاكيزي وانحاز ضد ملكه. وإن كان النسغ الرسائلي يتغلغل في البناء السردي، فالكاتب في الأغلب يتكئ على ثيمة مؤثرة تبدو كالمجداف في زورق تائه، لهذا يسترجع الكثير من الرؤى والأفكار حول الرسائل القديمة لدى الإغريق والرومان والروس، ورسالة الجندي الذي “نقل رسالة صدام حسين إلى آمر وحدته يأمره بقتله، لسماعه تأنيب عشيرة الرئيس له في حضوره” (ص 158)، ورسالة المتلمس التي تشبهها تماماً، فضربت العرب بها المثل.
ثم ينتقل في “برج بابل” الذي أطلق على اسم فندق، ومنه انطلق لوصف قصص ذي النون أيوب التي كان يكتبها بصفة “مقاصة”، أي مقالة قصصية، أو كما كانوا يسمونها بـ”كتاب العرائض” وهذه السردية مهمة، حيث ينتقل في “تل القمامة” إلى كتاب العرائض الحقيقيين، بينما يتجه إلى موظف البريد في “جرافيتي 2042”. والثيمة التي تستند عليها هي الرسم، وعلاقته بالرسائل، وهي تتحرك بطريقة تشبه قصص الرؤيا التقليدية، كنوع من التقنية التي تجمع بين الرؤيا والسينما.
أما باب (التسعون) فقد تضمن عنواناً ثانوياً آخر هو “تجارب في الموت” وهي تجارب تشبه تجارب “السجن”؛ ذلك لأن السجن يحاكي نوعاً ما القبو لدى دستويفسكي في كتابه “رسائل من قبو الموتى” أو من العالم السفلي، كما كان الحال في الأساطير العراقية القديمة. بينما يجري بشكل مضمر في “الانتقال” بين الموت والحياة. وفي “بيبليوتيكا” يتكئ على أمبرتو إيكو في علاقة الذاكرة بالحياة، أو علاقة الجنون بالوعي، وجل سردياته الأخيرة تحيلنا إلى انهيار الحواجز بين الأنواع الأدبية، وبالذات بين القصة والمقالة وتحولهما إلى سرديات فقط ذات صلة في الأغلب بالأمكنة والحياة.