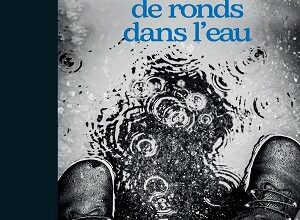ديفيد غودهارت: غير وارد الإطاحة بالديمقراطية الليبرالية

https://middle-east-online.com/
أنهما تمثلان مولد عصر سيادة الشعبوية بل شيخوختها. هذا ما يؤكد عليه الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد غودهارت في كتابه “الطريق نحو مكان ما” الذي يأتي كمحاولةٌ لتقديم نقدٍ أوسع لليبرالية المعاصرة من صميم الرؤية الراديكالية.
يكرس غودهارت معظم كتابه، الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود وترجمه الباحث في المركز العربي في واشنطن رضوان زيادة، لإظهار الأثر الذي تتركه التجارب والظروف على ما يتبناه الفرد من قيمٍ ومواقف؛ فالحركية والتعليم يساعدان على شحذ الفردانية التقدمية التي يمتاز بها “المنفتحون على أي مكان”، في حين أن اجتماع التجذر وكبر السن مع قسوة الظروف يؤدي إلى تشكل الشعبوية المعتلة التي ينادي بها “المنغلقون على مكانٍ ما”. لكن، وكما أظهر إيريك كوفمان في الدراسة التي قام بها حول الذين صوتوا لبريكست، فليس ثمة علاقةٌ مباشرةٌ بين القيم التي يعتنقها المتعصبون “المتشددون والمعتدلون” وبين ما خاضوه من تجارب، بل يمكن ربطها بجذورهم، وبالوالدين، ولعل الأمر متعلقٌ بجيناتهم أيضاً.
ويرى أنه من غير الوارد أن يتم الإطاحة بالديمقراطية الليبرالية، حتى في الولايات المتحدة الأميركية. فالوفاق والنظام المدني عاداتٌ راسخةٌ، وستواصل الأغلبية الساحقة نظرها إلى أميركا على أنها أرضٌ متعددة الأعراق. على حين ستحافظ السياسة البريطانية إلى حدٍ كبيرٍ على كونها إما تكنوقراطية أو محكومة بأولويات اليمين واليسار، كالانشغال مثلاً بإيجاد الطريقة المثلى للربط بين السوق والدولة في عمليات الإنفاق على البنية التحتية، أو إيجاد طريقةٍ للحد من التفاوت. إلا أن السياسة الغربية قد وجدت نفسها منذ مطلع هذا القرن مجبرةً لكي تفسح المجال لأصواتٍ جديدةٍ يسيطر على تفكيرها القلق على حماية الحدود الوطنية وسرعة التغيير الحاصل، وأن تستمع لأولئك الذين يشعرون بأنه لا مكان لهم داخل مجتمعٍ واقتصادٍ شديدي الانفتاح.
ويوضح أنه ما إن تمّ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى بدأت موجة ندبٍ مطولة تعبيراً عن الاستياء لانقسام الشعب البريطاني إلى قسمين. وحسب ما قيل، إن من صوّت لصالح الخروج البريطاني هم فشلة بريطانيا الخاسرون: المتروكون في الخلف، من الطبقة العاملة البيضاء في الشمال والمقاطعات الإنجليزية الوسطى، المدعومون من قبل الجيل الأكبر في كل مكان، ومن قبل أعضاء حزب المحافظين في جنوب البلاد. فلهؤلاء تجاربهم وفلسفتهم الحياتية المغايرة تماماً لتجارب وآراء الذين صوّتوا عن قناعة لبقاء بريطانيا وعدم انسحابها من الاتحاد الأوربي ممّن كانوا من أصحاب النجاح: فهم متفائلون، وفي مقتبل العمر، ومن مثقفي الطبقة الوسطى، كما أنهم يعيشون في كبرى المراكز الحضرية والمدن التي توجد فيها الجامعات”.
ويشير غودهارت إلى أنه مع هدوء العاصفة، ظهرت وجهة نظرٍ أكثر دقّة عملت على زعزعة هذا الحديث عن الاستقطاب الحاصل، من خلال إشارتها إلى تنوّع وتعدّد القبائل البريطانية وتقسيماتها الداخلية الفرعية أيضاً. فثمّة نسيجٌ فسيفسائيٌّ معقد يضمّ الاختلافات كافةً: الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على حدّ وصف مركز أبحاث المستقبل البريطاني فقد لوحِظ أن 37% فقط من حزب العمال صوّتوا لصالح الانسحاب، في حين أن أغلبية العامة من أصحاب الدخول المتدنية الذين يسكنون في المساكن العامة الرخيصة قد صوتوا لصالح مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وكذلك فعل أولئك الذين توجّب عليهم تسديد القروض العقارية للحصول على مسكن، كما تواجدت أقلياتٌ كبيرةٌ، بلغت نسبتها نحو 40% في كلا الفريقين؛ إذ صوّتت هذه الأقلية في لندن واسكتلندا من أجل البقاء، بينما كان تصويت الأقلية في الغرب الشمالي وغرب المناطق الداخلية لصالح الانسحاب.
لكن، غالباً ما تكشف ردود الأفعال الأولية عن الحقائق الجوهرية؛ فقد كشف التصويت على البريكست عن وجود انقسامٍ مركزيٍّ كبير داخل المجـتمع البريطاني. لكن هذا الصدع/الشـرخ لم يكن وليد الفوارق الاجــتـماعية الطبقية، وإن كان الخيار السياسي الأكثر ارتباطاً بالطبقات الاجـتـماعية، المحتمل أن أشهده في حياتي برمّتها؛ إذ وصلت نسبة المصوّتين من أجل البقاء، في الطبقات الاجتماعية العليا 57% ومن ثم أخذت بالتناقص/ بالتراجع نزولاً، لتسجّل، في الطبقات الاجتماعية الدنيا 36% فـقط، في حين بلغت في الطبقـة الاجتماعية المـتوسطة 49%”.
ويؤكد غودهارت إن الانقسام الحاصل يتمحور حول التعليم والحركية الاجتماعية؛ بل إنه في حقيقة الأمر نتيجة السببين معاً. فلم يكن الثراء، أو المنصب الإداري الرفيع، المعيار الحاسم للتنبّؤ فيما إذا كان المرء قد صوّت لصالح أو ضد بريكست؛ بل كونه خريجاً جامعياً أم لا؛ إذ إن أكثر من ثلثي الخريجين الجامعيين قد صوّتوا من أجل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي. ويظهر هذا الانقسام، على نحوٍ واضح، من خلال قيامنا بتحديد السبب الذي استثار غضبنا في تلك الحادثة، وهو ما حدث إثر تذمّر نايجل فاراج، حين عبّر عن شعوره بعدم الارتياح/بالانزعاج أثناء سفره في قطارٍ لا يقلّ أيّ مسافرين ناطقين بالإنكليزية؛ إذ ضجّت وسائل الإعلام، لأيام عديدة، بأصداء غضب “المنفتحين على أي مكان”. لكن الطرافة جاءت حين تبيّن أن نسبةً تراوح 60% أو 70% من السكان المحليين رأوا أن ما ذهب إليه فاراج لا يعدو كونه أمراً بدهيّاً يوافق الفطرة السليمة. أو لدى رفض جيرمي كوربين إنشاد النشيد الوطني في إحدى أولى إطلالاته بوصفه رئيساً لحزب العمال، ليأتي دور “المنغلقين على مكانٍ ما” هذه المرة فيجنّ جنونهم، في حين نظر “المنفتحون على أي مكان” إلى المسألة بأنّها نوعٌ من التلطيف الإعلامي المسلّي. إن أي مجتمعٍ حرٍّ يشتمل على العديد من القيم ومعايير التفكير المتباينة والمتضاربة مع بعضها، لكن ما إن تصبح هذه الفجوة شديدة العمق، ولاسيّما بين الطبقة المسيطرة وبقية فئات الشعب، حتى يصير المجتمع عرضةً لحدوث صدماتٍ وردود أفعالٍ شبيهةٍ في بريكست.
ويقول غودهارت إن الشعبوية المعتدلة أكثر فوضويةً وتناقضاً من الفردانية التقدمية، وهو ما قد يتوقعه المرء من أناسٍ لا يشغلون أنفسهم كثيراً بالسياسة. فالجزء الأكبر من الشعبويين المعتدلين لديهم تحفظاتٌ حول الانسياق وراء الليبرالية الحديثة، إلا أن هذا لا يعني أنهم، في أغلبيتهم، غير تحرريين. أو بعبارةٍ أخرى، يمكن أن نقول إنهم متسامحون إلى درجةٍ كبيرةٍ، من منطلق لنعش حياتنا وندع الآخرين يعيشوا حياتهم بطريقتهم، إلا أنهم لا يملكون قيم وأهداف الليبراليين ذاتها. ولما كانت الشعبوية المعتدلة تختلف عن التعصب الشديد، فهذا يجعل منها تياراً رئيساً يمتلك رؤيته الخاصة بها، التي تمثل جزءاً كبيراً من السياسة البريطانية الوسطية. وبالفعل، إن الشعبوية المعتدلة تطلّ علينا من خلال عناوين استبيانات الرأي الحديثة، فالتحرر الكبير على أصعدة الأعراق، والجنسانية، والجنس قد صار يتمتع بقاعدةٍ داعمةٍ كبيرة أسفل الطيف التحرري؛ ففي وقتٍ ليس بالبعيد يرجع إلى الثمانينيات، اعتقدت نسبة 70% من الناس أن العلاقات الجنسية المثلية أمرٌ خاطئ، في حين صارت النسبة ذاتها تقريباً تدعم اليوم زواج المثليين. إن هذا الانزياح الحاصل قد ضمّ في صفوفه الكثير من الشعبويين المعتدلين المنغلقين على مكانٍ ما. ومع ذلك، إن جماعات أغلبيةٍ مماثلة ترفض الهجرة الجماعية، وتولي أهميةً كبيرةً للمواطنة المحلية، كما أنها تعارض الرفاه الذي لا يشتمل على الجميع، ولا تحبّذ تعدد الثقافات الحديث “على الأقل في شكله الانفصالي”، فالشعبوية المعتدلة تنبثق عن هذا التراكب بين الأغلبيات.
ويلاحظ أن الشعبوية المعتدلة نجحت في إجبار “المنفتحين على أي مكان” على القيام بعددٍ من التراجعات الأخرى، وبالتراجع عن بعض الأمور التي كانوا قد أجمعوا على تفضيلها. فقد تمّ خلال السنوات الأخيرة إحداث تطبيعٍ لفكرة الهوية والروابط الوطنية، حتى بين صفوف أصحاب العقليات التحررية؛ الأمر الذي تم تتويجه بمهرجان داني بول في بريطانيا، الذي تمكّن، باختصارٍ، من توحيد “المنفتحين على أي مكان” و”المنغلقين على مكانٍ ما” تحت علمٍ موحدٍ واحد. كما تم، من جهةٍ أخرى، تداول نقاشاتٍ أكثر واقعيةً وشديدة البعد عن التطرّف حول الهجرة والاندماج؛ الأمر الذي بوسعنا القول إنّه قد تُوِّج بحدوث تقبلٍ عامٍّ لفكرة أن حزب استقلال المملكة المتحدة، على الرغم من تمثيله للفيفٍ جماهيريٍّ بريطانيٍّ صعب المراس ومتعصبٍ أحياناً، لا يُعدُّ حزباً عنصرياً في واقع الأمر. كما أن حقيقة تموقع قضية الحد من الهجرة في صميم السياسة البريطانية خلال السنوات العشر الماضية – بما في ذلك النجاح المحدود في الحد من أعداد المهاجرين الوافدين من خارج الاتحاد الأوربي منذ عام 2010 – يرجع إلى استمرار “المنغلقين على مكانٍ ما” بالإدلاء في استبيانات الرأي أنهم يرون أن معدلات الهجرة شديدة الارتفاع جداً.
ويضيف غودهارت “تمكن “المنغلقون على مكانٍ ما” من التأثير على أصعدةٍ أخرى أيضاً، كالسياسة الاجتماعية وسياسة الإعانات، مثلاً؛ فجميعنا شركاء، بطريقةٍ أو بأخرى، في نجاح أو فشل بعضنا، حيث إننا في المجتمعات الغنية نعتمد استراتيجية تجميع المخاطر سواء من خلال اعتماد أنظمة التأمين الإجبارية، كما هو الحال في فرنسا وألمانيا، أم من خلال أنظمة “تجميع المخاطر” الأكثر استناداً على الضرائب بشكلٍ عام، المتبعة في دولٍ مثل بريطانيا والسويد. لكن، لعل اللامبالاة البيروقراطية الموجودة في الدولة الحديثة قد أدت إلى الإطاحة بهذه الفكرة النبيلة بالدعم المشترك”.
ويشدد غودهارت على أنه يمكن أن نمنح الشعبوية المعتدلة صوتاً أعلى، وأن نقوم بالاستفادة من خروجنا من الاتحاد الأوروبي لإعادة الهجرة إلى سوياتها الأدنى، وأن نزيد من تركيزنا على الاستقرار، إضافةً إلى تجديد العقد الاجتماعي الوطني، وخصوصاً على صعيدي التعليم ما بعد المدرسي والتوظيف. ففي حال لم يقم مجتمعنا، الذي يسيطر عليه “المنفتحون على أي مكان” باستيعابٍ أفضل لمشاعر ومصالح “المنغلقين على مكانٍ ما”، سوف نشهد حدوث المزيد من نماذج الاضطراب السياسي المشابهة لبريكست، بل لعلنا سوف نشهد أعمال عنفٍ متقطع في حال نجح الإرهابيون في نشر الذعر عبر المدن الأكثر انقساماً في إنجلترا.
ويخلص غودهارت إلى أن معظم الناس – وإن ضمن مجتمعاتنا الأكثر غنىً وحركيةً – ما زالوا متجذرين ضمن عائلاتهم ومجتمعاتهم، فهم غالباً ينظرون إلى التغيير على أنه خسارة لشيء ما، ويشعرون بهرمية الروابط والالتزامات الأخلاقية نحو الآخرين. فطالما نظر “المنفتحون على أي مكان”، خلال الجيل الماضي، باستعلاء إلى أمثال هؤلاء الناس، إلا أن انتماءات هؤلاء لا تمثل عقبات في الطريق نحو تحقيق مجتمعٍ جيد، بل هي أحد حجارة الأساس لتشكيل هذا المجتمع. وبوسعنا القول إنه من الممكن حالياً، عقب صدمة عام 2016، إحداث تعايشٍ أكثر سعادةً؛ وهو ما يعني أن الكأس المقدسة التي يجب أن ترفعها سياسة الجيل القادم، هي المطالبة بتحقيق تسويةٍ جديدةٍ أكثر استقراراً بين “المنفتحين على أي مكان” و”المنغلقين على مكانٍ ما”؛ ما سيؤدي إلى المصالحة بين شطري الروح السياسية للإنسانية.