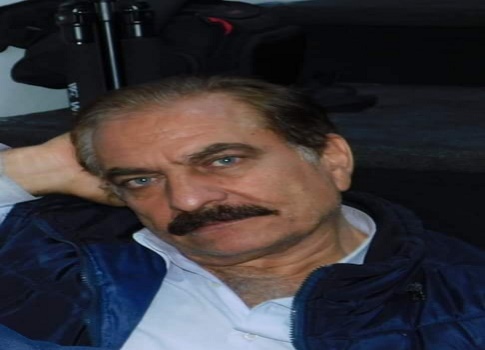هذا الكوكب الجميل

هذا الكوكب الجميل.. القراءة في وجوه الناس، أفرادا ومجتمعات، وتملِّي ملامح الطبيعة.. لا يقلان أهمية وغني ومتعة عن قراءة الكتب. وفي الفسحة الأخيرة من هذه الرحلة الجميلة، على اختلاف أحوالها وتنوع ألوانها وثمرات دروسها يكثر التلفت إلى الماضي وتنهمر الذكريات. وحين أستحضر أطيافا وصورا من هذا العالم، بدءا من واشنطن حتى طوكيو، مرورا بمعالم وبلدان شتى ومنها ذلك المرصد الفلكي الباقي من العصر العباسي في ضاحية سمرقند حتى صفاء الشمال الاسكندنافي، وصولا إلى سور الصين… أشعر بشيء من الغبطة الروحية والاعتزاز الإنساني أني لم أكلف أهلي ولا بلادي بنسا واحدا من تكاليف السفر، وكان الفضل الأول للشعر ودراسة اللغة الإنكليزية، دون أن أغفل عن أهمية الصداقات التي أتاحت لي بعض تلك الزيارات. أما البلاد العربية، فقد أتيحت لي زيارتها أكثر من مرة، باستثناء ليبيا والسودان وموريتانيا.. وما زالت زيارة السودان حلما عزيزا، وبخاصة أن لي عديدا من الأصدقاء، إلى جانب تقديري الكبير للحركات الصوفية التي حملت جوهر الإسلام إلى ذلك البلد الإفريقي الحميم، بعيدا عن الغربان التي لم تجلب لنا غير التكفير والغدر والإرهاب.
في كتاب الذكريات “الحنظل والرحيق…” أوردت باقات من أحوال تلك الزيارات. لكن الجانب الكوميدي في الزيارة الأميركية، حدث لي في مطار لندن وفي زيارة نصب الحرية في نيويورك. في طريقنا إلى الولايات المتحدة، أمضينا يوما وليلة بالانتظار في فندق قريب من مطار لندن، وسرعان ما نزل أصدقاء الرحلة لزيارة العاصمة الإمبراطورية العجوز، وقد ألحوا علي بمرافقتهم. لكني شعرت برومنسية جارحة أن أمشي في شوارع لندن وهي معبدة بدماء ألوف الضحايا من العرب والهنود، ولا سيما اغتصاب فلسطين. جلست في مقهى فندق العبور وكتبت مقطوعة صغيرة بعنوان (الرخمة العجوز) وفي لسان العرب أن هذا الطائر موصوف بالموق، أي الحمق، وفي القصيدة أقول:
“دم عربيّ/ وآخر هنديّ/ ومن قلب إفريقيا أنهرُ الأرجوان../ هذه التربة الظالمة/ فيكِ يا أرض إنكلترا/ كيف أمشي على بسطٍ من دمي؟/ وكيف أحاور؟/ كيف أحيِّي وحوشاً بنَوْا مدناً من شقائي؟!/. . ./ في هدير المصانع أشعر دمدمة من عظام الجدود/ في الجسور أعاني أنين الجياع/ وفي كل زاوية أتلمَّس مأساة شعبٍ/ مشى فوق تاريخه وجراحاته المزمنة/ جبل من حديد أساطيلك الطاغية/ . . ./ عجوز من الرخم البائدة/ تعيش على نثرات الموائد خلف المحيط/ كانت الشمس تحضن شاراتها العسكرية/ لا تستطيع الغياب
ثم جاءت رياح الأهالي/ فأوحت إلى الشمس أن تستريح/. . ./ عجوز تموت اختناقاً بأورامها..
وتموت اهتراء/ وليس لها أملٌ بالشفاء/ وليس لها موعدٌ للنشور!
– على مقربة من مطار لندن – ليلة 1979/9/9
أما (ضريح الحرية) فكان عنوان القصيدة التي كتبتها بعد زيارة تمثال (الحرية) في نيويورك.. وصعدنا داخله حتى الرأس، وفيها أقول:
“حديدٌ، حديد/ جبلٌ أجوفٌ من حديد/ وقميصُ حِجارة/ ولا روحَ، لا حسَّ، لا دفءَ/ لا شيءَ يملأ هذا الخواء الخرافيَّ/ لا شيءَ.. غيرَ صقيع الحجارة/ وبؤس الحديد!/. . ./ الشعلةُ – الحلمُ التي لوَّنها الفنَّان/ بروحه، ومدها بشرى إلى السماء/ نافورةً من جلَّنار/ ماتت ولم يبقَ سوى الرماد والدخان/ ليحملا عن الزنوج غبرةَ الفناء/ ولعنةَ الدولار/ يا خجلَ النحَّاتِ مما اقترفت يداه/ ويا ضياعَ التعبِ النبيل/. . ./ حديد، حديد، حديد/ جبل مترع بالأسى والصديد/ يا له من ضريحٍ جليل/ لإيواء هذا المثال القتيل!
– نيويورك – 1979/10/11
أما سور الصين العظيم، فهو آية معمارية عجيبة.. ولعل الحكايات المؤلمة في بنائه تحتاج إلى خاطرة مستقلة، وخاصة أن بعضها تحول إلى أساطير، يشترك البشر والطير والماعز في صياغة أحداثها. وتبقى للهند روعتها.. وطبيعتها الساحرة من غابات جوز الهند إلى قطعان الفيلة، وصولا إلى أجوائها الصوفية التي تذكرنا بالمهاتما غاندي والشاعر العظيم طاغور. ويكفي أن ولاية كيرلا على الساحل الجنوبي الغربي أخذت اسمها من “خير الله”. الصين والهند تستحقان وقفة مستقلة.