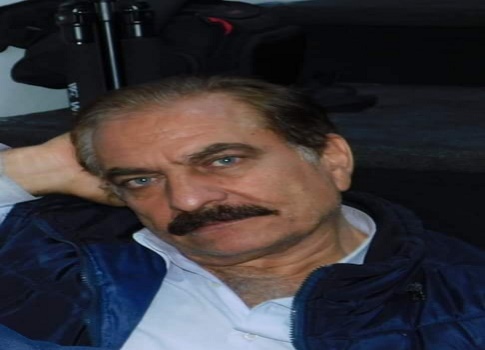أصفى ينابيع الشعر

أصفى ينابيع الشعر … في سكينة الغروب، ومن هذه الفسحة الضبابية أطل على فضاء العالم الشعري الذي عشته من أيام دعوة امرئ القيس للوقوف والبكاء، وهو يستحضر ذكرى الحبيب والمنزل، الإنسان والمحيط الطبيعي والاجتماعي، حتى خراب الدورة الدموية لدى رياض الصالح الحسين/ قيثارة الحزن الجريحة الجارحة في هذا الوجود، مرورا بنجوم العصر العباسي وبلابل الأندلس وأعلام النهضة وشعراء المهجر وفي طليعتهم جبران وأبو ماضي، وصولا إلى غنائيات الشابي وعلي محمود طه وعمر أبو ريشة ومعروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي وبدوي الجبل والأخطل الصغير وحتى أحمد فتحي ومحمود حسن إسماعيل.
في طفولتنا وصبانا الأول، لم يكن في محيطنا الزراعي/ الرعوي مدارس ولا مناهج تربوية مقطرة. القرآن والتراث الشعري وما تيسر من الحكايات والسير الشعبية، هذه هي صفوة الكنوز التراثية التي كانت في متناول أيدينا، وهي ثروة أدبية وثقافية وفيرة، ممتعة وفيدة من جميع النواحي الواقعية والفكرية والروحية.. وحتى الأسطورية. وفي تلك المرحلة المبكرة، كنت مطالبا بحفظ عشرات القصائد لإلقائها في سهرات الضيوف. وجاءت المدرسة بعد جلاء قوات الانتداب الفرنسي لتزيد من تحصيلنا الشعري والقصصي، فضلا عن المقالة في كتب القراءة، بالعربية والإنكليزية.. وهكذا لم أكد أبلغ العشرين والحصول على الثانوية حتى كنت أحفظ ما لا يقل عن 12 ألف بيت من الشعر، في حين كان أخي الأكبر- وهو في الوقت ذاته معلمي- يحفظ ربع القرآن الكريم ونحو 20 ألف بيت من الشعر، يطيب له أن يردد قطوفا منها في سهرات الشتاء وصيف البيادر، وحتى في وراء المحراث في الخريف وأيام الحصاد. وحتى اليوم، وأنا أوشك أن أتخطى السادسة والثمانين، أحاول أن أدرك سر شغفه بالشعر وحفظه وترديده، وهل كان شغفه الفني ذاك هو العزاء الجميل عن حرمانه من الأولاد، مع أنه تزوج مرتين.. ولم يرزق إلا طفلة واحدة سرعان ما اختطفها الموت…
تلك الذكريات لم تكن إلا الأساس الشعري في منصة الانطلاق للحديث عن أهم الشعراء الرواد الذين شقوا دروب الحداثة الشعرية من جيل أساتذتنا، وهم: بدر شاكر السياب، وصلاح عبد الصبور، وحليل حاوي؛ ولك واحد من هؤلاء الشعراء الرواد رؤاه وتجربنه وهويته الشعرية المتميزة عن سواها. ويبدو تأثرهم بالحداثة الأوربية واضحا وقويا، بحكم ثقافتهم التي جمعت بين التراث ورياح العصر القادمة من الغرب. السياب الذي اختزن في ذاكرته غابة النخيل الممتدة أمام داره في جيكور حتى انبثقت بعد ثلاثين عاما في (أنشودة المطر)، وراح يتغنى بها: “عيناك غابتا نخيل ساعة السحر…”، كان همه الكبير أن يتحرر العراق من استبداد نوري السعيد وطبقته المهيمنة وهي تلوح بقدوم حلف بغداد بسطوته التركية الأميركية.
ومن القصائد التي ما زلت أتذكر بعض أبياتها (قارئ الدم) ومطلعها: “أنا أيها الطاغوت مقتحم الرتاج على الغيوبِ/ أبصرت نعشك وهو يأزف، هذه سحب الغروب…”. لكن القصيدة التي ما زلت حتى اليوم أنتشي بترديدها هي (مدينة بلا مطر) وهي من أجمل أناشيد الثورة الرمزية التي تمزج الواقع بالأسطورة: “مدينتنا تؤرِّق ليلها نارٌ بلا لهبِ/ تُحَمُّ دروبُها والدورُ.. ثم تزولُ حمّاها/ ويصبغها الغروبُ بكلّ ما حملته من سحبِ/ فتوشك أن تطيرَ شرارةٌ ويهبُّ موتاها/ صحا من نومه الطينيِّ تحت عرائش العنبِ/ صحا تمّوز، عاد لبابل الخضراء يرعاها…”.
ومن شدة تأثري بهذه القصيدة كتبت قصيدة بعنوان (عام بلا مطر) نشرتها لي مجلة (الآداب) اللبنانية، وفيها أقول: موسمنا، ماذا؟ ورانت على عينيك آلاف الرؤى الضارعة/.. وبيتنا فئرانه هاجرت.. لم تبقَ فيه مثلنا قانعة!” ولم أنشرها في الأعمال الشعرية، لأنها لم تكن بالتفعيلة.. وعمود البح الخليلي لا يروقني إلا في الغناء، وكان لا يخلو من شجن عراقي، لكنه اختفى.
صلاح عبد الصبور الذي كرس شاعريته ومسرحه للبسطاء والناس (الغلابة) كان متميزا ببلاغة البساطة، بدءا من ديوانه (الناس في بلادي)، وإن عاب عليه بعضهم النزول إلى مستوى الشارع في قوله: “وشربت شايا في الطريق…” لكن قصيدته (لحن) التي نشرها في (الآداب) كان أصحابي في القرية ممن لم يتجاوزوا الابتدائية يتغنون بها، وفيها يقول: “جارتي مدّت من الشرفة حبلا من نغم/ نغمٌ قاسٍ رتيبُ الضرب منزوف القار/ نغم كالنار/ بيننا يا جارتي بحرٌ عميق/ وأنا لستُ بقرصانٍ ولم أركبْ سفينة/… أنتِ تغفين على الفرش الحرير/ وتذودين عن النفس السآمة/ بالمرايا واللآلي والعطور/ وانتظارِ الفارس الأشقر في الليل الأخير/ … ورفاقي طيبون/ ربَّما لا يملكُ الواحد منهم حشوَ فم/ ويمرّون على الدنيا خفافا كالنّسَم/ وعلى كاهلهم عبءٌ كبيرٌ وفريد/ عبءُ أن يولدَ في الظلمة مصباحٌ جديد…
ويمتاز صلاح بعذوبة طيبته الآسرة وانفتاح فضائه الإبداعي على الكون، سواء في شعره ومسرحه أو في لقاءاته وأحاديثه. وفي آخر لقاء به في مجلة “الكاتب” بالقاهرة، وكان يرأس تحريرها، خضنا في أحاديث شتى وشعرت أنه كان ولا يزال من أصدقاء الزمن الجميل الذين آمل أن يتجدد لقاؤنا في الدار الأخرى، ولو في ظلال كوخ الحطيئة الذي تحدث عنه حكيم المعرة في رسالة الغفران.
خليل حاوي، الطالع من تربة الأرز وعاشق الهلال الخصيب ودارس الفلسفة في كيمبريدج، شغلته الحضارة وأبدع في تحويل صلابتها النظرية بطريقة رمزية مدهشة إلى شعر، فالبحار والدرويش رمزان لحضارة الغرب في المغامرة.. وصوفية الشرق مع دراويش الهند
وفي تلك القصيدة يقول:
بعد أن عانى دوار البحر/ والضوء المداجي عبر عتمات الطريق/ ومدى المجهول ينشقّ عن المجهول عن موت محيق/ ينشر الأكفان زرقا للغريق/… حط في أرض حكى عنها الرواة/ حانة كسلى، أساطير، صلاة/ مطرح رطب يميت الحس في أعصابه الحرى، يميت الذكريات/… آه لو يسعفه زهد الدراويش العراة/ دوختهم حلقات الذكر فاجتازوا الحياة/ حلقات حلقات/ حول درويش عتيق/ شرّشت رجلاه في الوحل وبات/ ساكنا يمتص ما تنضحه الأرض الموات/ في مطاوي جلده ينمو طفيلي النبات/ طحلب شاخ على الدهر ولبلاب صفيق/ غائب عن حسه لن يستفيق//…
وفي قصيدته (السندباد في رحلته الثامنة) يوغل في أغوار النفس في رحلة استكشافية لم يحاولها أي شاعر قبله، قائلا: “داري التي أبحرت، غرّبت معي/ وكنت خير دار/ في دوخة البحار/ وغربة الديار…
ويشكل الزمن وتقلبه بين أحوال الناس والحضارات، على المستوى الفردي والجماعي مشكلة فلسفية ونفسية عجيبة
والشاعر يستلهم من قراءاته ومن تجربته الشخصية أجمل إبداعاته:
“كيف مر العمر من بعدي/ وما مر/ فظلت طفلة الأمس وأصغر/ تغزل الرسم على وجهي/ وتحكي ما حكته لي مرار/ عن صبي غص بالدمعة/ في مقهى المطار…
هؤلاء الشعراء الرواد رحلوا وتركوا آثارهم ناضرة مشرقة للأجيال… لا أدري إلى أي مدى يهتم شباب اليوم بأعمال من سبقهم ليضيفوا إليها تجاربهم، وهي لا بد أن تكون تجارب مفعمة بالجدة والابتكار والجمال. والحياة مسرع مكابداتهم الواقعية وتطلعاتهم المستقبلية وفضاءاتهم الإبداعية ومسؤوليتهم وحدهم… وفي ختام هذه الأطياف، أود أن أتوجه بتحية والمودة والإجلال لروح الدكتور سهيل إدريس (نضّر الله ذكراه العطرة)، صاحب مجلة (الآداب) ورئيس تحريرها، وله الفضل الكبير في رعاية تطلعاتنا واحتضان تجاربننا الشعرية من أيام كنا طلابا في جامعة دمشق.. وجيلنا كان يضم علي الجندي، عبد الباسط الصوفي، خليل الخوري وهم ممن سبقونا قليلا، أما جماعتنا في جامعة دمشق فقد كانت تضم الشعراء (تيسير سبول، كمال أبو ديب، عبد الكريم كاصد، ممدوح عدوان، فواز عيد، فايز خضور، محمد كمال، فؤاد نعيسة.. وآخرين، من خارج الجامعة.. ومنهم: مروان الخاطر، مصطفى خضر، ممدوح السكاف.. وكان هاني الراهب أبرز الروائيين.. وروايته الوباء تشكل جزءا أساسيا مهما من تاريخ سوريا في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي حافلة بالرموز.