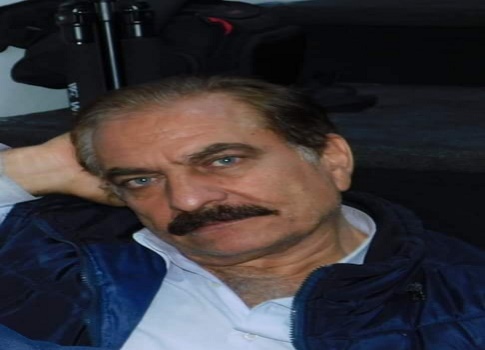الإبداع الأدبي بين المركز والأطراف

الإبداع الأدبي بين المركز والأطراف… يقول الروائي الياباني كِنْزابُرو أووِيه الحائز على جائزة نوبل 1994: “ولدت في قرية محاطة بالغابات الجبلية، تقع على جزيرة صغيرة في طرف اليابان، لا في مركزها؛ وحتى اليابان ذاتها تقع على حافة آسيا، وهذا أمر مهم جدا. لكن زملاءنا المتأنقين يعتقدون أن اليابان مركز آسيا. ولعلهم يتصورون، في سرهم، أن اليابان مركز العالم. لكني أقول دائما إنني كاتب من المحيط الخارجي النائي في الضواحي أو في الأطراف. فالمنطقة التي ولدت فيها ونشأت على أرضها بعيدة عن المركز، واليابان تقع في محيط آسيا، إنها بلاد في المحيط الخارجي من هذا الكوكب. وأنا أقول هذا بكل صدق واعتزاز. إن الأدب ينبغي أن يكتب من المحيط ليتجه نحو المركز، ونحن قادرون على انتقاد المركز. إيماننا وموضوع كتابتنا وخيالنا، هذه كلها خاصة بإنسان الهامش. إن الإنسان في المركز لا يملك أي شيء للكتابة، ونحن نستطيع، من محيطنا الخارجي، أن نكتب قصة الكائن البشري. وهذه القصة يمكن أن تعبر عن إنسان المركز وإنسانيته. لذلك، عندما أركز على “المحيط الخارجي”، فلعل هذا أهم ما أعتقد به”.
انطلاقا من هذه النظرة الفكرية الكاشفة، أرى أن المركز الفكري والأدبي والفني لم يعد محصورا في بيئته التقليدية القديمة بين مصر وبلاد الشام والعراق. لكنه شرع يتحول وينتقل على مهل إلى مناطق عربية أخرى كانت، قبل سنوات، تعد من المحيط أو الأطراف. ويقول أحد النقاد إن مركز الثقافة والإبداع الأدبي انتقل إلى بعض بلدان الخليج والمغرب الكبير، أي البلاد التي كانت تعد من أطراف العالم العربي. وهذه سمة حضارية متميزة، يدركها أعلام الفكر ويعترفون بها، بعيدا عن أي تحزب أو مغالاة، لأن التطور سنة الحياة، والغراس الجديدة لا تنمو إلا في بيئة ترعاها وتوفر لها ظروف العناية وتعزيز الازدهار. وحتى مشاعل الأدب في الغرب بشاطئيه، الأوروبي والأميركي، لم تسلم من رياح التحول، وسرعان ما خطفتها أمريكا اللاتينية ممثلة بروادها الكبار: أستورياس، ماركيز، أمادو، غاليانو، ألليندي، فارغاس، بورخيس.. وغيرهم.
والتاريخ العربي حافل بمراحل التحول في الأدب، سلبا وإيجابا. فالشعر الجاهلي، بدءا من أصحاب المعلقات حتى الصعاليك، كان ذروة إبداعية تمتاز بنكهة خاصة، ولعل أجواء الحرية الطليقة التي كان يتمتع بها أولئك الشعراء هي التي أسهمت في إنجاز تلك الفرادة المتميزة. وفي بداية الدعوة المحمدية، وقف الشعراء ذاهلين أمام البلاغة القرآنية، وظنها بعضهم “من أساطير الأولين”. وفي العصر الأموي، حلت سلطة الدولة المركزية محل التنابذ القبلي وجرى تصعيد الصراع إلى المستوى الفني، بالمعنى الفلسفي- النفسي لمصطلح “التصعيد”، فانتشرت “النقائض” بين جرير والفرزدق والأخطل، حتى غدت متنفس الجميع، وتوهج الحب العذري في نسق جمالي من الوجد عززه الشعراء العشاق بنفحات عاطفية مفعمة بألوان شجية من لواعج الحرمان والأسى والعتاب، وراحت قصائدهم تتردد في المجالس والبوادي والمنتجعات. ومن أطرف المفارقات أن يلجأ شاعر عذري من وزن جميل بثينة إلى صحبة الصعاليك لكي يحظى بنظرة خاطفة من حبيبته، ولو من بعيد، فيقول:
أبيت مع الهُلّاك ضيفاً لأهلها – وأهلي قريبٌ موسعون ذوو فضلِ
وقد ظل التفاوت الاجتماعي في سبل العيش ونزعة الثراء حافزا لاستمرار التمرد الفردي، وبقيت شذرات من شعر الصعاليك تتردد كزخات ضئيلة متناثرة من مطر موسمي عاصف في مستهل الربيع، لكن ذلك الشعر سرعان ما خبا وجرفته الأحداث كالرمال المتحركة. ولعل إشارة مالك ابن الريب كانت آخر ذكرى من آثار تلك الموجة العابرة، إذ يستحضر ذكريات الغضا بلوعة فاجعة، قائلا في مرثيته:
ألم ترني بعتُ الضلالة بالهدى – وأصبحتُ في جيش ابن عفّان غازيا؟
وجاء العصر العباسي بروافد جديدة من الشرق والغرب دليلا على الاستقرار، واستجابة لتأثير الترجمة التي تمثلت ذروتها في تأسيس “بيت الحكمة” برعاية المأمون، وأثمرت روائع شعرية ونثرية جديدة، إلى جانب حكايات طريفة حملتها المقامات، واحتفت بإبداعات أخرى أعمال أدباء كبار كالجاحظ والتوحيدي، كما كان للترف الأندلسي نكهته الشعرية المتميزة بدفئها وعذوبتها ورقتها شعرا وعمرانا وموسيقى.